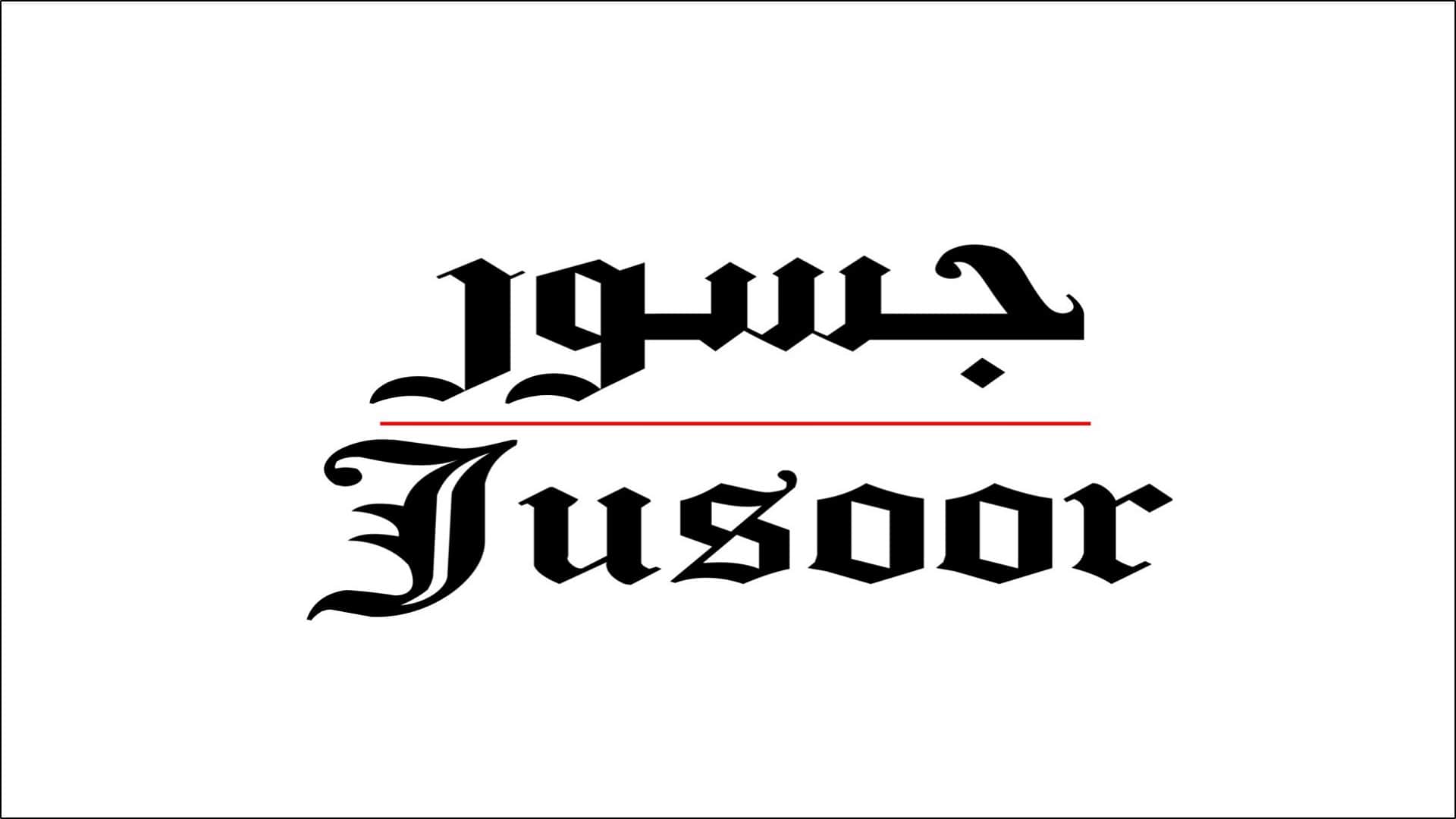"إنهاء احتكار المعلومات".. تعزيز الحقوق الرقمية في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى
"إنهاء احتكار المعلومات".. تعزيز الحقوق الرقمية في مواجهة شركات التكنولوجيا الكبرى
من بين التحولات العديدة التي تجري في الاقتصاد الأمريكي، لا يوجد ما هو أكثر بروزًا من نمو منصات الإنترنت العملاقة (أمازون، وأبل، وفيسبوك، وغوغل، وتويتر)، التي أصبحت أكثر قوة بعد جائحة كوفيد-19، حيث تنتقل الكثير من جوانب الحياة اليومية عبر الإنترنت. وبقدر ما تتمتع به هذه الشركات من سهولة في الاستخدام، فإن ظهور مثل هذه الشركات المهيمنة يجب أن يدق ناقوس الخطر، ليس فقط لأنها تمتلك الكثير من القوة الاقتصادية ولكن أيضًا لأنها تمارس قدرًا كبيرًا من السيطرة على الاتصالات السياسية، وتهيمن على نشر المعلومات، وهذا يفرض تهديدات فريدة للديمقراطية وحرية التعبير.
ووفقا لمجلة "فورين أفيرز"، في الحين الذي سعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى فرض قوانين مكافحة الاحتكار ضد هذه المنصات، كانت الولايات المتحدة أكثر فتورًا في استجابتها، لكن هذا بدأ يتغير، على مدى العامين الماضيين، بدأت لجنة التجارة الفيدرالية وائتلاف من المدعين العامين للولايات تحقيقات في الانتهاكات المحتملة لقوة الاحتكار التي تتمتع بها هذه المنصات، وفي أكتوبر، رفعت وزارة العدل دعوى قضائية ضد "غوغل".
ويشمل منتقدو شركات التكنولوجيا الكبرى الآن الديمقراطيين الذين يخشون التلاعب من قبل المتطرفين المحليين والأجانب والجمهوريين الذين يعتقدون أن المنصات الكبيرة متحيزة ضد المحافظين، وفي الوقت نفسه، تسعى حركة فكرية متنامية، بقيادة مجموعة من العلماء القانونيين المؤثرين، إلى إعادة تفسير قانون مكافحة الاحتكار لمواجهة هيمنة المنصات.
وعلى الرغم من وجود إجماع ناشئ حول التهديد الذي تشكله شركات التكنولوجيا الكبرى على الديمقراطية، فإن هناك القليل من الاتفاق حول كيفية الاستجابة، فقد زعم البعض أن الحكومة بحاجة إلى تفكيك "فيسبوك" و"غوغل"، ودعا آخرون إلى فرض لوائح أكثر صرامة للحد من استغلال هذه الشركات للبيانات.
وفي غياب طريق واضح للمضي قدما، لجأ العديد من المنتقدين إلى الضغط على المنصات لتنظيم نفسها، وتشجيعها على إزالة المحتوى الخطير والقيام بعمل أفضل في تنظيم المواد التي يتم نشرها على مواقعها، ولكن قِلة من الناس يدركون أن الأضرار السياسية التي تفرضها المنصات أكثر خطورة من الأضرار الاقتصادية.
وقليلون هم الذين فكروا في طريقة عملية للمضي قدما؛ إزالة دور المنصات كحراس للمحتوى، ويستلزم هذا النهج دعوة مجموعة جديدة من شركات "البرمجيات الوسيطة" التنافسية لتمكين المستخدمين من اختيار كيفية تقديم المعلومات إليهم، ومن المرجح أن يكون أكثر فاعلية من الجهود الخيالية لتفكيك هذه الشركات.
قوة المنصات
تعود جذور قانون مكافحة الاحتكار المعاصر في الولايات المتحدة إلى سبعينيات القرن العشرين، مع صعود خبراء الاقتصاد والقانون المؤيدين للسوق الحرة، وبرز روبرت بورك، الذي كان المحامي العام وقتها، كباحث بارز زعم أن قانون مكافحة الاحتكار يجب أن يكون له هدف واحد فقط: تعظيم رفاهية المستهلك، وزعم أن السبب وراء نمو بعض الشركات إلى هذا الحد هو أنها أكثر كفاءة من منافسيها، وبالتالي فإن أي محاولات لتفكيك هذه الشركات كانت لمجرد معاقبتها على نجاحها.
لقد استلهم هذا المعسكر من العلماء نهج عدم التدخل الذي تتبناه مدرسة شيكاغو للاقتصاد، والتي قادها الحائزان على جائزة نوبل ميلتون فريدمان وجورج ستيجلر، والتي نظرت إلى التنظيم الاقتصادي بعين الشك.
وزعمت مدرسة شيكاغو أنه إذا كان من الواجب هيكلة قانون مكافحة الاحتكار بحيث يعمل على تعظيم الرفاهية الاقتصادية، فلا بد أن يكون مقيداً إلى حد كبير.
وبأي معيار، كان نجاح هذه المدرسة الفكرية مذهلاً، حيث أثرت على أجيال من القضاة والمحامين، وأصبحت تهيمن على المحكمة العليا، وقد تبنت وزارة العدل في إدارة ريجان العديد من مبادئها، واستقرت سياسة مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة إلى حد كبير على نهج متساهل منذ ذلك الحين.
بعد عقود من هيمنة مدرسة شيكاغو، أتيحت للاقتصاديين الفرصة الكافية لتقييم آثار هذا النهج، وما وجدوه هو أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل مطرد أكثر تركيزاً على جميع المجالات وعانى المستهلكون، ويربط كثيرون، مثل توماس فيليبون، صراحة بين ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، مقارنة بالأسعار في أوروبا، وعدم كفاية إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار.
والآن، تزعم "مدرسة ما بعد شيكاغو" المتنامية أن قانون مكافحة الاحتكار يجب أن يُنفَّذ بقوة أكبر، ويعتقدون أن إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار ضروري، لأن الأسواق غير المنظمة لا يمكنها وقف صعود وترسيخ الاحتكارات المناهضة للمنافسة.
كما أدت أوجه القصور في نهج مدرسة شيكاغو لمكافحة الاحتكار إلى "مدرسة برانديز الجديدة" لمكافحة الاحتكار، وتزعم هذه المجموعة من علماء القانون أن قانون شيرمان، وهو قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي المبكر في البلاد، كان يهدف إلى حماية ليس فقط القيم الاقتصادية ولكن أيضًا القيم السياسية، مثل حرية التعبير والمساواة الاقتصادية، ولأن المنصات الرقمية تمارس القوة الاقتصادية وتتحكم في اختناقات الاتصالات، فقد أصبحت هذه الشركات هدفًا طبيعيًا لهذا المعسكر.
من الصحيح أن الأسواق الرقمية تتميز ببعض السمات التي تميزها عن الأسواق التقليدية، فمن ناحية، فإن عملة هذا المجال هي البيانات، فبمجرد أن تجمع شركة مثل أمازون أو غوغل بيانات عن مئات الملايين من المستخدمين، يمكنها الانتقال إلى أسواق جديدة تماما والتغلب على الشركات الراسخة التي تفتقر إلى المعرفة المماثلة.
ومن ناحية أخرى، تستفيد مثل هذه الشركات بشكل كبير مما يسمى بتأثيرات الشبكة، فكلما كبرت الشبكة أصبحت أكثر فائدة لمستخدميها، وهو ما يخلق حلقة ردود فعل إيجابية تؤدي إلى سيطرة شركة واحدة على السوق.
وعلى النقيض من الشركات التقليدية، لا تتنافس الشركات في الفضاء الرقمي على حصة السوق، بل تتنافس على السوق نفسها، ويمكن للشركات الأولى أن ترسخ أقدامها وتجعل المنافسة الإضافية مستحيلة، ويمكنها ابتلاع المنافسين المحتملين، كما فعلت "فيسبوك" بشراء "إنستغرام" و"واتساب".
ولكن هيئة المحلفين لا تزال في حيرة بشأن ما إذا كانت شركات التكنولوجيا الضخمة تقلل من رفاهية المستهلك، فهي تقدم ثروة من المنتجات الرقمية، مثل عمليات البحث والبريد الإلكتروني وحسابات الشبكات الاجتماعية، ويبدو أن المستهلكين يقدرون هذه المنتجات تقديرا عاليا، حتى مع دفعهم ثمناً بالتخلي عن خصوصيتهم والسماح للمعلنين باستهدافهم.
وعلاوة على ذلك، يمكن الدفاع عن كل إساءة تقريبًا تُتهم بها هذه المنصات باعتبارها فعّالة اقتصاديًا في الوقت نفسه، على سبيل المثال، أغلقت أمازون متاجر التجزئة الصغيرة وأفرغت ليس فقط الشوارع الرئيسية ولكن أيضًا تجار التجزئة الكبار، لكن الشركة تقدم في الوقت نفسه خدمة يجدها العديد من المستهلكين لا تقدر بثمن.
أما بالنسبة للادعاء بأن المنصات تشتري الشركات الناشئة لمنع المنافسة، فمن الصعب معرفة ما إذا كانت الشركة الناشئة ستصبح "أبل" أو "غوغل" التالية لو ظلت مستقلة، أو إذا كانت ستفشل بدون ضخ رأس المال والخبرة الإدارية التي تلقتها من مالكيها الجدد، على الرغم من أن المستهلكين ربما كانوا ليكونوا في وضع أفضل إذا بقيت "إنستغرام" منفصلة وأصبحت بديلاً قابلاً للتطبيق لـ"فيسبوك"، فإنهم كانوا ليكونوا أسوأ حالًا إذا فشلت "إنستغرام" تمامًا.
إن الحجة الاقتصادية لكبح جماح شركات التكنولوجيا الكبرى معقدة، ولكن هناك حجة سياسية أكثر إقناعًا، تتسبب منصات الإنترنت في أضرار سياسية أكثر إثارة للقلق من أي ضرر اقتصادي تخلقها، الواقع أن الخطر الحقيقي الذي تشكله هذه المنصات ليس تشويها الأسواق، بل إنها تهدد الديمقراطية.
احتكارات المعلومات
منذ عام 2016، استيقظ الأمريكيون على قوة شركات التكنولوجيا في تشكيل المعلومات، فقد سمحت هذه المنصات للمخادعين بترويج الأخبار المزيفة وللمتطرفين بدفع نظريات المؤامرة، وهي البيئة التي لا يتعرض فيها المستخدمون إلا للمعلومات التي تؤكد معتقداتهم السابقة، بسبب طريقة عمل خوارزمياتها، ويمكنها تضخيم أو دفن أصوات معينة، وبالتالي التأثير بشكل مقلق على المناقشة السياسية الديمقراطية.. والخوف النهائي هو أن المنصات جمعت قدرا كبيرا من القوة بحيث يمكنها التأثير على الانتخابات، إما عن عمد أو عن غير قصد.
واستجاب المنتقدون لهذه المخاوف بالمطالبة بأن تتحمل المنصات قدرا أعظم من المسؤولية عن المحتوى الذي تبثه، ودعوا تويتر إلى قمع أو التحقق من صحة تغريدات الرئيس دونالد ترامب المضللة، وانتقدوا فيسبوك لتصريحه بأنه لن يشرف على المحتوى السياسي.
الواقع أن كثيرين يرغبون في رؤية منصات الإنترنت تتصرف مثل شركات الإعلام، فتقوم بتنظيم محتواها السياسي ومحاسبة المسؤولين العموميين، ولكن الضغط على المنصات الكبيرة لأداء هذه الوظيفة -على أمل أن تفعل ذلك مع وضع المصلحة العامة في الاعتبار- ليس حلاً طويل الأجل.
واليوم، يشتكي المحافظون إلى حد كبير من التحيز السياسي لمنصات الإنترنت، وهم يفترضون، مع بعض التبرير، أن الأشخاص الذين يديرون منصات اليوم -جيف بيزوس من أمازون، ومارك زوكربيرج من فيسبوك، وسوندار بيتشاي من غوغل، وجاك دورسي من تويتر- يميلون إلى التقدم الاجتماعي، حتى مع كونهم مدفوعين في المقام الأول بالمصلحة الذاتية التجارية.
لكن هذا الافتراض قد لا يصمد في الأمد البعيد، ولنفترض أن أحد هذه الشركات العملاقة استولى عليه ملياردير محافظ، إن سيطرة روبرت مردوخ على فوكس نيوز وصحيفة وول ستريت جورنال تمنحه بالفعل نفوذا سياسيا بعيد المدى، ولكن على الأقل فإن آثار هذه السيطرة واضحة للعيان: فأنت تعرف متى تقرأ افتتاحية في وول ستريت جورنال أو تشاهد فوكس نيوز، ولكن إذا سيطر على فيسبوك أو غوغل، فقد يغير بشكل خفي خوارزميات التصنيف أو البحث لتشكيل ما يراه المستخدمون ويقرؤونه، ما قد يؤثر على آرائهم السياسية دون علمهم أو موافقتهم.
القمع
إن الطريقة الأكثر وضوحاً لضبط هذه السلطة هي التنظيم الحكومي، وهذا هو النهج المتبع في أوروبا، حيث أقرت ألمانيا، على سبيل المثال، قانونا يجرم نشر الأخبار الكاذبة، ورغم أن التنظيم قد لا يزال ممكنا في بعض الديمقراطيات التي تتمتع بدرجة عالية من الإجماع الاجتماعي، فمن غير المرجح أن ينجح في بلد مستقطب مثل الولايات المتحدة.
هاجم الجمهوريون هذه العقيدة بلا هوادة، زاعمين أن الشبكات متحيزة ضد المحافظين، وألغتها لجنة الاتصالات الفيدرالية في عام 1987، لذا تخيلوا هيئة تنظيمية عامة تحاول أن تقرر ما إذا كانت ستمنع تغريدة رئاسية اليوم، أيا كان القرار، فإنه سيكون مثيرا للجدل على نطاق واسع.
وهناك نهج آخر لكبح قوة منصات الإنترنت يتمثل في تعزيز المنافسة، فإذا كان هناك تعدد للمنصات، فلن تتمتع أي منها بالهيمنة التي تتمتع بها فيسبوك وغوغل اليوم، ولكن المشكلة هي أن الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لن يكون بوسعهما على الأرجح تفكيك "فيسبوك" أو "غوغل" بالطريقة التي تم بها تفكيك ستاندرد أويل وأيه تي آند تي.
الواقع أن شركات التكنولوجيا اليوم سوف تقاوم بشدة مثل هذه المحاولة، وحتى لو خسرت في النهاية المطاف، فإن عملية تفكيكها سوف تستغرق سنوات، إن لم يكن عقوداً، ولعل الأمر الأكثر أهمية هو أنه ليس من الواضح ما إذا كان التفكيك من شأنه أن يحل المشكلة الأساسية.
إعادة السيطرة
يجب أن يشعر الجمهور بالفزع إزاء نمو وقوة منصات الإنترنت المهيمنة، وهناك سبب وجيه يجعل صناع السياسات يلجؤون إلى قانون مكافحة الاحتكار كعلاج، لكن هذا ليس سوى واحد من عدة استجابات محتملة لمشكلة القوة الاقتصادية والسياسية الخاصة المركزة.
الآن، تطلق الحكومات إجراءات مكافحة الاحتكار ضد منصات التكنولوجيا الكبرى في كل من الولايات المتحدة وأوروبا، ومن المرجح أن يتم التقاضي في القضايا الناتجة لسنوات قادمة، لكن هذا النهج ليس بالضرورة أفضل طريقة للتعامل مع التهديد السياسي الخطير الذي تشكله قوة المنصات للديمقراطية.