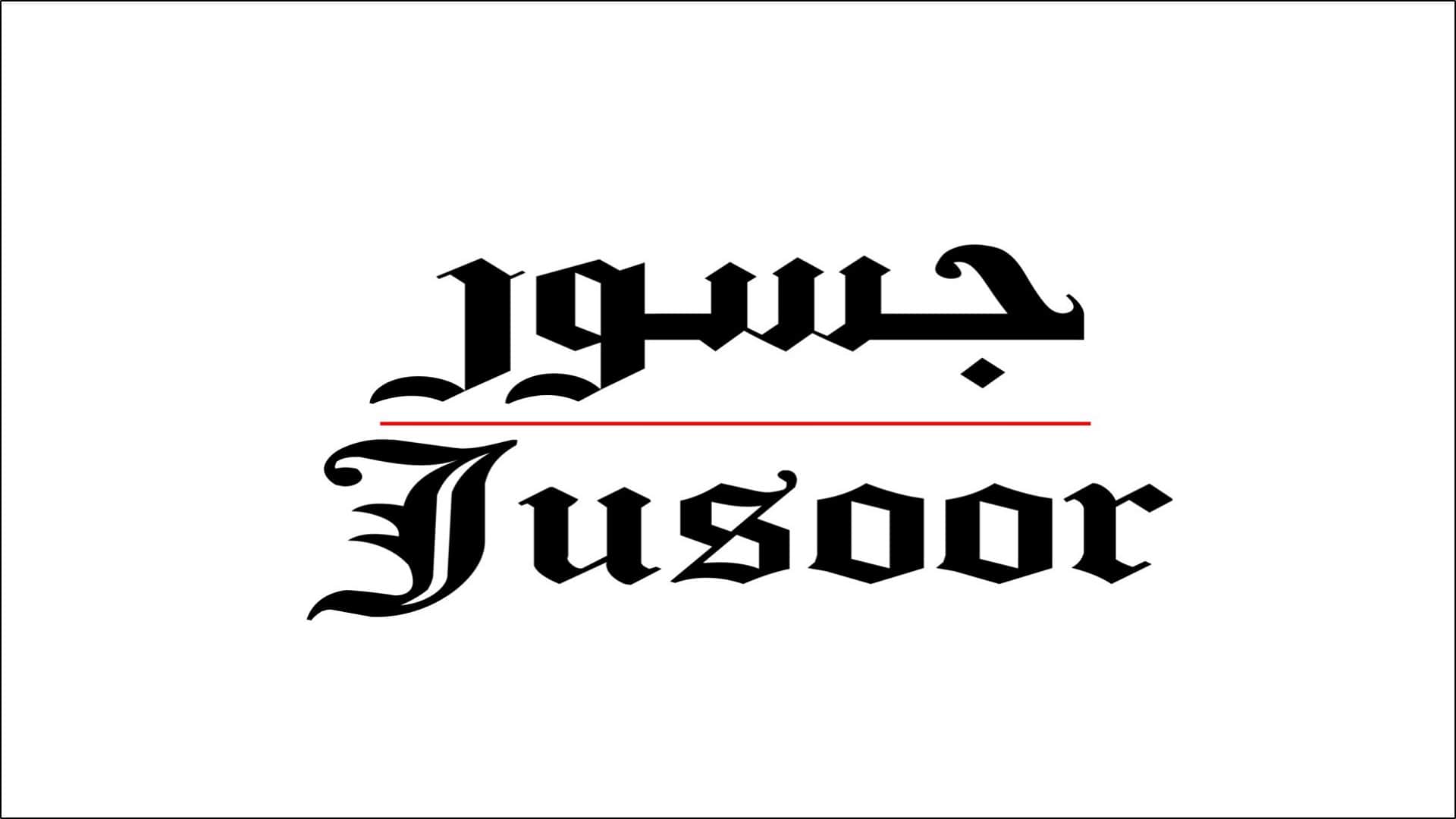الهجرة الإفريقية... ملف منسي يفتح من جديد
الهجرة الإفريقية... ملف منسي يفتح من جديد
تواترت واقعتان في الأسبوع الماضي شديدتا الصلة بسياسات الأرض ونزاعاتها في منطقة الساحل الإفريقي، والتي هي أصل الحرب القائمة في السودان حالياً. فقد كتبت الـ"فورين بوليسي" تتساءل في عنوانها إن كانت غانا هي الهدف التالي لحركة الجهاديين.
كما تخطفت الصحافة تقرير الـ"واشنطن بوست" في 20 مايو (أيار) "دول شمال إفريقيا ترمي بالمهاجرين في الصحراء بدعم من الاتحاد الأوربي".
أثارت المقالتان قضايا لا غنى عنها متى أردنا تحسين معرفتنا بالهجرة الإفريقية من ساحل القارة بخاصة، إذ رفعتا عن هذه الهجرة الحجاب الذي أسدله عليها التركيز المبالغ فيه على دراسة وجهتها الأوروبية وعواقبها، كأنه لا مسارات لها داخل القارة.
وأثارتا كذلك عامل الهوية في دراسة هذه الهجرة، ونعني بذلك النزاع على الأرض بين المزارعين والرعاة، والذي تزيد سياسات الدولة حياله من ضراوته.
جاء في الـ"فورين بوليسي" أن جماعة "النصرة" (وهي وثيقة الصلة بتنظيم "القاعدة") مددت نشاطها أخيراً إلى الأجزاء الشمالية من بلدان إفريقية مشاطئة للمحيط الأطلنطي مثل غانا، بعد احتلالها نصف بوركينا فاسو وأجزاء من مالي والأرض على طول نهر النيجر بينهما.
ومع قناعة غانا بأنها بمنأى عن نشاط "النصرة" فإن الدلائل تشير إلى أن الجهاديين استخدموا شمالها لتسوقهم وكملاذ يؤمنون به ظهرهم. وكانت غانا مع دول على ساحل الأطلنطي قد تعاقدت بـ"مبادرة غانا" (2017) كهيئة إقليمية لمنع اندلاق الإرهاب من دول الساحل إلى الدول المشاطئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وكثفت غانا من وجودها العسكري على حدودها الشمالية وعززته، وتكفّل الاتحاد الأوروبي بالإسناد بالاستخبارات من الجو والحرب الإلكترونية من خلال الـ21 مليون دولار التي خصصها لدعم القوات المسلحة.
تطعن واقعة غانا في المفهوم الغالب الذي يقول بأن الأيديولوجيا (الإسلام) هي الدافع من وراء التحاق شباب المسلمين بالحركات الجهادية، فمن رأي البحث المستجد في المسألة أن هوية هؤلاء الشباب، لا الأيديولوجية، هي الحكم في اختيارهم سبيل الجهاد.
فيقبل على الحركة الجهادية شباب من شعب الفلاني الذين لا تعترف غانا بمواطنتهم مع أنهم يشكلون واحداً في المئة من سكانها. ومعلوم أن أصل الفلاني هو غينيا، وبدأوا هجراتهم كبادية إلى غرب إفريقيا منذ القرن الـ11 حتى بلغوا إثيوبيا.
وانتهت منهم جماعة قليلة نسبياً إلى غانا لم تطل إقامتهم بها سوى لجيلين. وهم يلقون التحقير في غانا كجماعة مجبولة على الجريمة. وهو استحقار يغذي دعوة الجهاديين لهم بالانضمام إلى ركابهم.
ورأت الأكاديمية ميري إسترادا أن دراسات الهجرة الإفريقية أغفلت اعتبار الهوية في تشخيص ديناميكيتها وعواقبها. فنشأت بهذه الهجرة نقيضة ديمغرافية بين الساكن الأصيل والوافد من حيث الحقوق.
وجرى التهوين من الأجنبي حتى تواثقت الحكومات على أن طرده أولى. فدخل الفلاني فاقد الحقوق لأجنبيته في صراع خاسر حول الأرض مع المزارعين الغانيين "الأصلاء"، يفاقم منه ازدياد نفرهم، علاوة على الآثار الوخيمة على البيئة بسبب تغير المناخ، ولم تنجح قوانين الجنسية الغانية في تكييف وضعية الأجنبي حيال الأصلي من السكان.
ومن ذلك قانون 2012 الذي شرع طرد هؤلاء الغرباء من غانا.
ولم يكتف القانون بالطرد فحسب، بل خول للدولة الاستيلاء على ماشيتهم. وهذا ما ساق الفلاني إلى مقاومة هذه الإجراءات بحقهم فقتلوا بقر المزارعين وحرقوا بيوتهم.
ثم جاءتهم الحركة الجهادية من باب تمردهم على جور فقدان الهوية، لا من باب الأيديولوجيا. وكانت غانا مثلاً أبعدت 250 طالب لجوء فلاني إلى بلدهم (بوركينا فاسو) في يوليو (تموز) الماضي بتهمة تهديد أمن البلاد.
فنشرت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" بياناً دعت فيه للاحتجاج على الإرجاع القسري لأولئك اللاجئين، ودعت لتضريج غانا بالدم كما ضرجت الفلاني.
وطالما كانت الهوية هي سبب التحاق شباب الفلاني بالحركات الجهادية، صح لغانا، في قول الخبراء، أن تتوقف عن اضطهاد الفلاني ضمن إجراءات كثيرة عليها اتباعها لتعزيز موقفها من دون أن تصبح ساحة للجهاديين.
فبوسع غانا، في قول الباحث النرويجي تور بنجامنسن، أن تتعلم من خيبة جاراتها في وجه الجهاديين بألا تجعل المواجهة نوعاً من مكافحة الإرهاب الذي تغلب عليه العسكرة بقيادة الغرب كما كانت عليه الحال في الساحل.
أثار تقرير الـ"واشنطن بوست" مسألة بؤس دراسات الهجرة الإفريقية من زاوية تركيزها على وجهتها الأوربية وذيولها من دون وجهاتها الإفريقية. فعرض لدافع الاتحاد الأوروبي لتمويل دول شمال إفريقيا لإلقاء المهاجرين الأفارقة في الصحراء، وهو الأمر المنافي لحقوق الإنسان. لكنها خطة، في قوله، أملتها سياسات أوروبية داخلية أرادت بها قوى الوسط ويمين الوسط الأوروبي وقف زحف الدوائر اليمينية إلى سدة الحكم في دول الاتحاد، من فوق موجة العداء العام للهجرة الإفريقية إلى أوروبا، والتي تعالت في العقد الأخير وصخبت.
وهذا الإجحاف الأوروبي بطالبي الهجرة الإفريقيين هو ما أراد به الوسط ويمين الوسط ألا يبدو أقل صرامة بوجه هذه الهجرة من دون اليمينيين.
وعلق أحدهم على أن الاتحاد الأوروبي بذاك اقترب قليلاً قليلاً من فنتازيا اليمين المتطرف، الذي يريد أوروبا قلعة لا تخترق أسوارها.
ولم يعد الاتحاد الأوروبي، وهو يقف وراء هذه الانتهاكات بحق طالبي اللجوء، يتذكر مذهبه في الحوكمة الرشيدة وحقوق الإنسان، بعد أن أوكل لحكومات غيره أن تكون ديدباناً شديد النكال بالمهاجرين عند بوابته.
وخبر الـ"واشنطن بوست" مع ذلك لا يخرج عن النظرة التقليدية للهجرة الإفريقية وكأنها لوجهة واحدة هي أوروبا. وهي النظرة التي خرج بنجامنسن لنقضها.
فالهجرة الإفريقية داخل إفريقيا، التي كان السودان ميداناً لها عبر بوابة دارفور، أغزر بكثير من تلك التي مقصدها أوروبا، فلا تزال هجرة 80 في المئة من الأفارقة إلى أكناف إفريقيا، حتى مع ازدياد وتائر الهجرة من إفريقيا إلى أوروبا منذ 2015.
ولهذا التحيز بقيت دراسة الهجرات الداخلية في القارة بلا أسبقية لها في البحث. ولا يزال الفهم يقضي بأن الهجرة الإفريقية استثنائية وغير تاريخية.
وجد بنجامنسن في تبرم أوروبا من الهجرة الإفريقية لؤماً منها. واتجه لوضع الهجرة الإفريقية في سياق تاريخي عريض. فقارة مثل أوروبا كانت الهجرة منها وفي أنحائها هي التي أسعفتها على تجاوز أزماتها الاقتصادية.
إذ هاجر بين 1850 و1914 أكثر من مليون أوروبي إلى أميركا الشمالية وأستراليا هرباً من الفقر والمجاعة. وهاجر في الوقت نفسه أوروبيون كثيرون في داخل أوروبا طلباً للفرج الاقتصادي. مثلاً هاجر الإيطاليون إلى فرنسا وسويسرا وألمانيا.
وهاجر الأيرلنديون إلى إنجلترا واسكتلندا، والبولنديون إلى ألمانيا. وأسعفت تلك الهجرات كل من إيطاليا وأيرلندا اللتين كانتا في حال عسر هضم ديموغرافي. ولم تصبح أوروبا دولة المهاجرين منها إلى الخارج أكثر من المهاجرين في داخلها إلا في السبعينيات. وهذا تاريخ في الهجرات وأشراطها الاقتصادية والديمغرافية لا يطرأ في دراسة الهجرة الإفريقية.
فالتركيز على هجرة الإفريقيين إلى أوروبا لا يصيبنا بعلم عنها لا ينفع فحسب، بل نرتكب به سياسيات غير مجدية حيالها. فإفريقيا، المدمجة في الاقتصاد العالمي، بحاجة إلى متنفس كالذي تمتعت به أوروبا خلال أزماتها الاقتصادية يلطف من الآثار السالبة لزيادة سكانها وتردي مواردها. وبغير تأمين هذا المتنفس لزيادة السكان في إفريقيا نعرض أمنها للأخطار.
وهكذا فسياسة الاتحاد الأوروبي لاحتواء الهجرة قد تقود إلى عدم الاستقرار في إفريقيا. قد تنجح سياسة الاحتواء في خفض عدد الأفارقة المهاجرين إلى أوروبا، لكن الضغوط على الإفريقيين للهجرة إلى بلدان أوروبا ستبقى طالما ظلت حال إفريقيا على سوئها.
وستكون عواقب هذا الفيض من المهاجرين وخيمة على القارة. فمهما نمت دولها فإنه ليس بوسع سوق عملها استيعاب من أرادوا دخوله. ومن لم يهاجر بقي في بلده فقيراً ضجراً ومصدراً محتملاً للاضطرابات وانفراط الأمن. وعليه ففرص إفريقيا للنمو تتناقص إذا لم يتوافر لها متنفس الهجرة منها إلى غيرها. وهو ما أنقذ أوروبا ذات يوم.
لا أعرف إن كان لا بد لنا في السودان من خوض حرب لنعرف أننا لم نكن بحاجة لنكون ضحايا ظاهرة هجرة الساحل والصحراء لو أمسكنا بأزمتها بدلاً من الاستثمار فيها أو الاحتجاج عليها.
لكنني أعرف مثلاً يسخر ممن يحمل مسألة بلا علم بها، وهو مثل ذائع من دارفور، مسرح حربنا الأول، يقول "شايل جبل مرة بلا وقاية"، أي يحمل ثقلاً في حجم جبل مرة (الجبل المهيب الذي يتوسط الإقليم) بغير وقاية (وهي لفافة القماش التي يضعها المرء على رأسه لتكون وقاية له من الملامسة المباشرة لجرة ماء أو حزمة الحطب التي عليه).
نقلا عن: إندبندنت عربية