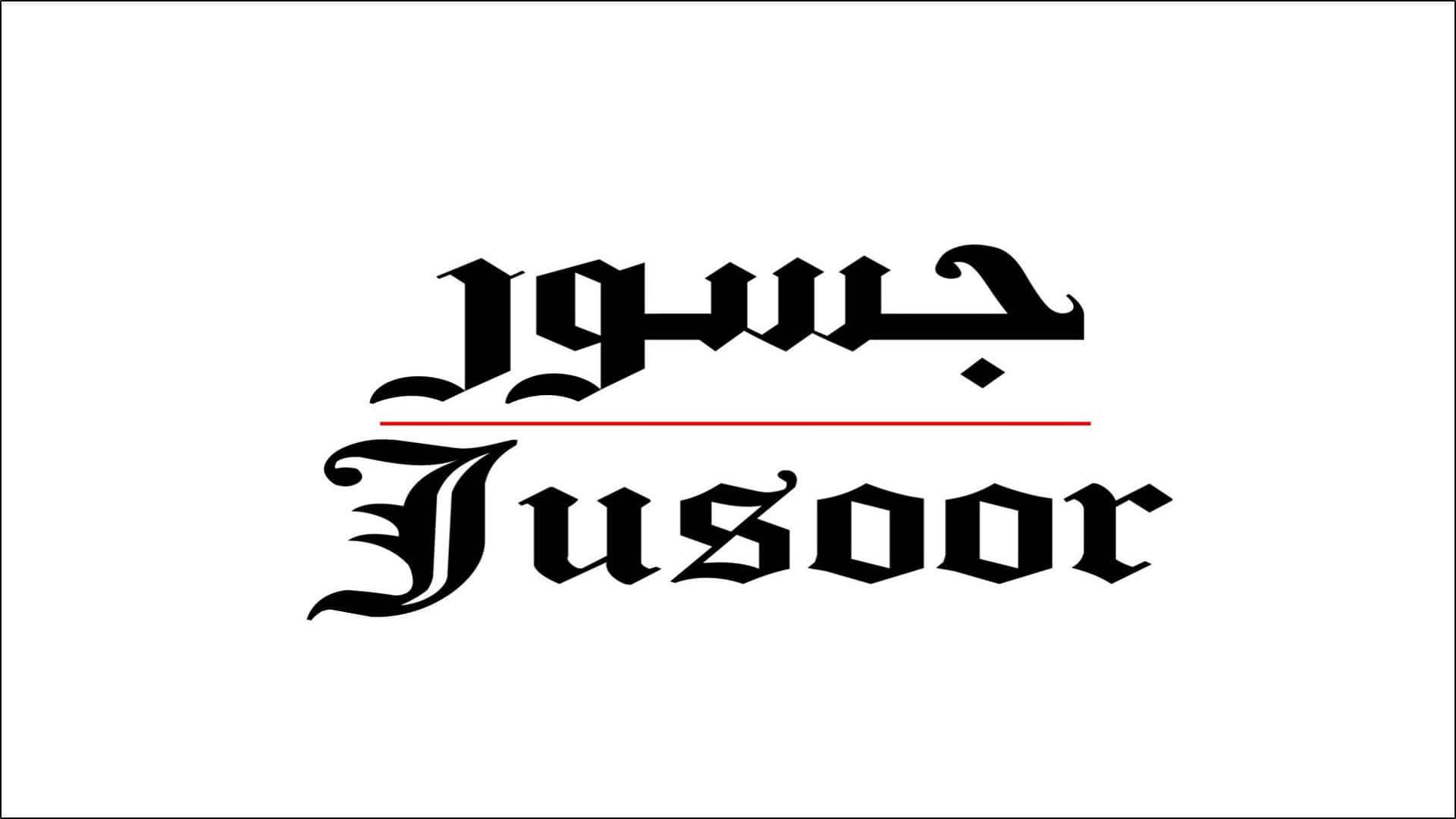جدل الـ«سيلفي» لا ينقطع
جدل الـ«سيلفي» لا ينقطع
في الأسبوع الماضي، تلقى عشاق الصورة الشخصية المُلتقطة للذات (سيلفي) دعماً واضحاً، حين نُشرت نتائج دراسة أُجريت على عينة من 2113 مشاركاً، بجامعة توبينغن في ألمانيا، ليخلص المشرف على الدراسة، زاكاري نيس، إلى أن تلك الصورة «لديها القدرة على مساعدة الناس على إعادة الاتصال بتجاربهم السابقة، وبناء قصصهم الذاتية».
لا يتوقف الجدل بشأن الصورة «السيلفي»، وتتناقض التقييمات ومستخلصات البحوث إزاءها، بين ما إذا كانت تلك الصورة عملاً إيجابياً يوثق المعنى الأكبر للحظة يعيشها مُلتقطها، أم تصرفاً مغروراً يكرّس النرجسية، ويكشف اضطراباً في الشخصية.
بدأ الاهتمام بالصورة «السيلفي» في مطلع العقد الماضي، وعندما حل عام 2013، كان هناك حديث عن «جنون السيلفي»، حينما غرقت مواقع «التواصل الاجتماعي» بـ«إبداعات» المستخدمين في هذا المجال.
لكن الحديث عن «السيلفي» بدأ يأخذ منحى آخر في ربيع عام 2014، وكان حادث المواطنة الأمريكية كورتني سانفورد، التي انقلبت سيارتها وماتت، أثناء التقاطها صورة لنفسها، سبباً في الانتباه إلى ما تطرحه تلك الممارسة المرتبطة بعالم «التواصل الاجتماعي» من مخاطر وتحديات.
لذلك، وكما أفادت صحيفة «ذي غارديان» آنذاك، فإن 2014 كان العام الذي تم فيه اكتشاف مدى خطورة تلك الصور، قبل أن تكشف صحيفة «ذي تلغراف» لاحقاً أن أكثر من 50 شخصاً ماتوا، خلال عام 2015، حين حاولوا التقاط صورة «سيلفي» لأنفسهم، وأن عدد «ضحايا السيلفي» في هذا العام فاق عدد قتلى أسماك القرش!
لقد طرأ تطور فارق على علاقتنا بالصورة المُلتقطة للذات، في فورة تجليات العصر الرقمي الذي نعيشه راهناً، ويبدو أن هذا التطور أخذ تلك الصورة من وظيفتها الموضوعية والمقبولة والإيجابية إلى حالة سلبية غارقة في الاضطراب، حتى إن دراسة أجرتها «الرابطة الأميركية للطب النفسي» عن «هوس السيلفي»، قبل تسع سنوات، توصلت إلى أن هذا التركيز الشديد على التقاط الصور الذاتية إنما يعد نوعاً من «الاضطراب العقلي» و«الخلل النفسي».
والصورة المُلتقطة للذات هي تلك الصورة التي نلتقطها لأنفسنا باستخدام تقنية «السيلفي»، وقد تكون تلك الصورة مطلوبة لإنجاز معاملة إجرائية، وقد تكون تعبيراً عن رغبتنا في تسجيل لحظة ما نعيشها، أو إثبات وجودنا في حالة أو مكان، أو تسجيلاً لتطور ما طرأ على حياتنا، عبر توثيق ما تركه على ملامحنا، وحالتنا الجسدية.
ومنذ أول مشهد فوتوغرافي تم التقاطه في عام 1827، لم تتوقف الصورة الذاتية عن إدهاشنا؛ فنحن ننظر إلى صورنا الشخصية كتأريخ لحياتنا، أو محاولة لتأبيد لحظات نحسب أنها مهمة ومختلفة وقادرة على الإيحاء.
هي لحظة تأبيد اللحظة، التي نجتهد عبرها لكي نعيد تذكير أنفسنا بما نود أن نذكره دوماً، أو نعود إليه تأريخاً أو تذكيراً أو حنيناً.
والصورة الملتقطة للذات تبرز كـ«أنا رقمية» عند التقاطها، لكن حين نبثها على الوسائط الرائجة، تتحول «متعة رقمية»، أو ذروة من ذرى أدائنا النرجسي، ورغم أننا نقايض بها جزءاً من خصوصيتنا، وبعضاً من حميميتنا، فإنها تعوضنا بلحظات، نبدو خلالها كالنجوم، الذين يحصدون الاهتمام، بأقل مجهود يذكر.
في صورتنا الذاتية الكثير من الاحتفاء بالذات، وإظهار الاهتمام بما تتركه التغيرات والمآلات على ملامحنا، وإعلاء الرغبة في تكريس البروز والأهمية، حتى لهؤلاء الذين يعيشون ضمن مقتضيات العادية، وسواء كنت مفردة أو نكرة أو عامياً، فالصورة ستمنحك الشعور اللحظي بالأهمية، وستجعلك قادراً لوهلة على اجتراح النجومية، وتذوق عسلها الآسر.
لكن ما فعلته «السوشيال ميديا» بالصورة كان أكبر من إحاطة أي عقل وتصور أي خيال؛ فقد حولت تلك الوسائط بعضنا إلى مجانين بالصورة، يجتهدون لكي تكون صورتهم الذاتية عنواناً لما أرادوا دائماً أن يكونوا عليه، ولذلك فهم حريصون على التقاطها عبر زوايا معينة، ومن خلال حسابات دقيقة، حيث سيتمكنون من إخفاء تلك الهالات السوداء تحت العيون، أو تفادي تلك التجاعيد التي بدأت تغطي على نضارة بشرتهم، أو إظهار الشعر في الوضع الأمثل، الذي يتقي العوار أو النقص أو تهافت اللون.
هي محاولة لخلق هوية مبتغاة، وترويجها، وغرسها في الفضاء الاتصالي الذي ننشط فيه على أنها حقيقتنا وهويتنا. ومطالبة متابعينا بالتعليق والاستحسان، والإلحاح على ذلك، ليست سوى تأكيد قاطع على الاصطناع.
ستتضارب نتائج البحوث بخصوص «السيلفي» تبعاً لمنهجية البحث، وعينته، ومنظور القائمين عليه، ومع ذلك، فإن المسار العام لتلك البحوث يكشف بوضوح عن جوانب سلبية في الإفراط في تلك الممارسة، وعن مخاطر كبيرة على الذات التي تعشقها وتُمعن في التقاطها.
نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط