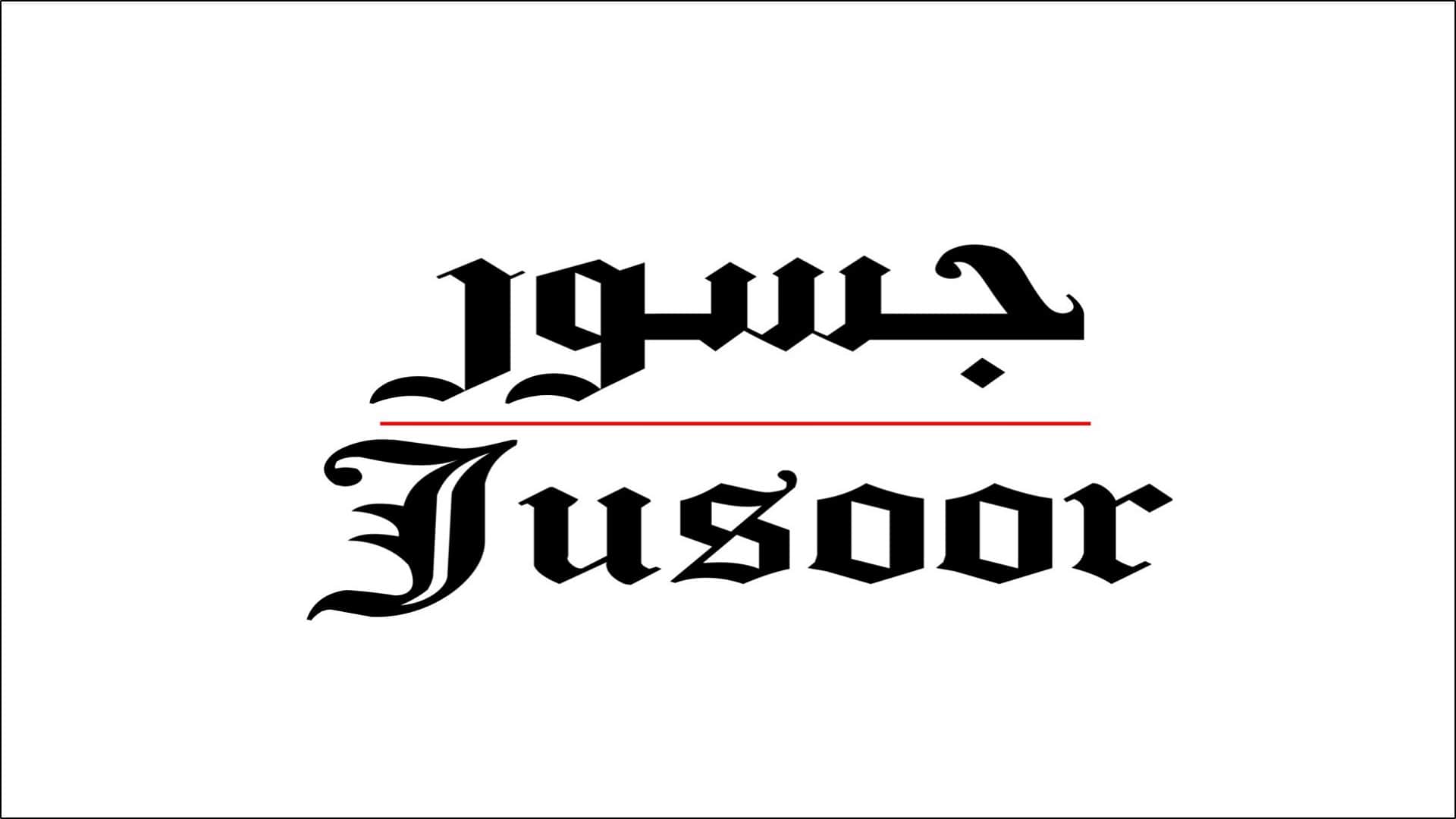«السوشيال ميديا» و«صناعة الثقافة» العالمية
«السوشيال ميديا» و«صناعة الثقافة» العالمية
كان مفكرو «مدرسة فرانكفورت» من أبرز المُنظِّرين الذين اهتموا بمصطلح «صناعة الثقافة»، فهماً، وشرحاً، وتأصيلاً، ورغم أن معظم النتاج الفكري لأهم أعضائها ازدهر في منتصف القرن الفائت؛ فإن انتباههم لمدى تأثير وسائل الإعلام الجماهيرية في صناعة الثقافة كان لافتاً في هذا الوقت المبكر.
ومن بين أبرز الأفكار التي طرحها رواد تلك المدرسة -وعلى رأسهم كل من ماكس هوركهايمر، وتيودور أدورنو- فكرة هيمنة المصالح التجارية والسياسية على آليات «صناعة الثقافة»، بكل ما ينجم عن تلك الهيمنة من تأثيرات ضارة على المجتمعات والإنسان الفرد.
لكن التغيرات الحادة والمتسارعة في الفضاء الاتصالي العالمي -وما صاحبها من اختراقات تكنولوجية مُذهلة- أدت إلى دور قوي ومتصاعد -وربما حاسم- لوسائل «التواصل الاجتماعي» في صناعة الثقافة الجماهيرية، بعدما أضحت تلك الوسائل أكثر نطاقات التعرض نفاذاً وفاعلية.
ولأن معظم الدراسات الموثوقة على الصعيد العالمي باتت تتفق على أن تلك الوسائل أضحت أكبر معرض للأفكار والمعلومات، ولأن الوصول إليها أصبح ميسوراً لأكثر من ثلثي سكان العالم، فإن قدرتها على تشكيل الواقع الثقافي العالمي صارت يقيناً يصعب دحضه.
ومن بين أكثر الإشارات دلالة في هذا الصدد، ما لاحظه قطاع كبير من الناشرين، من هيمنة تتصاعد لطبقة «المؤثرين الجدد» الذين لا يمتلكون مؤهلات ثقافية مُعتبرة، ولا تاريخاً معروفاً في مجالات الإنتاج المعرفي والنشر، على قوائم الكتب الأكثر مبيعاً.
ولا تظهر تلك الهيمنة في المجتمعات الأقل نمواً فقط، ولكنها تزدهر باطراد أيضاً في الدول المتقدمة التي عُرفت تاريخياً بجودة الإنتاج المعرفي، وغزارته، وتعدد مراكز صناعته؛ مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وغيرها.
فقد باتت دور النشر العالمية المُعتبرة تهتم بهؤلاء «المؤثرين الجدد»، وتذهب إليهم للتوقيع على نشر أعمالهم التي ستجني أفضل الأرباح، ولن تحتاج تسويقاً أو دعاية؛ لأنهم يأتون إلى الناشر وجمهورهم معهم، وهو جمهور بالملايين، جاهز لشراء الكتب، والاحتفاء بها، بصرف النظر عن قيمة ما تنطوي عليه من معرفة أو حس إنساني.
لا يتوقف النُّقاد في مجالات الإعلام وعلم الاجتماع عن توجيه سهام النقد الحادة لوسائل «التواصل الاجتماعي»، ثم إن كثيراً من السياسيين، وكبار القادة، والمسؤولين الأمميين، وقطاعات واسعة من الجمهور، لم يتوقفوا قط عن تعيين مناطق القصور والخلل في أنموذج الأعمال الذي تتبعه هذه الوسائل النافذة، ولا عن التحذير من عواقب الاستسلام لديناميات عملها المثيرة للجدل.
ورغم أن طيف الانتقادات المطروحة في هذا الصدد يظل واسعاً وممتداً، فإن القليل جداً منها انتبه إلى خطورة منح مهمة «صناعة الثقافة» لوسائل «التواصل الاجتماعي»، والاستسلام لسلبها هذا الدور من المجتمع والدولة والمؤسسات المعنية، والاستئثار بمعظم مقدراته.
واليوم، تنشط على هذه الوسائط طبقة واسعة تُسمي نفسها «صُناع المحتوى»، وهؤلاء ينتجون مواد، ويبثونها عبر شبكة «الإنترنت»، من خلال تطبيقات كثيرة، من دون التزام بأي قدر من مُحددات الجودة أو الدقة، ومن دون آليات فعالة للمساءلة، أو اعتبار لمعايير، سوى ما يرتضونه لأنفسهم بإرادتهم الحرة؛ بل ومن دون أي قدرة على إلزامهم بتعريف أنفسهم على نحو صحيح.
ولذلك، فإن المحتوى الثقافي والمعرفي والمعلوماتي الرائج عبر الوسائط في هذه الأثناء أضحى مُجرداً من ثلاثة مُحددات جوهرية: أولها التعريف الواضح بالمُرسِل/ المُنتِج، وثانيها التزام القدر المناسب من الدقة أو الصحة، وثالثها ضمان احترام حق الملكية الفكرية.
ولهذا، فإن تلك الوسائط أضحت حافلة بقصص تاريخية مُلفقة أو منزوعة من السياق، ومواعظ دينية دون سند مُعتبر، ودعاوى عنصرية وشوفينية ترتكز على التضليل والتزوير والتحريف، وحكايات مُختلقة عن المجتمع وقضاياه.
ولأن تلك الأنماط من المحتوى تستهدف في المقام الأول الرواج، أو التصيد الاحتيالي، أو تحقيق المصالح التجارية والسياسية المشبوهة، فإنها تحول المشهد الثقافي السائد إلى حالة مكتملة من الضحالة والاختلاق والتضليل، فضلاً عن أن نزعتها التجارية العارمة تستلزم قدراً أكبر من اللعب على العواطف الحادة؛ مثل الغضب والخوف والحزن، بدلاً من المقاربات العقلانية.
سيُبادر أنصار الانفتاح المعلوماتي الراهن بالدفاع عن أدوار تلك الوسائط، وسيتوسلون بمبادئ حرية الرأي والتعبير، وسيُلقون باللوم على الدولة الوطنية ومؤسساتها؛ لأنها لا تؤدي دورها في تأطير المشهد الثقافي، وضمان حق الجمهور في الحصول على معلومات تتحلى بالجودة والصحة. ولكن هذه الدفوع تتجاهل أن «عصمة» هذه الوسائط ليست في أيدي الدولة والمجتمع فقط؛ لأن جزءاً كبيراً منها يتركز في أيدي ثُلة محدودة العدد من أصحاب شركات التكنولوجيا الكبرى، ولأن هؤلاء لا يبحثون سوى عن الرواج والربح، من دون اعتبار لخطورة المآلات الثقافية لترك صناعة الثقافة العالمية دون ضابط أو رابط.
نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط