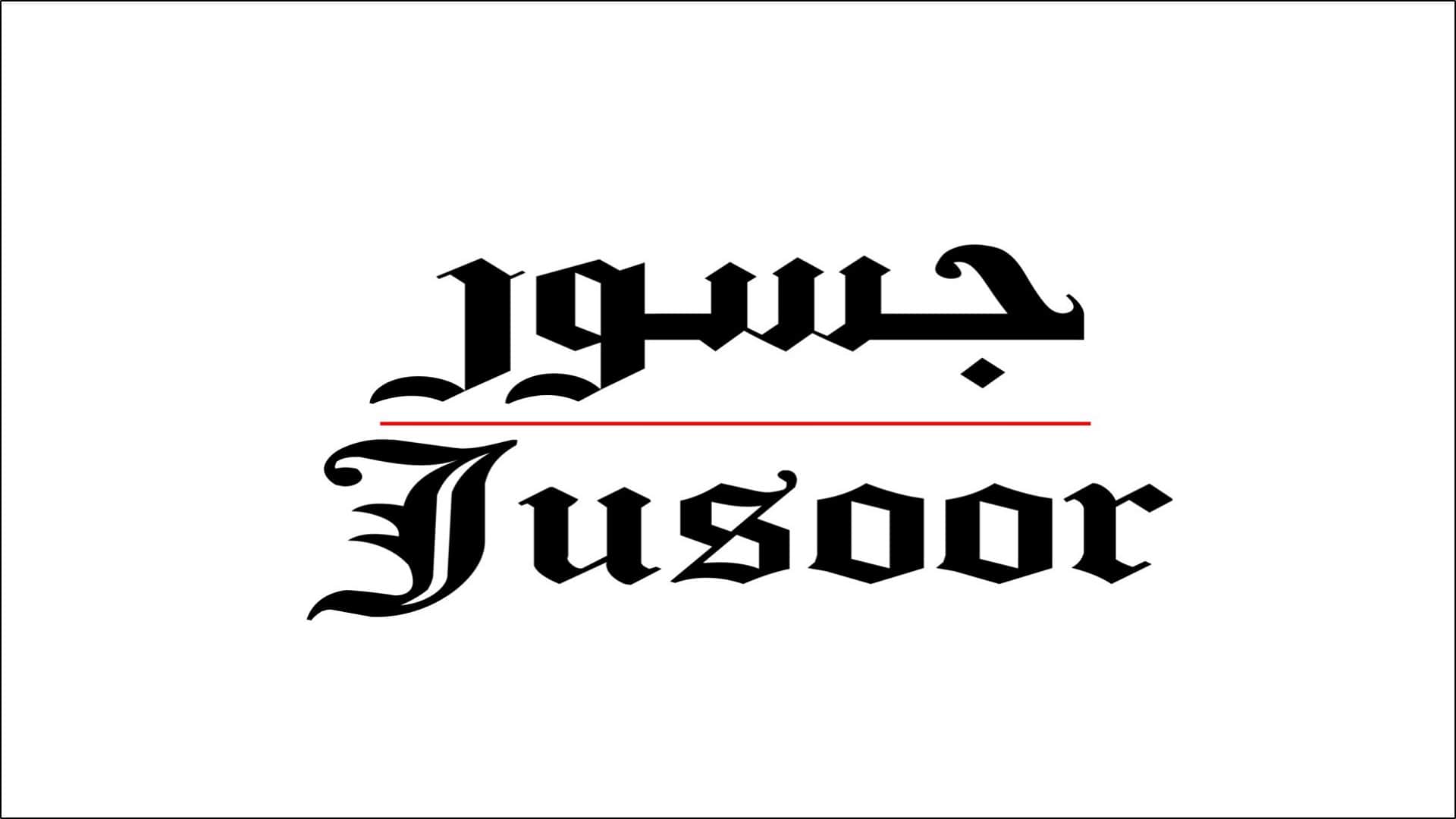أدوية مفقودة وموت بطيء.. كيف فشل النظام الصحي اللبناني في حماية مرضى السرطان؟
أدوية مفقودة وموت بطيء.. كيف فشل النظام الصحي اللبناني في حماية مرضى السرطان؟
كان جسدها مكسوراً، لكن روحها تتدلّى من السماء مثل حبل نجاة.. بربارة، التي قيل لنا إن أقصى ما يمكن أن تهبه الحياة لها هو سنة واحدة، كانت تمشي على عظامها المتكسّرة كما لو أنها دَرجٌ إلى معنى أعمق، سرطان ثدي في مراحله الأخيرة، انتشار في العظم، ثم ميتاستاز في الرأس، وكل تقرير طبي كان أشبه بنعيٍ مؤجل.
قال هاني نصار، زوج بربارا، من بيروت، بعد اكتشاف مرضها، حين قالوا لنا: "جمعتين وبنخلص"، كانت تجمع أنفاسها لا لتودّع، بل لتصعد بعد عام، كانت على القرنة السوداء، أعلى قمة في لبنان، ترفع هاتفها وتقول لطبيبها ضاحكة بعدني طيبة شوف أنا وين تلك اللحظة لم تكن تحدياً للمرض فقط، بل كانت صفعة لكل نظام صحي قرر أن المريض رقم، وأن الفقير أقل أهلية للحياة.
يسرد هاني تفاصيل قصته لـ"جسور بوست"، قائلاً: سألت بربارة يومها سؤالاً بسيطاً ومخيفاً، أين الجمعيات؟ لماذا كل الاهتمام بالأطفال فقط وكأن الألم حين يكبر يفقد حقه في الرعاية؟ أين من يرافق البالغين، من يناصرهم، من يطالب بحقهم في العلاج، من يمسك بيدهم حين يغادرون المستشفى ليواجهوا ليلهم وحدهم؟ لم تجد جواباً، فقررت أن تكون الجواب قبل أيام قليلة من رحيلها.
في الرابع من فبراير 2014، اليوم العالمي لمرضى السرطان، أخذت العلم والخبر لتأسيس جمعية تحمل اسمها، كانت تعرف أنها راحلة، لكنها أرادت أن تترك باباً مفتوحاً، سجلت فيديو، عُرض يوم دفنها، قالت فيه: "ما تخافوا من يلي بيقتل الجسد، خافوا من يلي بيقتل الروح".. ثم غادرت في 27 فبراير، وتركت لنا الوصية الثقيلة.. كملوا.
انهيار النظام الصحي
من بربارا إلى إنشاء مؤسسة باربارا الطبية، يتذكر هاني ما حدث، قائلاً: "بلا ميزانيات، ولا رعاة، ولا مكاتب فخمة، بدأنا بما هو متاح، أدوية باهظة الثمن تُترك في بيوت المرضى بعد تغيير العلاج أو الشفاء أو الوفاة جمعناها، دققنا فيها، ومررناها من مريض لم يعد بحاجة إليها إلى مريض حياته معلّقة عليها دون أن نقبض أو ندفع فقط نعيد توزيع الحق اليوم، حين أقول إننا أمّنا أدوية بقيمة تقارب عشرة ملايين دولار، فأنا لا أتباهى، بل أتهم نظاماً جعل من التضامن الأهلي صمام أمان بدل من أن تكون الدولة.
يستكمل: "لم نكتفِ بالدواء اشتغلنا على الوعي، لأن الجهل شريك خفي للمرض. في 2019 و2020، أنشأنا “قرية التوعية من السرطان في وسط بيروت تسع مستشفيات، إحدى عشرة جامعة، سبع عشرة منظمة مجتمع مدني، اجتمعوا ليقولوا للناس إن السرطان ليس نوعاً واحداً، ولا قصة واحدة، ولا قدراً صامتاً.
ثم جاء كوفيد-19، وأُغلقت الأبواب فتحنا الشاشات على "زوم"، صار المرضى يلتقون، ونصف أطباء السرطان في لبنان انضموا ليشرحوا، يُطمئنوا، يجيبوا، كنا نعتقد أننا نعبر أزمة، ولم نكن نعلم أننا ندخل مجزرة.
مع الانهيار الاقتصادي، انقطعت أدوية السرطان ليس مجازاً انقطعت فعلياً مرضى في الدرجة الرابعة، حين يتوقف علاجهم، لا يمرضون أكثر، بل يموتون واحداً تلو الآخر، مجموعات الدعم التي كانت تعج بالحياة، صارت تمتلئ بصور النعوات. هنا، أدركنا أن الدعم النفسي لم يعد كافياً أغلقنا المجموعات، ونزلنا إلى الشارع، رفعنا الصوت، ظهرنا في الإعلام، مارسنا الضغط، لا لأننا هواة سياسة، بل لأن السياسة دخلت غرف المرضى دون استئذان فضحنا سرقات، أدوية كانت تصل مختومة بختم وزارة الصحة ثم تختفي في السوق السوداء، قلنا الأسماء حين لزم الأمر، وصرخنا حين لم يعد الهمس أخلاقياً.
حين تسلّم وزير صحة طبيب، فُتح باب، بدأ تعاون شاق، مليء بالتوتر، لكنه مثمر طالبنا بالمكننة، لأن الورق في بلدنا يموت قبل المرضى. ونجحنا اليوم، لم يعد المريض يذلّ نفسه على أبواب الوزارة الدواء يصل إلى المستشفى باسم المريض، مرتبطاً برقم هويته إنجاز تقني؟ نعم. لكنه في بلد مثل لبنان، انتصار أخلاقي، من 2021 حتى 2024، مظاهرات، اجتماعات، صدامات، حتى صار الحق مساراً لا استثناء.
التحدي النفسي والاجتماعي
حين بدأت الأدوية تتوفر، وحين صار هناك وفر في الأموال، قلنا:" الآن نعود إلى الإنسان، إلى ما بعد الجرعة إلى ما بعد المستشفى لأن السرطان لا ينهش الجسد فقط، بل يعزل الروح، من هنا وُلد مركز بربارة نصار لمرضى السرطان بيت، لا مؤسسة أربع طبقات، لكنها في الحقيقة أربع محاولات لإعادة ترميم ما تهدّم. في الطابق الأرضي، صيدلية مجانية، وحديقة فيها “جرس الأمل، المريض الذي ينهي علاجه يدق الجرس، يترك صوته معلقاً، واسمه محفوراً، ليقول لمن يأتي بعده، ممكن.
يقول نصار: "ثماني عيادات لإعادة التأهيل علاج فيزيائي، أسنان، تغذية، دعم نفسي شامل فوقها، مساحات للعلاج بالفن، بالموسيقى، بالدراما، بالحركة حتى الرقص، لأن الجسد الذي خُذل طويلاً يحتاج أن يتذكر إيقاعه أنشأنا مركز تجميل، ليس ترفاً، بل مقاومة المرأة التي يسقط شعرها، تتغير بشرتها، تحتاج أن ترى نفسها جميلة، أولاً لنفسها، ثم للعالم خلقنا مجتمعاً يضم أكثر من ألف مريض وأهلهم، يلتقون، يتشاركون الهواجس، لأن المشاركة تخفف وطأة الخوف.
ويؤكد نصار: "هذه ليست قصة جمعية هذه مرآة لوضع صحي لبناني مأزوم، تُرك ليُدار بالترقيع، حتى صار المجتمع المدني خط الدفاع الأخير. نحن لسنا بديلاً عن الدولة، ولا نريد أن نكون، نحن نتيجة غيابها.. ما فعلته بربارة، وما نحاول أن نكمله، هو تذكير دائم بأن الحق في الصحة ليس منّة، وأن المريض ليس عبئاً، وأن الروح التي تُكسر بالإهمال أصعب علاجاً من أي ورم.
على حافة الانهيار الصحي
في لبنان لا تبدو أزمة الصحة مجرد خلل إداري أو نقص تمويل عابر، بل هي انهيار بنيوي يغيّر معادلة الحياة والموت بين المستشفيات والمرضى، خصوصاً أولئك الذين يعبرون أقسى حدود المرض، مرضى السرطان.
وفق بيانات رسمية وغير رسمية، تتجاوز أرقام المرضى الذين يتلقون علاج السرطان الـ 12,500 شخص في لبنان، وقد تلقوا أكثر من 25,000 جرعة دوائية مموّلة ضمن برنامج وزارة الصحة، لكن ضمن حدود الإمكانات المتاحة، بعد أن كان توفير الأدوية يتأرجح بين الوفرة والنقص القاتل حسب الموسم والتمويل المتاح.
السرطان في لبنان لم يعد مرضاً فردياً فقط، بل عبء يتنامى على ظهر نظام صحي يعاني منذ سنوات الإحصاءات الرسمية تشير إلى ارتفاع معدل الإصابة من 65,2 إلى 117,3 وفاة لكل 100 000 نسمة بين عامي 1990 و2023، ما يجعل لبنان من بين الدول ذات المعدلات الأعلى للموتى بالسرطان في المنطقة ومع أن وزارة الصحة تشكك في بعض التوقعات العالمية، فإن تسجيل نحو 14 000 حالة سرطان سنوياً أخيراً، حيث تشكّل النساء نحو 8000 حالة والرجال 6000 يعكس ضغوطاً صحية متزايدة.
هذه الأرقام لا تشمل جميع المصابين الذين لم يتمكنوا من دخول النظام الرسمي للرعاية بسبب نقص الموارد أو انعدام التأمين، ما يعني أن العدد الحقيقي للمرضى قد يكون أعلى بكثير من الأعداد المعلنة.
في قلب هذه الأزمة، المستشفيات التي كانت يوماً ما تذخر بالخدمات الطبية في المنطقة، بدأت تتهاوى تحت وطأة الصدمات المتتالية للأزمات الاقتصادية والأمنية.
في عام 2024 فقط، أغلقت 15 من أصل 153 مستشفى أو تعمل جزئياً بسبب تداعيات الصراع، وفي بعض المناطق مثل النبطية انخفضت الطاقة الاستيعابية لأسرة المستشفيات بنسبة 40% هذه الأرقام لا تنقل فقط قصوراً في الخدمة، بل حياة مفقودة وفرص علاج تضيع، إذ كل سرير يفقده النظام الصحي يعني تأخيراً في جراحة أو علاج كيماوي أو رعاية متقدمة لمريض سرطان في مرحلة حرجة.
وفي هذه البيئة المتداعية تتجسد أزمة المستشفيات ليس فقط في أعداد الأسرة أو الأدوية، بل في الهجرة المكثفة لطاقم الكادر الطبي. بين 2020 و2021، زادت نسبة اللبنانيين الذين لا يغطيهم أي نوع من التأمين الصحي من 42,1% إلى 55%، بينما غادر نحو 20% من الممرضين و40% من الأطباء البلاد بحلول نهاية 2022، ما ترك فجوة كبيرة في الخبرات داخل المستشفيات.
هذا التفكك في الكادر الطبي يجعل من المستشفيات التي تعمل فعلياً جزراً من الجهد الفردي والكرم المهني بدلاً من نظام صحي قادر على تقديم رعاية شاملة ومتسقة.
ووفق إحصاءات غير رسمية، فإن لبنان يعالج أعداداً تتجاوز 230 إصابة جديدة بالسرطان لكل 100 000 شخص، وهو أعلى من كثير من دول الجوارما يضع ضغطاً إضافياً على نظام مصاب أساساً بالشلل.
كل هذه الأرقام تعكس أزمة متداخلة نظام صحي في حالة ضعف مزمن، ارتفاع في معدلات الإصابة، نقص في الأدوية، واستنزاف في الكفاءات الطبية المصادر الرسمية تقول إن برنامج “أمان” الذي أطلقته الوزارة لمعالجة نقص الدواء بدأ بتسع أدوية ثم توسّع ليشمل حوالي 300 دواء لعلاج السرطان والأمراض المزمنة، وهو مؤشر على محاولة مواجهة الأزمة، لكنه يبقى محدود الإمكانات مقارنة بحجم الاحتياجات.
بين الانهيار الاقتصادي والفقر الصحي
قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن النظر إلى المؤسسات الصحية في لبنان لا يمكن أن يقتصر على أرقام وجداول، بل هو مأساة إنسانية تحكي عن بلد انهار تدريجياً، والقطاع الصحي كان دائماً في قلب هذه الأزمة، لا يمكنه أن ينهار بالكامل، ولا مسموح له أن يستمر بلا دعم أو استقرار.
وأوضح الشافعي، في تصريحات لـ"جسور بوست"، أن التحدي الأول والأكثر وضوحاً هو التمويل، أو بالأحرى غيابه المستشفيات اللبنانية كانت تعتمد أساساً على نظام هش قائم على التحويلات المالية، التأمينات، ودفع الدولة المتأخر مع الانهيار الاقتصادي، هبطت قيمة الليرة بشكل كارثي، وارتفع الدولار إلى مستويات غير مسبوقة، ما قلب موازين التكلفة المستشفى الذي كان يستورد أدوية ومعدات على سعر صرف محدد وجد نفسه مضطراً لدفع 10 أضعاف، بينما المريض نفسه لم يعد قادراً على تغطية أي زيادة النتيجة كانت تضاعف الضغوط ارتفاع تكلفة التشغيل مع بقاء أسعار الخدمة “إنسانية” هو تناقض قاتل أدى إلى تقليص الخدمات، تأجيل العمليات، إغلاق أقسام، أو طلب دفعات مسبقة بالدولار، ما حول العلاج من حق أساسي إلى امتياز اقتصادي.
وأضاف الشافعي، أن أزمة الأدوية شكلت جانباً آخر من الأزمة الأخلاقية والاقتصادية في آن واحد شركات الاستيراد تطالب بالدفع النقدي بالدولار، والدولة غير قادرة على التدخل أو تقديم الدعم الكافي، مما فتح الباب للسوق السوداء. الأدوية تختفي من الصيدليات الرسمية لتظهر بأسعار مضاعفة أحياناً خمس إلى عشر مرات، ما يضع المؤسسات الصحية أمام خيار صعب: إما شراء الدواء من السوق السوداء للحفاظ على حياة المرضى، أو الالتزام بالقانون وترك المريض دون علاج. وصف الشافعي هذا الوضع بأنه “اختيار أخلاقي مستحيل في اقتصاد مكسور”.
ومن منظور إداري، أكد الشافعي، أن العديد من المؤسسات الصحية كانت تعمل بعقلية ما قبل الأزمة، من دون خطط للطوارئ، أو إدارة مخاطر، أو شفافية حقيقية كشفت الأزمة عن عُري هذه المؤسسات، من مستشفيات مفلسة، وحسابات مالية غير واضحة، إلى تداخل العلاقة بين السياسة والصحة، ما صعّب أي محاولات إصلاحية.
وأشار إلى أن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة الأسعار المرتفعة، التأمين غير الكافي، وضمان اجتماعي عاجز أو متأخر، جعلت المريض مسؤولاً عن مرضه وكأنه ارتكب خطأ. هذا ما وصفه بـ”الفقر الصحي”، حيث يضطر الناس إما للانتظار حتى تتدهور حالتهم الصحية أو مواجهة تكلفة علاج باهظة تزيد الضغط على الفرد والاقتصاد الوطني.
وأكد الشافعي، أن الأزمة الاقتصادية والصحية في لبنان تشكل دائرة مغلقة: قطاع صحي ضعيف يزيد الفقر، والفقر يزيد المرض، والمرض يضغط على مؤسسات مفلسة أصلاً من دون تدخل جدي، تنظيم، تمويل مستدام، ورقابة حقيقية، ستستمر هذه الدائرة في الدوران، والعبء الأكبر سيكون دائماً على المرضى والمواطنين.
لبنان والصحة في أزمات متداخلة
قال الإعلامي والكاتب السوداني سيبويه يوسف، إن أي نزاع مسلح في أي منطقة من العالم يصيب القطاع الصحي أولاً، مؤكّداً أن النظام الصحي هو الأكثر عرضة للتأثر عندما تتجه الموارد المالية إلى المجهود الحربي بدل الرعاية الإنسانية.
وأشار يوسف في تصريحات لـ"جسور بوست"، إلى أن لبنان مثال واضح على هذا الواقع، فدولة محدودة الموارد، تعتمد على اقتصاد هش، تتحمل صدمات كبيرة عند أي أزمة أو تصعيد، ما يجعل مؤسساتها الصحية عرضة للشلل أو الانهيار.
وأوضح أن المؤسسات الصحية تقوم على موارد محددة لتقديم خدمات أساسية للمواطن، وأن أي حرب أو نزاع يزيد العبء على هذه المؤسسات مشكلات مباشرة مثل الإصابات، النزيف، نقص دم المرضى، أو عدم القدرة على توفير أدوية وعلاجات أساسية تصبح شائعة في مثل هذه الظروف، وتزداد خطورة إذا ظهرت أوبئة أو أسلحة بيولوجية أو كيميائية، فشكل الأسلحة المستخدمة يؤثر مباشرة في طبيعة الإصابات والخدمات الطبية المطلوبة.
وأشار يوسف إلى أن لبنان، في ظل وضعه الاقتصادي الهش، يواجه تكاليف باهظة عند التعامل مع أي ضغط خارجي أو تدخل دولي، خاصة فيما يتعلق بعلاقاته مع دول إقليمية، حيث تصبح الموارد محدودة ومرتبطة باستقرار الدولة السياسي والاقتصادي وأضاف أن هذا الضعف الاقتصادي لا يقتصر أثره في الصحة فحسب، بل يمتد إلى التعليم والجغرافيا المجتمعية، ما يخلق واقعاً مأزوماً يتداخل فيه الفقر الصحي مع أزمات بنيوية طويلة الأمد.
وأضاف يوسف أن الأزمة اللبنانية ليست اقتصادية فقط، بل سياسية ودستورية واجتماعية، مع صراعات طائفية متجذرة تؤخر أي حلول عملية لمشكلات الصحة أو البنية التحتية وقال إن الإعلام يلعب دوراً أساسياً في معالجة هذه القضايا، لكنه يظل محدود الإمكانات ما لم يرفع صوته عالمياً الإعلام يمكن أن يرصد الكارثة الإنسانية ويصفها بدقة، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يُظهر للعالم أن لبنان ليست مجرد أزمة، بل كتلة دولة تحمل نسيجاً متماسكاً، قادراً على الصمود رغم الصراعات الداخلية والتحديات الإقليمية.
وقال يوسف إن لبنان اليوم يمثل مثالاً حياً على كيف يمكن للأزمات المركبة -اقتصادية، سياسية، وصحية- أن تتفاعل لتزيد معاناة الناس، وأن أي مقاربة لمعالجة القطاع الصحي يجب أن تأخذ في الاعتبار هذه العوامل مجتمعة، وتضع الإنسان في قلب الحلول، وليس الأرقام أو السياسة فقط في النهاية، يبقى الإعلام، الاقتصاد، والسياسة مترابطين بشكل لا يمكن فصله، وأي تدخل فعلي لإنقاذ الصحة العامة في لبنان يحتاج إلى رؤية شاملة تراعي هذه التعقيدات، مع التركيز على حماية المواطن قبل أي اعتبار آخر.