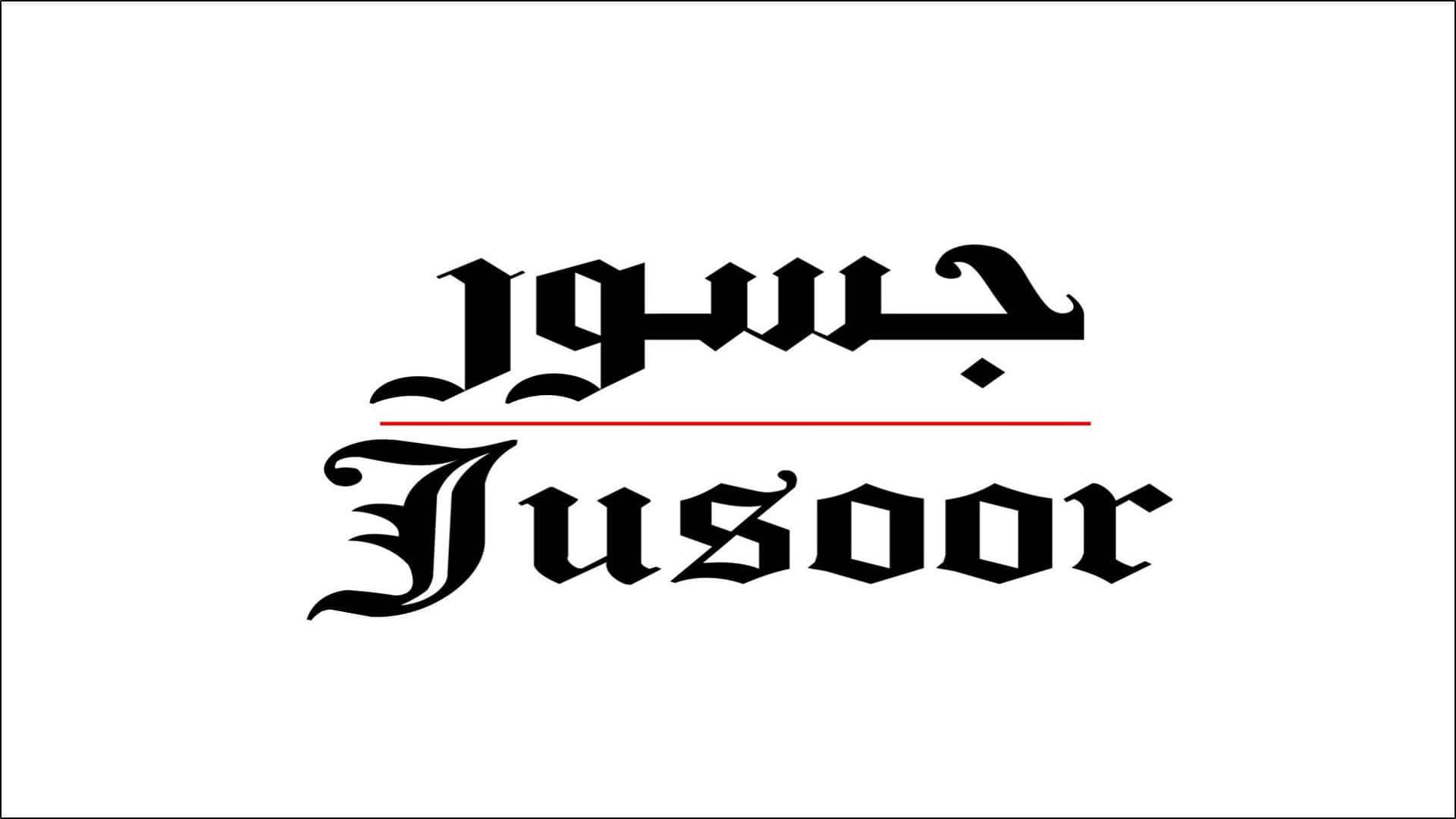«حرب غزة»... والثمن الذي يدفعه الصحافيون
«حرب غزة»... والثمن الذي يدفعه الصحافيون
يعرف الصحافيون المحترفون، الذين قضوا أوقاتاً طويلة في غرف الأخبار المؤسسية، عبارتين مُهمتين تتعلقان بتوصيف أهمية الأخبار؛ أولاهما تقول إن «الأخبار السيئة هي أخبار جيدة» (Bad News is Good News)، في حين تشير ثانيتهما إلى أن «الأخبار التي تتعلق بالدماء، تتصدر» (If It Bleeds, It Leads).
سيقول بعض النُّقاد إن هاتين المقولتين إنما تعكسان قدراً كبيراً من البراغماتية المهنية، وإنهما ربما لا تقيمان وزناً للآلام والمآسي التي تُنتج الأخبار الدامية، لكن هذا ليس حقيقياً تماماً؛ إذ يبدو أن الصحافيين يدفعون بالفعل أثماناً فادحة لقاء وجودهم في الخطوط الأمامية لكتابة التاريخ، حيث تنقل أخبارهم نكبات ومواجع وتراجيديات إنسانية يجب أن يعرفها العالم، وإلا فما فائدة الصحافة؟
كان هذا ما حدث على مدى عامين منذ اندلاع «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023؛ فالأنباء تأتي من غزة كل يوم، ومعها الفيديوهات والصور المأساوية، والصحافيون يُقتلون أو يُصابون أو يفقدون بيوتهم وأحبتهم على مدار الساعة، في حين لا يكون بوسعهم سوى مواصلة العمل، وتحت أي ظروف.
ففي خضم الأزمات والحروب الدموية تبرز معضلة: هل يُخفي الصحافيون ميلاً خفياً لاندلاع الصراعات لأنها تمدّهم بأخبار ساخنة وقصص مثيرة تتصدر العناوين، أو أن الواقع أشد قسوة؛ إذ يدفعهم ثمن التغطية وسط المآسي إلى الأرق والإحباط، مُستنزَفين نفسياً وهم يشهدون الكوارث الإنسانية؟ «حرب غزة» الأخيرة، التي يبدو أنها في طريقها للتوقف الآن، تطرح هذا التساؤل؛ فمع تصاعد دخان المعارك، وجد الصحافيون أنفسهم في قلب المأساة. فهل كانت أنباؤها الجسام مجرد مواد دسمة للعمل الصحافي، أو حملاً ثقيلاً ترك أثره العميق في نفوسهم؟
لا يمكن إنكار أن بعض المراسلين يعترفون بأن «الأدرينالين» يتدفق في عروقهم عندما يجدون أنفسهم في قلب حدث جلل، فيندفعون نحو الخطر فيما يفر الآخرون. لكن هذا لا يعني أن الصحافيين يحبون الحروب أو يرحبون بالصراعات؛ فكثير من المراسلين الميدانيين المُخضرمين يرفضون فكرة أنهم يستفيدون من المآسي. وهؤلاء يؤكدون أن تغطية الصراعات ليست اندفاعاً وراء الخطر بقدر ما هي رسالة ومسؤولية. وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن الوجود تحت القصف، وفي ظلال الموت، ليس سعياً بالضرورة وراء الخطر لذاته، بل رغبة في الشهادة على الحقيقة وإيصالها.
صحيح أن الأحداث الكبرى تثير حماسة الصحافي، وتدفعه لبذل قصارى جهده المهني، لكن التكلفة الإنسانية والنفسية لهذه التغطيات جسيمة؛ فمشاهد الموت والمعاناة المتكررة تترك ندوباً لا تُمحى في نفسية المراسل. وقد وجدت دراسات أكاديمية أن مراسلي الحروب يعانون من معدلات مرتفعة من «اضطراب الكرب التالي للصدمة والاكتئاب»، تقارب مستويات الجنود العائدين من القتال. وبينما يتعرض المراسل للخطر مراراً من دون حصانة نفسية كتلك التي لدى الجندي، فإنه يتجرع الصدمات بصمت، والبعض ينهار تحت العبء النفسي الرهيب.
من بين هؤلاء، المصور الجنوب أفريقي كيفن كارتر، الذي قدم أحد أكثر الأمثلة مأساوية على ذلك؛ إذ التقط صورة أيقونية لمجاعة جنوب السودان، في التسعينيات الفائتة، هزّت ضمير العالم، لكن ما رآه من فظائع طارده في كوابيسه. انتحر كارتر عام 1994، تاركاً رسالة قال فيها إنه «مُطارد بذكريات حية عن القتل، والمسلحين الذين يحاربون كالمجانين، وركام الجثث، وعن أطفال يتضورون جوعاً»، بينهم طفل ظل نسر ينتظر «نفوقه»، حتى ينهش عظامه؛ إذ لم يكن قد تبقى لديه لحم من أثر المجاعة. كلمات كارتر الأخيرة كشفت كم قد يفوق الألم النفسي قدرة الإنسان على الاحتمال لدى من جعلوا المأساة عملهم اليومي.
في «حرب غزة» الأخيرة، تبدو هذه الحقائق جلية أكثر من أي وقت؛ فقد غدا القطاع أخطر مكان للعمل الصحافي في العالم؛ إذ فقد عشرات الصحافيين حياتهم أثناء أداء واجبهم، منذ اندلاع القتال والقتل، لتضحى غزة عن حق «مقبرة للصحافيين».
مع هذه المعاناة اليومية، ليس غريباً أن يشعر الصحافي بإرهاق عقلي ونفسي؛ فالتغطية المستمرة للمآسي تحرم العقل من الراحة. كل صورة لأم ثكلى، أو طفل مُمزق الأشلاء، تبقى مُرتسمة في الذاكرة، وتمنع الصحافي من نسيانها مهما حاول. هذه ليست إثارة حماسية، بل صدمة مُركزة ومُمتدة، تضع الإنسان في حالة استنزاف دائم.
فلماذا يستمر الصحافيون في خوض غمار هذه المآسي إذا كانت تكلفتها النفسية باهظة؟ الدافع الأعمق ليس حباً بالكوارث، بل ربما إخلاصاً للمهنة، أو شغفاً بها، أو تلبية للواجب، أو إيماناً بمسؤولية كشف الحقيقة.
قد يبدو أن الصحافة تزدهر في الصراعات، وهذا قد يكون صحيحاً على مستوى المؤسسات الإعلامية التي تجد مادة وفيرة للتغطية، لكن على مستوى الصحافي الفرد الإنسان، تظل التكلفة عميقة وثقيلة، وربما أفدح من الاحتمال.
نقلاً عن الشرق الأوسط