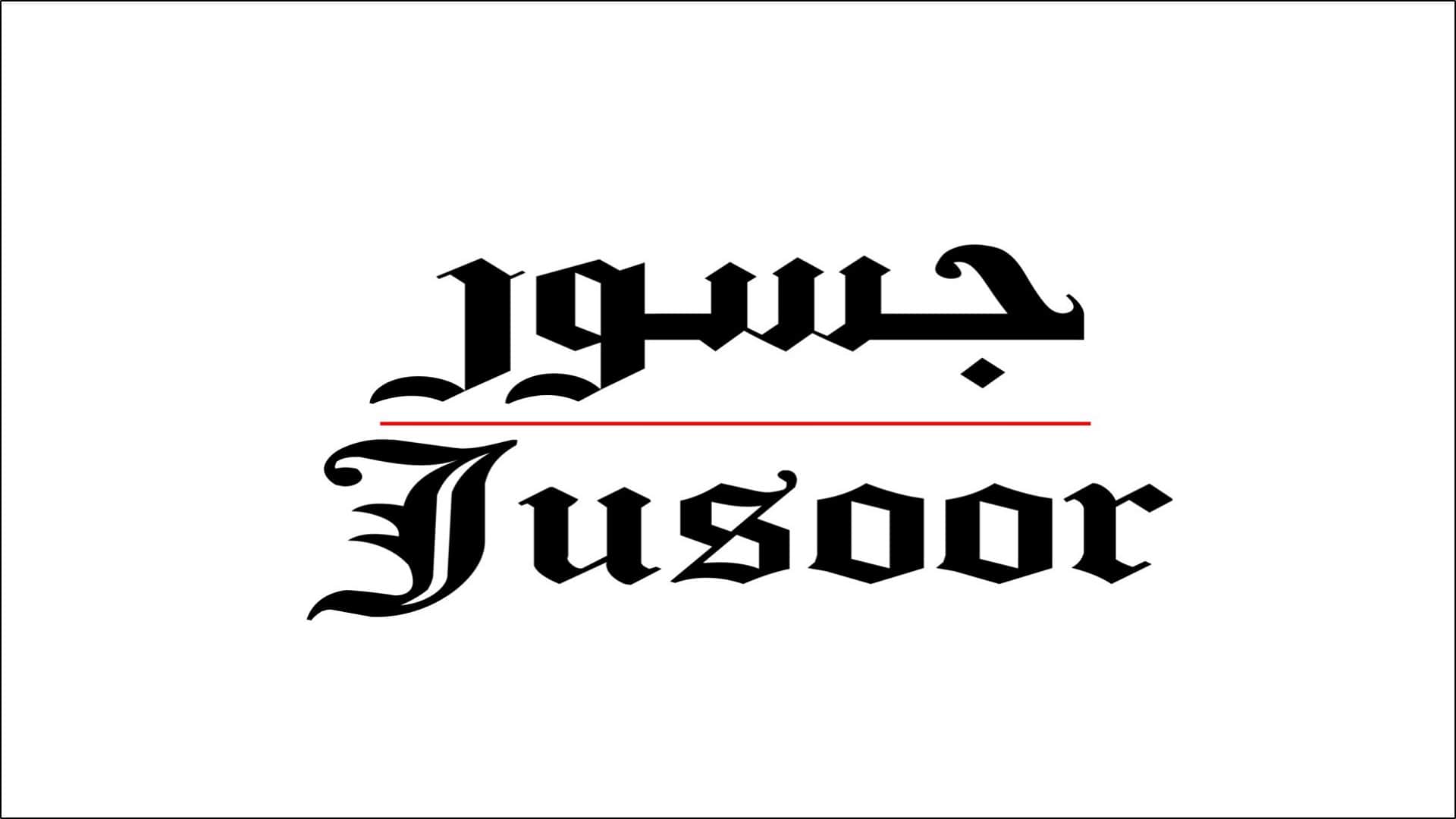درس المعبد
درس المعبد
تلقيت دعوة كريمة من وزير السياحة والآثار المصري في الأسبوع الأخير من عام 2019 لحضور افتتاح المعبد اليهودي الكبير بالإسكندرية بعد ترميمه وتجديده، الذي يقع في مواجهة الكنيسة المرقسية وقد بني على أرض كانت ملكاً لها منذ عقود عدة.
الوزير قال إن الافتتاح سيكون حفلاً عالمياً يحضره ممثلون لرموز الديانات السماوية الثلاث ومحافظ الإسكندرية والشخصيات العامة من أبناء الثغر وغيره من عموم البلاد، وإن أبناء الطائفة اليهودية سيكونون أول المدعوين، لأن مصر عرفت التسامح الديني منذ فجر التاريخ ولم تفرق بين دين وآخر واحترمت أهل الكتاب، وهي تقف اليوم لكي تقول للعالم كله إن دور العبادة موضع تقديس واحترام.
وأضاف الوزير المتميز قائلاً إنه سيفتتح في اليوم نفسه مسجداً تاريخياً في أحد الضواحي ثم يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية ويتوج ذلك اليوم الذي يرعاه رئيس الدولة بافتتاح تجديدات المعبد اليهودي الكبير.
لقد تلقيت الدعوة شاكراً، وقد كنت مديراً لمكتبة الإسكندرية في ذلك الوقت، لكن الوزير أشار إلى أن هناك توجيهاً بأن تكون الكلمة الافتتاحية للحفل هي لمدير مكتبة الإسكندرية باعتبارها شاهدة العصور وملتقى الثقافات والحضارات والديانات.
وبالفعل ذهبت إلى الحفل الكبير ولفت نظري ذلك الجهد الضخم الذي بذلته وزارة الآثار في ترميم ذلك الصرح الديني الذي يقع في قلب العاصمة الثانية للبلاد، وحضر الحفل عدد كبير من رجال الدين والأثريين والمسؤولين الحاليين والسابقين يتقدمهم الأثري المعروف زاهي حواس ويتصدر الحفل صاحب الدعوة وزير السياحة والآثار وقتها خالد عناني.
كما كان في مقدمة الحاضرين محافظ الإسكندرية ورجال الدولة من مختلف الوزارات إلى جانب أمين عام المجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري وكبار مهندسي شركة "المقاولين العرب" الذين قاموا بعملية الترميم بتكليف من الدولة المصرية وإشراف من الوزارة المعنية.
وعندما جاءت كلمة الافتتاح التي سألقيها، فوجئت بأن عدد (الميكروفونات) على منصة الخطابة تفوق أي عدد رأيته في حياتي في كل المناسبات التي عايشتها، وآمنت أن كل ما يتصل بالتعامل مع اليهود يبدو مثيراً من الناحية الدولية ومهماً للوكالات العالمية، خصوصاً إذا كان المعبد الذي يعاد افتتاحه يقع في دولة عربية إسلامية.
لقد ألقيت كلمة ضافية باللغتين العربية والإنجليزية، تحدثت فيها عن تاريخ اليهود في المنطقة والسماحة التي عاشوا في ظلالها داخل الدول العربية، خصوصاً مصر، وكيف كان وزير المالية المصري يهودياً مصرياً هو قطاوي باشا في عشرينيات القرن الماضي حين تمتع اليهود في عموم البلاد المصرية بجميع المزايا، حتى إن الحاخام الكبير كان عضواً في لجنة إعداد دستور عام 1923.
كما امتلك اليهود شركات كبرى وكانوا مؤثرين في مجالات المال والاقتصاد بل والإعلام أيضاً، فقد أصدروا في أربعينيات القرن الماضي مجلة باسم (الكاتب) وعهدوا إلى عميد الأدب العربي وزعيم الاستنارة طه حسين رئاسة تحريرها، بخاصة أن ذلك التنويري الكبير فاقد البصر ومالك البصيرة ابن صعيد مصر هو نفسه الذي مثل الدولة المصرية في افتتاح الجامعة العبرية بالقدس في فلسطين عند منتصف عشرينيات القرن العشرين.
فلم يكن لدى المصريين محاذير تجاه الديانة اليهودية عبر التاريخ، بل وفرقوا إلى حد كبير بين جرائم إسرائيل في حق الفلسطينيين والعرب وبين وجودهم في النسيج الحضاري في المنطقة، بل وشراكتهم في بعض مراحل الحضارة العربية الإسلامية.
ولقد كان الجو يوم هذه المناسبة مفعماً بالمشاعر، وعلى الرغم من قلة عدد اليهود المصريين الذي ما زالوا في البلاد إلا أنني رأيت ماجدة هارون رئيسة الجالية اليهودية في مصر تبكي بحرقة، وقالت لي إنها شعرت لأول مرة بأن الوطن المصري يحتضن كل أبنائه، وهي بالمناسبة سليلة بيت يهودي مصري يتسم بالإخلاص للوطنية المصرية والانتماء لليسار القومي.
لقد مارس اليهود المصريون أدواراً واضحة في تاريخ الحركة الشيوعية بالبلاد إلى جانب إسهاماتهم في الحركة الوطنية عندما تيسر لهم ذلك، ولذلك فإنني أعبر، كما ذكرت مراراً، عن الأسف الشديد لأننا لم نتمكن من معالجة مسألة الوجود اليهودي في العالم العربي بذكاء وحكمة، بل تركنا لحماس الظروف وعواطف بعض المراحل المشتعلة من تاريخنا أن تتحكم في قراراتنا على نحو أدى إلى خروج أعداد ضخمة من الأجانب من البلاد، خصوصاً من الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والمنصورة وغيرها من المدن الكبيرة في الدولة المصرية.
لم يكن خروج اليهود منفرداً، بل صاحبهم في ذلك الموقف اليونان والطليان والأرمن والشوام وغيرهم من الجنسيات الصديقة الذين كانوا يتميزون بالولاء الواضح للتراب الوطني ويقدرون رعاية مصر لكل أبنائها والوافدين إليها كافة.
دعني أكتب الآن عن ملاحظات ثلاث ترتبط بهذا الموضوع وقد ثارت في ذهني كدرس ليوم إعادة افتتاح ذلك الكنيس الكبير مؤمناً بأن "درس المعبد" يستحق التأمل، على الرغم من فوات الأوان، وهذه الملاحظات هي:
أولاً: إن المجتمعات التي تتصف بتعدد الأصول والأعراق هي بالضرورة أكثر تقدماً وتألقاً من تلك التي تتعصب لجنس بعينه أو قومية بذاتها، ولا يتعارض ذلك بالطبع مع مفهوم الانصهار الوطني الذي يحميه مبدأ المواطنة الذي يجعل الجميع متساوين في المراكز القانونية والحقوق السياسية ما داموا يقفون على أرضية وطنية ويؤمنون بالوطن ويحاربون من أجله إذا لزم الأمر، وذلك هو المفهوم الحديث للدولة العصرية التي لا تفرق بين الناس بسبب الأصول أو الأجناس أو الديانات، ومصر كانت ولا تزال مؤهلة أكثر من غيرها لتلعب هذا الدور التنويري المعاصر الذي تفتقده شعوب الشرق الأوسط وغيرها من الأمم الموازية في جميع قارات العالم، لقد حان الوقت ليرفع الجميع شعار الدولة الوطنية بلا تعصب أو شيفونية حمقاء أو تمييز أو إقصاء.
ثانياً: إن من سماحة المصريين أن تجدهم يتحدثون أحياناً في مجالسهم الخاصة عن ذلك الطبيب المسيحي النابه لشعب يرى في أسطورة مجدي يعقوب نموذجاً يعتز به الجميع باعتباره أيقونة مصرية عالمية يفاخر بها كل من ينتمي إلى هذا الوطن بدلاً من التركيز على قصة الجنرال يعقوب الذي كان لحناً نشازاً لا يعبر عن التيار العام بين أشقائنا في الوطن أثناء الحملة الفرنسية، وليتذكر الجميع أن العلم لا وطن له، وأن الطب رسالة إنسانية سامية، وأننا نتذكر جميعاً مدرسينا العظام في مراحل التعليم المختلفة وكيف كان الأقباط منهم، بل واليهود، يتفانون في خدمة تلاميذهم في المدارس والجامعات.
ثالثاً: إنني أتذكر يوم أن كنت طالباً في السنة الأولى الإعدادية بالمدرسة الأميرية في دمنهور عام 1956، وكان معي في الفصل زميل يهودي أتذكر اسمه جيداً وهو رحمين إبراهيم رحمين، وكنا نلعب معاً في براءة خلال حصص الألعاب ونتجاور أثناء الدروس ولا يشعر أحدنا باختلاف عن زميله، وتصادف أن وقع العدوان الثلاثي على مصر وعدنا إلى المدرسة لنجد أن زميلنا اليهودي قد اختفى وغادر البلاد مع أسرته بعد أن بدأ التضييق على الجالية اليهودية بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية في جانب والقرارات الاشتراكية بالتأميم والتمصير في جانب آخر، عندئذ بدأ الوطن يفقد جزءاً من رونقه ويخبو توهج ضيائه الذي عهدناه دائماً.
إن مناسبة إعادة افتتاح المعبد الكبير بالإسكندرية في الأيام الأخيرة من عام 2019 قد دفعتني إلى كتابة هذه السطور لأعبر عن اعتزازي بتعددية تاريخ المجتمع المصري وروافده المختلفة وكيف أن مصر كانت دائماً بلد العطاء والإخاء والمحبة، ولا بد أن تعود يوماً ما إلى سالف عهدها لترفض التعصب وازدراء الغير وتستوعب كل تقاليد التسامح التي نشأت فيها ومظاهر الانصهار الاجتماعي التي عرفت بها، ولا ينسحب الأمر على مصر وحدها، ولكنها نموذج لمجتمعات أخرى بدءاً من العراق وصولاً إلى المغرب، وهما دولتان عرفتا الجالية اليهودية ودورها في الحياة وفي مجالات الأدب والفن حتى إن المسرح العربي والسينما المصرية مدينان للشراكة الأجنبية بجزء كبير من أسباب الشهرة وعوامل الانتشار، ولا يزال صوت ليلى مراد يصدح في الآذان وهي تغني لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقت أن كانت يهودية الديانة وقبل أن تتحول إلى الإسلام طواعية، وهي القادمة من أسرة فنية كبرى، فوالدها زكي مراد وشقيقها منير يوم أن كنا لا نعرف الناس بدياناتهم، فكثيرون لا يتساءلون عن ديانة الفنانة الرائعة فيروز أو الممثل العملاق نجيب الريحاني، فالكل سواء تحت قبة العروبة والمظلة القومية التي يعتز بها الجميع بغير استثناء.
نقلا عن “إندبندنت عربية”
كاتب المقال: د.مصطفى الفقي سياسي مصري