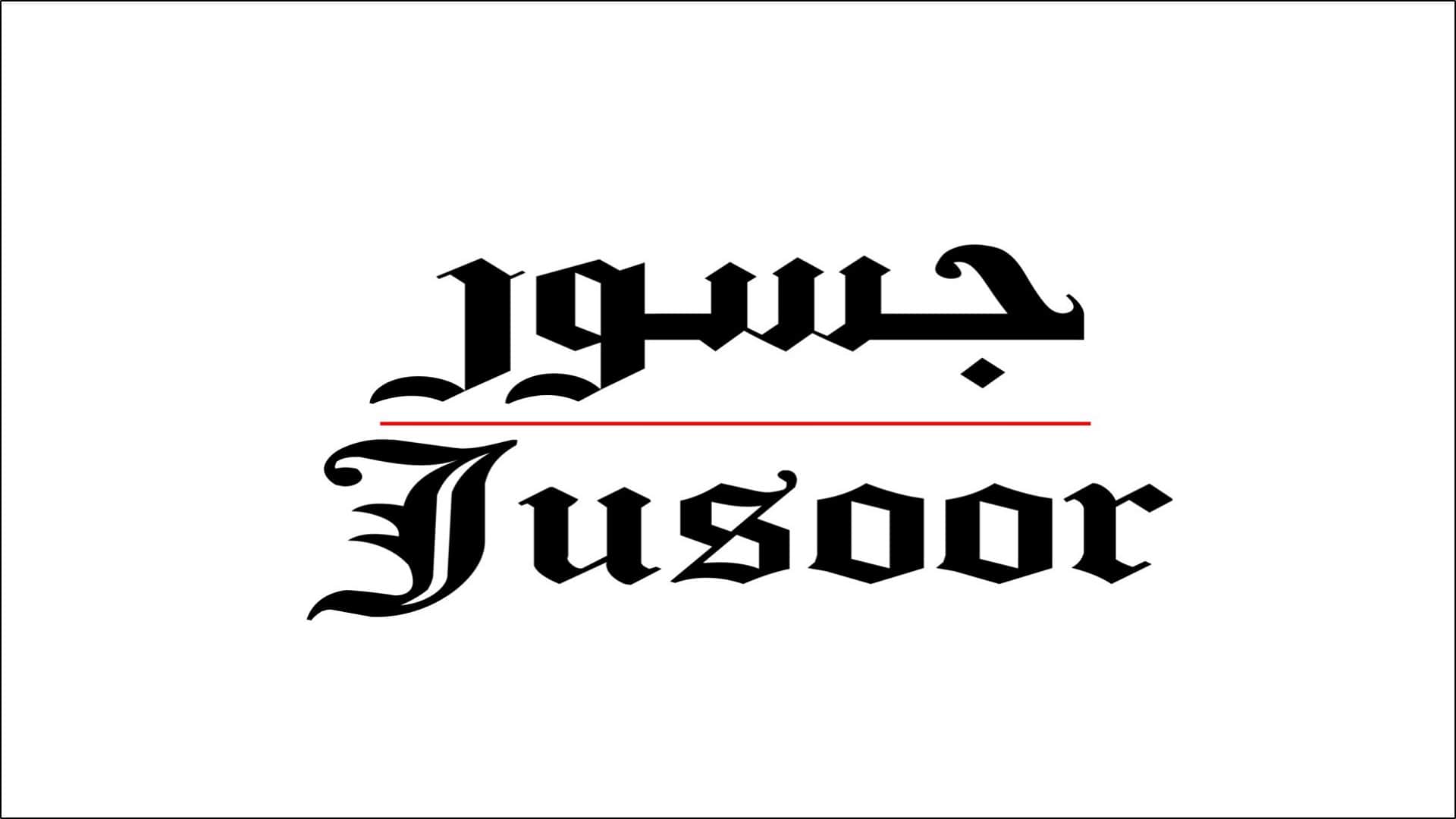المدير التنفيذي لـ«غرينبيس الشرق الأوسط»: خطر التغير المناخي يلحق بالعالم أجمع.. والنساء الأكثر تضرراً (حوار)
«غوى النكت» لـ«جسور بوست»: الحرب في غزة ولبنان مثال صارخ للتدمير البيئي
اختتمت قمة المناخ (كوب29) أعمالها في العاصمة الأذربيجانية باكو، التي انعقدت تحت شعار "تضامناً من أجل عالم أخضر"، وقد شكلت القمة فرصة محورية لمناقشة سبل تسريع العمل الدولي للتصدي لأزمة المناخ المتفاقمة، مع التأكيد على أهمية تضامن الدول لمعالجة تداعيات تغير المناخ التي باتت تهدد مستقبل الكوكب.
وركزت القمة بشكل أساسي على تعزيز التزامات مالية جديدة لصالح الدول الفقيرة التي تعاني بشدة من آثار تغير المناخ، مثل موجات الحر، والعواصف، والفيضانات، التي باتت أكثر تكراراً وشدة، وتمثل هذه التحديات عبئاً كبيراً على الاقتصادات الهشة، ما يجعل توفير التمويل المستدام أولوية قصوى لضمان حماية المجتمعات الأكثر عرضة للخطر.
وفي مقابلة أجرتها "جسور بوست" مع غوى النكت، المدير التنفيذي لمنظمة غرينبيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تم التطرق إلى التحديات البيئية في المنطقة العربية خلال العام الحالي، التي تفاقمت بفعل النزاعات المسلحة.
وأوضحت النكت، أن الحروب ألحقت أضراراً بيئية كبيرة، ما زاد من تعقيد الجهود الرامية للتكيف مع تغير المناخ والحد من تداعياته، مؤكدة أن المجتمع المدني يلعب دوراً محورياً في التصدي للأزمة المناخية من خلال رفع الوعي، والضغط على الحكومات لتبني سياسات خضراء، وتعزيز الشراكات الدولية.
ودعت المدير التنفيذي لمنظمة غرينبيس، إلى تفعيل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها خلال القمة، لضمان تحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات المناخية.. فإلى نص الحوار:
ما القضايا الملحّة التي ركزت المنظمة عليها خلال مؤتمر المناخ «كوب 29»؟
مؤتمر المناخ كوب 29 عرف بقمة التمويل، حيث سعت الدول النامية للوصول إلى تمويل مناسب بدعم جهودها في مواجهة التغير المناخي، وعلى الرغم من أن الرقم الذي توصلت إليه القمة أقل من المستهدف فإنه خطوة جيدة يمكن البناء عليها في السنوات المقبلة.
وكانت الدول النامية تأمل في أن تخصص الدول الغنية -التي تتحمل مسؤولية تاريخية عن الانبعاثات العالية- ما لا يقل عن تريليون دولار لتمويل المناخ، إلا أنه تم الاتفاق في النهاية على تخصيص 300 مليار دولار سنويا فقط.
هل ينجح العالم في خفض الانبعاثات بنسبة 43% والالتزام بما جاء في اتفاق باريس؟
تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030، كما نص عليه اتفاق باريس، يمثل تحديًا كبيرًا للمجتمع الدولي، حيث تشير التقارير الحديثة إلى أن الخطط الحالية للدول، حتى إذا نُفذت بالكامل، قد لا تكون كافية للوصول إلى هذا الهدف، فعلى سبيل المثال، أظهر تقرير للأمم المتحدة أن الانبعاثات قد تنخفض بنسبة 2.6% فقط بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، وهو ما يقل بكثير عن النسبة المستهدفة.
لتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر تعزيز الطموحات المناخية وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) لتكون أكثر جرأة وفورية، ويجب زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير تقنيات احتجاز الكربون، كما يتعين على الدول المتقدمة الوفاء بالتزاماتها المالية لدعم الدول النامية في جهودها للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي.
ويمكن القول إن النجاح في تحقيق خفض الانبعاثات بنسبة 43% يتطلب تعاونًا دوليًا مكثفًا، وتطبيق سياسات فعّالة، والتزامًا حقيقيًا من جميع الأطراف المعنية.
ما الإجراءات التي يجب اتخاذها لضمان أن يكون انتقال الطاقة عادلاً؟
ندعم في منظمة "غرينبيس" الانتقال العادل للطاقة في المجتمعات المتضرّرة نحو التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ويعني "الانتقال العادل" إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، والانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة بطريقة عادلة للجميع، ولا سيما للأشخاص الذين يعملون في القطاعات الملوثة، والبلدان منخفضة الدخل التي تعتمد على الوقود الأحفوري.
ويتطلب الانتقال العادل للطاقة دعم المجتمعات المتأثرة بالتحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، من خلال توفير برامج لإعادة تدريب العمال وخلق وظائف جديدة في قطاع الطاقة النظيفة، كما يتطلب تحقيق عدالة الطاقة تمويلاً دولياً وسياسات مالية تعزز الوصول المتكافئ للطاقة المتجددة، مثل تقديم حوافز وإعانات للأسر ذات الدخل المحدود والمناطق النائية.
لذلك، يُعدّ التمويل الدولي للمناخ من قبل البلدان الغنية المتقدمة عاملًا بالغ الأهمية لتمكين الانتقال العادل في البلدان ذات الدخل المنخفض، فهناك حاجة للتمويل لتوفير الموارد للطاقة المتجددة، فضلاً عن التنويع والتحول الاقتصادي على نطاق أوسع؛ وعلى وجه الخصوص في البلدان منخفضة الدخل التي تعتمد بشكل كبير على عائدات الوقود الأحفوري للخدمات العامة والعمالة والاستثمار، وتلك التي لديها قدرة محدودة على الوصول إلى الطاقة المتجددة، نظرًا للفوارق الهائلة في الاستثمار في الطاقة المتجددة بين البلدان.
من وجهة نظركم.. كيف يمكن العمل على تعزيز وتوجيه الانتقال نحو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
في البداية تعد إعادة توجيه الدعم المُقدم حالياً للوقود الأحفوري نحو مشاريع الطاقة المتجددة خطوة حاسمة، حيث تُنفق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مليارات الدولارات سنوياً لدعم الوقود الأحفوري، ويمكن استثمار هذه الأموال في تعزيز البحوث وتطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، ما سيخلق فرص عمل جديدة ويعزز من العدالة الاجتماعية، ما سيُمكّن المجتمعات الفقيرة والفئات الأكثر ضعفًا من الوصول إلى طاقة نظيفة وميسورة التكلفة.
ويجب تعيين الإمكانات الحقيقية لمصادر الطاقة المتجددة، حيث تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة تتراوح بين 22 و26% من إجمالي الإشعاع الشمسي على كوكب الأرض، ما يجعلها مثالية للاستفادة من الطاقة الشمسية، ويمكن لكل كيلومتر مربع من هذه المنطقة توليد طاقة شمسية تعادل 1-2 مليون برميل من النفط سنويًا، ما يعادل نصف احتياجات العالم من الكهرباء، كما أن ثلاثة أرباع المنطقة تتمتع بسرعات رياح تتجاوز الحد الأدنى المطلوب لمشاريع طاقة الرياح واسعة النطاق، وهذا يفتح المجال أمام المنطقة لتكون رائدة في تصدير الطاقة المتجددة.
ويجب اعتماد سياسات حكومية داعمة تتمثل في تقديم حوافز ضريبية وإعانات لمصلحة مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية لنقل وتوزيع الطاقة المتجددة، واستحداث قواعد وأنظمة صارمة بشأن الانبعاثات الكربونية، وتوجيه الصناعات نحو حلول طاقة أنظف، وإطلاق حملات تثقيفية لتوعية الجمهور حول الفوائد البيئية والاقتصادية للطاقة المتجددة.
ويعد اتباع نهج مبتكر وشامل للاقتصاد الذي لا يعتمد على عائدات النفط والغاز أمراً حيوياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن خلال تنويع اقتصاداتها، ستتمكّن دول المنطقة من تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلّب أسعار النفط والانخفاض المتوقع في الطلب العالمي عليه، ويجب تشجيع الشراكات بين الدول لتبادل المعرفة والتكنولوجيا، خاصة مع البلدان التي نجحت في التحول إلى الطاقة المتجددة.
ولتحقيق انتقالٍ ناجح، من الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب، وخلق قوة عاملة ماهرة قادرة على قيادة قطاع الطاقة المتجددة واستدامته، ويتعيّن على الجامعات والمؤسسات المهنية تقديم دورات متخصّصة، مدعومة بشراكات في مجال الصناعة، لتقديم الخبرات العملية.
كيف يمكن دعم الدول الفقيرة للتحول للطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري؟
يمثل التحول إلى الطاقة المتجددة فرصة ذهبية للدول النامية لتعزيز الوصول إلى الطاقة النظيفة، وتقليل الاعتماد على الواردات الباهظة للوقود الأحفوري، وخلق فرص عمل، وتقليل التلوث وتعزيز الصمود والاستقلال الاقتصادي، لكن هذا التحول يتطلب استراتيجية شاملة تُعالج التحديات الفريدة التي تواجهها هذه الدول، مع الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تقدمها مصادر الطاقة المتجددة.
ويعد تحويل الدعم المالي المقدم للوقود الأحفوري إلى مشاريع الطاقة المتجددة خطوة ضرورية، فمثل هذا التحول لا يُسهم فقط في تقليل الانبعاثات الضارة، ولكنه يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي، وتحسين الصحة العامة، وزيادة المساواة الاجتماعية، خاصة للمجتمعات الأكثر هشاشة.
كذلك فإن دعم الدول الفقيرة بالتمويل الدولي والمساعدات التقنية أمر لا غنى عنه، ويجب أن تفي الدول الغنية بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ من خلال توفير الموارد اللازمة لنقل التكنولوجيا، وتخفيف أعباء الديون، والاستثمار في البنية التحتية للطاقة النظيفة.
وتحتاج الدول الفقيرة إلى إصلاح أطرها التنظيمية لتسهيل الموافقات على مشاريع الطاقة المتجددة، وجعل هذه المشاريع جذابة للمستثمرين، ويمكن تحقيق ذلك عبر تقليل المخاطر الاستثمارية، وتخصيص الأراضي لمشاريع الطاقة النظيفة، وتقديم الحوافز الاقتصادية.
ويجب أن تتضمن خطط العمل المناخية الوطنية أهدافاً طموحة ومتوافقة مع هدف الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية، ولتحقيق ذلك، ينبغي زيادة حصة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء العالمية من 29% اليوم إلى ما لا يقل عن 60% بحلول عام 2030.
أيضا، تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات ضروري لتطوير حلول مستدامة وشاملة، فلا يمكن لأي دولة أن تواجه هذا التحدي بمفردها، والتعاون بين الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص سيشكل حجر الزاوية في نجاح هذا التحوّل.
كيف تؤثر التغيرات المناخية على النساء والأقليات والسكان الأصليين والفئات الأكثر ضعفاً؟
تُقر العدالة المناخية بالآثار الاجتماعية والاقتصادية والصحية المتفاوتة التي تترتب على أزمة المناخ، وهذه الأزمة لا تؤثر على الجميع بالتساوي، فالمجتمعات الأكثر ضعفاً، التي تتحمل أقل المسؤولية عن الانبعاثات، هي التي تدفع الثمن الأكبر لأزمة تغير المناخ، وتتحمل تبعاتها الأكثر قسوة، وهذا يؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة والظلم الاجتماعي والاقتصادي، وتعد البلدان منخفضة الدخل، وكذلك السكان الأصليون والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة، من الأكثر عرضة للكوارث المناخية.
بالنسبة للسكان الأصليين، فإنهم من أوائل المجتمعات التي تواجه تبعات تغيّر المناخ، بسبب ارتباطهم العميق بالموارد الطبيعية مثل الأراضي الزراعية والمياه العذبة التي تتأثر بشكل كبير بالتغيرات المناخية، هذه التغيرات لا تقتصر فقط على تهديد مصادر معيشهم، بل تضر أيضاً بهويتهم الثقافية.
كما أن العرق والطبقة الاجتماعية يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بعدم المساواة في آثار تغير المناخ، فالأقليات العرقية غالباً ما تعيش في مناطق أكثر عرضة للكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف، بالإضافة إلى ذلك، تعاني من صعوبة أكبر في الوصول إلى الموارد والفرص اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية، كما أن التمييز الاجتماعي يعيق مشاركتهم في السياسات المناخية، ما يزيد من معاناتهم في أوقات الأزمات.
وتعتبر النساء أكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، بسبب الأدوار الاجتماعية والاقتصادية التي يؤدينها في العديد من المجتمعات، لا سيما في الدول النامية، وغالباً ما تتحمل النساء مسؤولية توفير الموارد الأساسية مثل المياه والغذاء والطاقة للأسر، وهي موارد تصبح أكثر ندرة بسبب التغيرات المناخية مثل الجفاف والفيضانات.
وتعاني النساء من محدودية الوصول إلى الموارد المالية والتعليمية والتقنية التي يمكن أن تساعدهن على التكيف مع آثار الكوارث المناخية. في أوقات الأزمات، مثل النزوح الناتج عن الكوارث، تزداد معاناة النساء مع ارتفاع معدلات العنف القائم على النوع الاجتماعي، كما أن الأدوار التقليدية تعيق مشاركتهن في صنع القرارات المتعلقة بالتغير المناخي، ما يقلل من قدرتهن على حماية أنفسهن ومجتمعاتهن، لهذا، يمثل تمكين النساء ودعمهن عنصراً أساسياً لتحقيق استجابات عادلة ومستدامة للتغير المناخي.
وعندما تحدث كوارث مناخية، فإن النساء والأطفال يواجهون احتمالية وفاة تزيد بـ14 مرة على الرجال، نتيجة لضعف الوصول إلى المعلومات، والمحدودية في التنقل، وصعوبة اتخاذ القرارات، وتُشير التقديرات إلى أنّ 80% من المشرّدين بسبب تغير المناخ هم من النساء، وعندما تتشرد النساء، يصبحن أكثر عرضة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي، كما أنّ الكوارث المناخية الحادة قد تُعطل الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، ما يؤدي إلى تفاقم الآثار السلبية على النساء والفتيات.
كيف تنظرون إلى واقع الحرب في غزة ولبنان وتأثيراتها البيئية؟
النزاعات المسلحة تُسبب دمارًا هائلًا يؤثر بشكل عميق على البيئة والصحة العامة وسبل العيش، والحرب على غزة ولبنان، تعد مثالًا صارخًا للتدمير البيئي، بما يتضمن تدمير النظم البيئية، وتلويث الموارد الطبيعية، وتدهور التنوع البيولوجي، ما يهدد الحياة وحقوق الإنسان الأساسية.
وعندما استخدمت القوات الإسرائيلية قنابل فوسفورية تركت آثارًا مدمرة على التربة والمحاصيل الزراعية، حيث إن حرارة انفجار هذه القنابل تؤدي إلى تدمير الغطاء النباتي، بينما يُعتبر الفوسفور الأبيض ملوثًا شديد الخطورة للهواء والمياه، حيث يتسبب في تلوث الهواء بالدخان الكثيف الذي يؤثر على الجهاز التنفسي للبشر والحيوانات، ويتسرب إلى المياه ويبقى سامًا لفترات طويلة، ما يهدد الحياة البحرية والكائنات التي يعتمد البشر عليها في الغذاء.
وهذا يقودنا إلى التحدي الكبير المتمثل في تهديد الأمن الغذائي، فقد تم تدمير 70% من أساطيل الصيد، بالإضافة إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمحاصيل الزراعية، ما يعمق الأزمة الغذائية في غزة ويزيد من تعقيد الوضع الإنساني، أمّا في لبنان، فقد أدى القصف المكثّف إلى تدمير آلاف الهكتارات الزراعية و65 ألف شجرة زيتون، فيما قدرت الخسائر في القطاع الزراعي بنحو 1.2 مليار دولار وفقاً لتقرير البنك الدولي.
وتُسهم الحروب في تفاقم أزمة المناخ من خلال انبعاثات الكربون التي تُخلّفها، والتي تمتد تأثيراتها على المدى الطويل، فعلى سبيل المثال، خلال أول 120 يومًا من الحرب على غزة، بلغت الانبعاثات الكربونية نحو 536,410 أطنان من ثاني أكسيد الكربون، حيث كان 90% منها ناتجًا عن القصف الجوي والاجتياح البري. ولتوضيح حجم هذه الكارثة، فإن هذا الرقم يفوق البصمة الكربونية السنوية لعدة دول تُعاني أصلاً من آثار التغير المناخي.
ولا يقتصر الدمار الناتج عن الحروب على الهواء والمياه، بل يمتد إلى تلوث التربة والغطاء النباتي بالمواد الكيميائية السامة. الجزيئات الدقيقة الناتجة عن تدمير المباني، مثل الأسبستوس (PM2.5 وPM10)، تلوث الهواء بشكل مباشر وتتسرب إلى التربة والمياه الجوفية، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض الكلى، ويضر بالنظم البيئية والبشر على حد سواء، ويزيد من الأعباء الصحية والبيئية، كما أن العمليات العسكرية تسهم في انبعاث كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة نتيجة لاستهلاك الوقود، ما يعمق أزمة تغير المناخ.
وتدمر الحروب البنية التحتية البيئية الأساسية مثل محطات معالجة المياه والصرف الصحي، ما يؤدي إلى تدهور الخدمات البيئية الأساسية، وفي سياق الحرب في غزة، يتدفق يوميًا نحو 60 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر الأبيض المتوسط، ما يشكل تهديدًا حقيقيًا للحياة البحرية، ويؤثر سلبًا على جودة مياه الشرب، كما تتسبب الحرائق والقصف في تدمير الغابات والغطاء النباتي، ما يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظم البيئية.
وتؤثر الحروب سلبيا على التنوّع البيولوجي، فعلى سبيل المثال، تسببت الحرب في مقتل الحيوانات البرية والماشية، وتدمير خلايا النحل، فضلاً عن تقليص الإنتاج الزراعي والبحري، ما يزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف معاناة المجتمعات المحلية.
تُبرز هذه التداعيات المدمرة الحاجة الماسة إلى دمج الاعتبارات البيئية في تقييم آثار الحروب وفي السياسات المعنية بمواجهة الحروب والتعافي بعدها، والتركيز على إعادة التأهيل البيئي كجزء أساسي من تحقيق العدالة والاستدامة.. الحروب ليست مجرد أزمات إنسانية، بل هي كوارث بيئية تهدد مستقبل كوكبنا.
ولكل ما سبق، يجب أن يتوقف القصف المستمر على لبنان من قبل إسرائيل، وكذلك التدمير والقتل في غزّة والضفة الغربية فوراً، ونحن نطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفرض حظر عالمي على جميع عمليات بيع ونقل الأسلحة والدعم العسكري، وإنهاء الاحتلال غير الشرعي لفلسطين.
هل عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستكون لها تأثيرات سلبية على جهود حماية البيئة؟
لا شك أن وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مدعومًا من حلفائه في صناعة الوقود الأحفوري، يشكّل تحديًا كبيرًا أمام الحركة البيئية والمناخية العالمية، ولكن هذا لا يعني نهاية الطريق، فلا يمكن لأي حدث أو شخص أن يوقف الزخم المتزايد نحو حماية البيئة، فالتغيير قادم لا محالة، واتفاق باريس، الذي جمع شعوب العالم حول هدف مشترك وهو ضمان مناخ آمن ومستقر، يظل حجر الزاوية في الجهود العالمية.
ومع تزايد الوعي والمطالب بمناخ نظيف وآمن، باتت أيام شركات النفط والغاز الكبرى معدودة، فاتفاق باريس ليس قابلاً للتفاوض، ونحن مستمرون في المضي قدمًا نحو المستقبل الذي نطمح إليه.