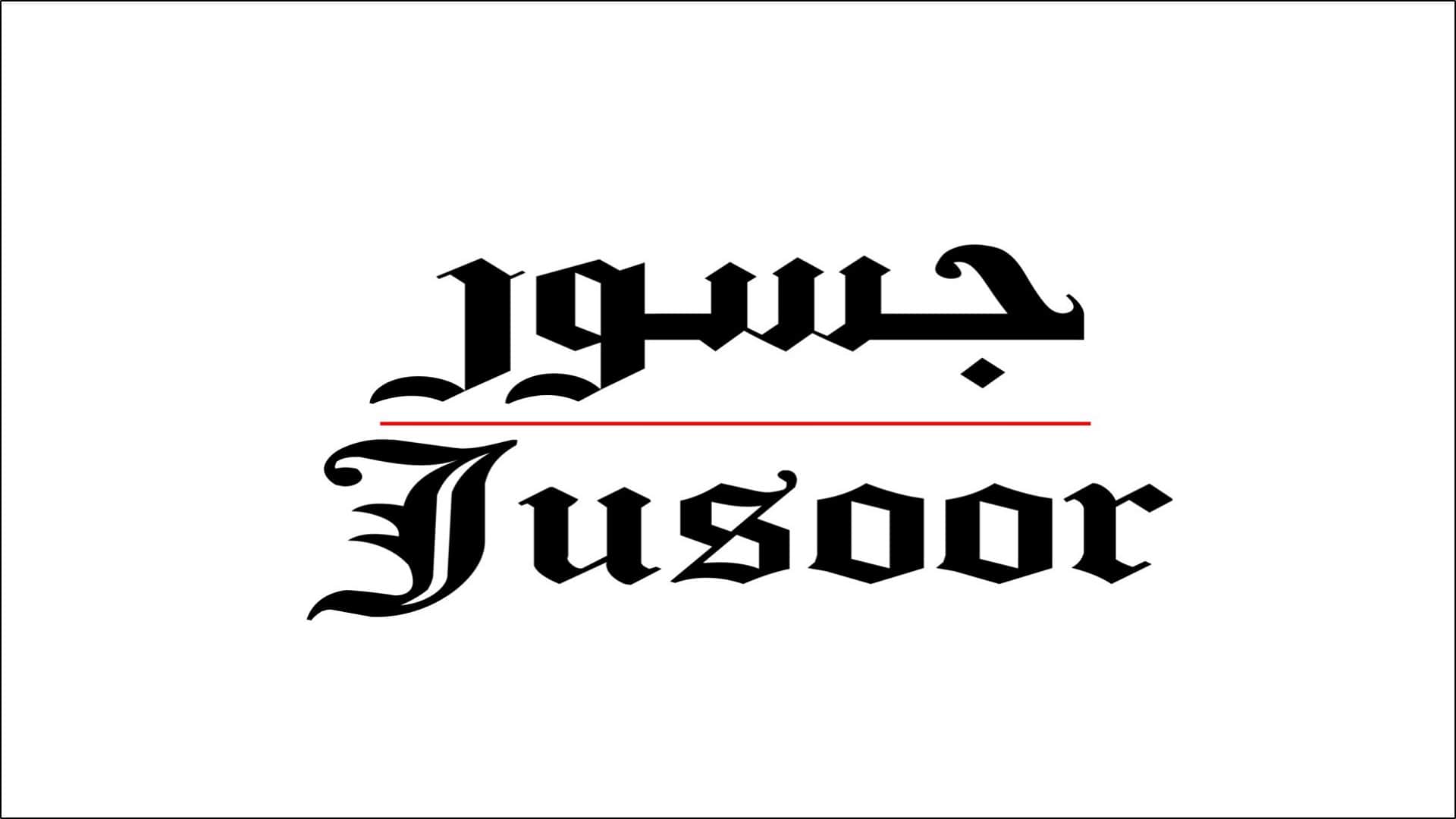إذا فات الجزائر أن تلم شتات المنقسمين
إذا فات الجزائر أن تلم شتات المنقسمين
وصلت الجزائر بالقمة العربية الحادية والثلاثين إلى غايتها، رغم المصاعب التي كانت تتناثر على طول الطريق، ورغم أن أطرافاً إقليمية في المنطقة كان يسعدها ألا تنعقد القمة في موعدها، وكان يسعدها ألا يلتئم لها انعقاد في الموعد المحدد لها ولا في المكان.
وقد كانت إيران في المقدمة من هذه الأطراف، التي لا يزال يزعجها أن تكون جامعة الدول العربية موجودة ككيان، علاوة على أن يكون لهذا الكيان دور، ومع الدور مهمة لا بديل عن أن ينهض بها بيت العرب في مقره الذي يطل على ميدان التحرير.
ولكن حرب الاستقلال الطويلة التي خاضها الأشقاء في الجزائر، قد علمتهم طول النَفَس فيما بدا أمامنا من خطوات في طريق عقد القمة، وعلمتهم أن اليأس من بلوغ الغاية، يجب ألا يكون له موطئ قدم على طول المسيرة مهما امتدت وطالت. ولهذا، فعندما تأجلت القمة من صيف السنة إلى خريفها، تمسكت القيادة الجزائرية بالموعد وبالمكان، ورأت أن الانعقاد لا بد أن يتم، حتى ولو كانت مفاجآت الطريق إلى القمة متعددة، ومتوالدة، ومتوالية.
وكان السلاح الذي واجهت به المصاعب هو سلاح «طول النَفَس» أكثر من أي سلاح آخر، ولو شئنا ترجمة عملية لهذا السلاح، فسوف تكون الترجمة من كلمة واحدة هي: العزيمة.
وحين تناثرت أنباء عن تأجيل القمة قبل أسابيع من انعقادها، فإن الحكومة في الجزائر غضبت، وكانت على حق في أن تسخط وتغضب، ولكنها لم تسمح لغضبها بأن يؤثر على عزيمتها أو ينال منها، فمضت في سبيلها تريد أن تصل إلى خاتمته، وكانت لديها من الحكمة ما جعلها تعرف كيف تتعامل مع عوائقه.
ولأن الجزائر كانت ترى حقائق الواقع الذي تلتئم فيه القمة، فإنها رأت أن أفضل شعار يمكن أن ترفعه تعبيراً عن واقع الحال هو: لمّ الشمل.
وكان اللقاء الذي جرى في ضيافة حكومة بلد المليون شهيد، بين قادة الفصائل الفلسطينية التي طال خلافها واختلافها، مما يمكن أن يكون نوعاً من المصافحة مع الشعار قبل أن يأتي أوان القمة. فقادة الفصائل التقوا على طاولة الطريق إلى القمة، واتفقوا على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، خلال سنة من تاريخ توقيع الاتفاق الذي عُرف بأنه: إعلان الجزائر.
وكان لقاء الفصائل مع ما بينها من خلاف واختلاف، علامة على أن ما عدا قضية فلسطين يمكن أن يكون له محل على طاولة القمة، إذا فاته أن يكون له مكان على الطريق الموصلة إليها.
وكانت ليبيا المجاورة للجزائر هي المرشحة، أكثر من غيرها، لأن تجد لها موقعاً على قائمة بنود لقاءات قاعة القمة، سواء كانت لقاءات على مستوى المندوبين في الجامعة، أو كانت على مستوى وزراء الخارجية، أو كانت على مستوى القادة العرب الذين جاءوا وحضروا.
ذلك أن الفلسطينيين إذا كانوا منقسمين بين القطاع وبين الضفة، فالوضع نفسه قائم في بلد عمر المختار بين حكومة في الشرق على الحدود مع مصر، وحكومة في الغرب على الحدود مع الجزائر، وما بين الفريقين سواء في فلسطين أو في ليبيا تتفرق دماء الوطن بين القبائل.
ومن الوارد أن تتعثر الفصائل في الذهاب إلى الانتخابات لا قدر الله، وإذا حدث هذا فلن يكون الذنب ذنب الجزائر التي سيكون لسان حالها عندئذ، هو شطر بيت الشعر الذي نحفظه لشاعر النيل حافظ إبراهيم، الذي فيه كان يقول: صح مني العزم والدهر أبى.
والفصائل التي جلست، واتفقت، ووقّعت، سوف تظل مدعوة إلى ألا تُخيب آمالاً كبرى مُعلقة على الاتفاق. والآمال هنا هي آمال الفلسطينيين أنفسهم، باعتبارهم أصحاب القضية، قبل أن تكون آمال العرب، أو حتى آمال الجزائريين الذين دعوا، ورعوا، ومن قبل كانوا قد راهنوا على أن يكون شعار القمة عنواناً لفعل، لا مجالاً لمزيد من الأحاديث والكلام.
وقد أدركت الجزائر منذ وقت مبكر أن الانطباع المستقر لدى الرأي العام العربي عن القمم العربية، أنها قمم حديث حلو يقال، أكثر منها ميداناً لأفعال يراها الناس بأعينهم، ويلمسونها بأياديهم، ويجدون فيها ما يغير من ملامح واقع يُعاش.
أدركت هذا كما يدركه غيرها، فأرادت من وراء إعلان الجزائر أن يكون دليلاً على أن القمم ليست كلها سواء، وأن منها ما يمكن أن يختلف فيقدم ما يستطيعه وما يقدر عليه، وكانت دعوة الفصائل إلى توقيع «الإعلان» من قبيل الأدلة التي لا تخطئها عين.
ويبدو أن الإعلان الذي وقّعته الفصائل قد فتح الشهية لدى بقية القضايا والملفات، فتزاحمت على جدول أعمال وزراء الخارجية حتى بلغت 19 بنداً على قائمة البنود. وكان هذا مما جعل الآمال المعلقة عريضة، ومما جعل الذين تابعوا اللقاءات يتفاءلون.
ورغم اختلاف وزراء الخارجية، ومن قبلهم مندوبو الدول الدائمون في الجامعة، على أولوية بعض الملفات المطروحة على جدول الأعمال، ثم على الأهمية النسبية لها، فإن الاختلاف لم يصل إلى ما يخص إيران، وبالذات سلوكها الإقليمي الذي صار ينتقل في المنطقة من ركن هنا إلى ركن هناك، كما تنتقل العدوى من المرضى فتصيب الأصحاء من الناس.
وإلى وقت قريب كانت إيران لا تختلف عن تركيا في سلوكهما الإقليمي، ولكن أنقرة أفاقت قليلاً ولم تعد تجد جدوى فيما ظلت تمارسه في جوارها العربي، ولم يجد الرئيس رجب طيب إردوغان مفراً من العمل على تصفير مشاكله على خريطة المنطقة، ولكنها لا تزال استفاقة غير مكتملة، لأن يد تركيا العابثة في ليبيا، وفي العراق، وفي سوريا، لا تزال في حاجة إلى أن تتوقف عما تمارسه.
ولأن القمة قمة لمّ شمل، ولأن هذا هو شعارها المعلن، ولأن هذا هو أملها من وراء الانعقاد، فإنها لم تملك إلا أن تضع أنقرة مع طهران في خانة واحدة بين الخانات.
ولكن هذا كله لا يعني أن القمة سوف تأتي للعرب بالمن والسلوى، من اليوم إلى أن تنعقد القمة المقبلة، لأن شيئاً من ذلك ليس واقعياً في حقيقة الأمر، ولم يكن واقعياً في أي قمة سابقة، إضافة إلى أنه لم يحدث أن انعقدت قمة من قبل في مثل هذه الظروف العربية والإقليمية والدولية معاً.
إن كل قمة هي بنت ظروفها التي نبتت فيها، وليس من الجائز أن نقارن مثلاً بين قمة 1990، التي احتشدت في مواجهة غزو العراق للكويت، بينما العالم وقتها منتبه ومهتم، وبين قمة 2022 التي تنعقد بينما العالم يعاني تداعيات «كورونا» وحرب أوكرانيا، ولا يبدو منتبهاً ولا مهتماً بالدرجة التي انتبه بها واهتم يوم غزا العراق الكويت.
وإذا كانت قمة الجزائر قد جددت الوعي لدى المواطن العربي بما يدور حوله، وبما يراد لبلاده، وبما يحيط بها من مخاطر، فربما يكفيها جهدها في تجديد الوعي بالمخاطر، إذا فاتها أن تلم شمل أشتات المنقسمين.
نقلا عن “الشرق الأوسط”
كاتب المقال: سليمان جودة