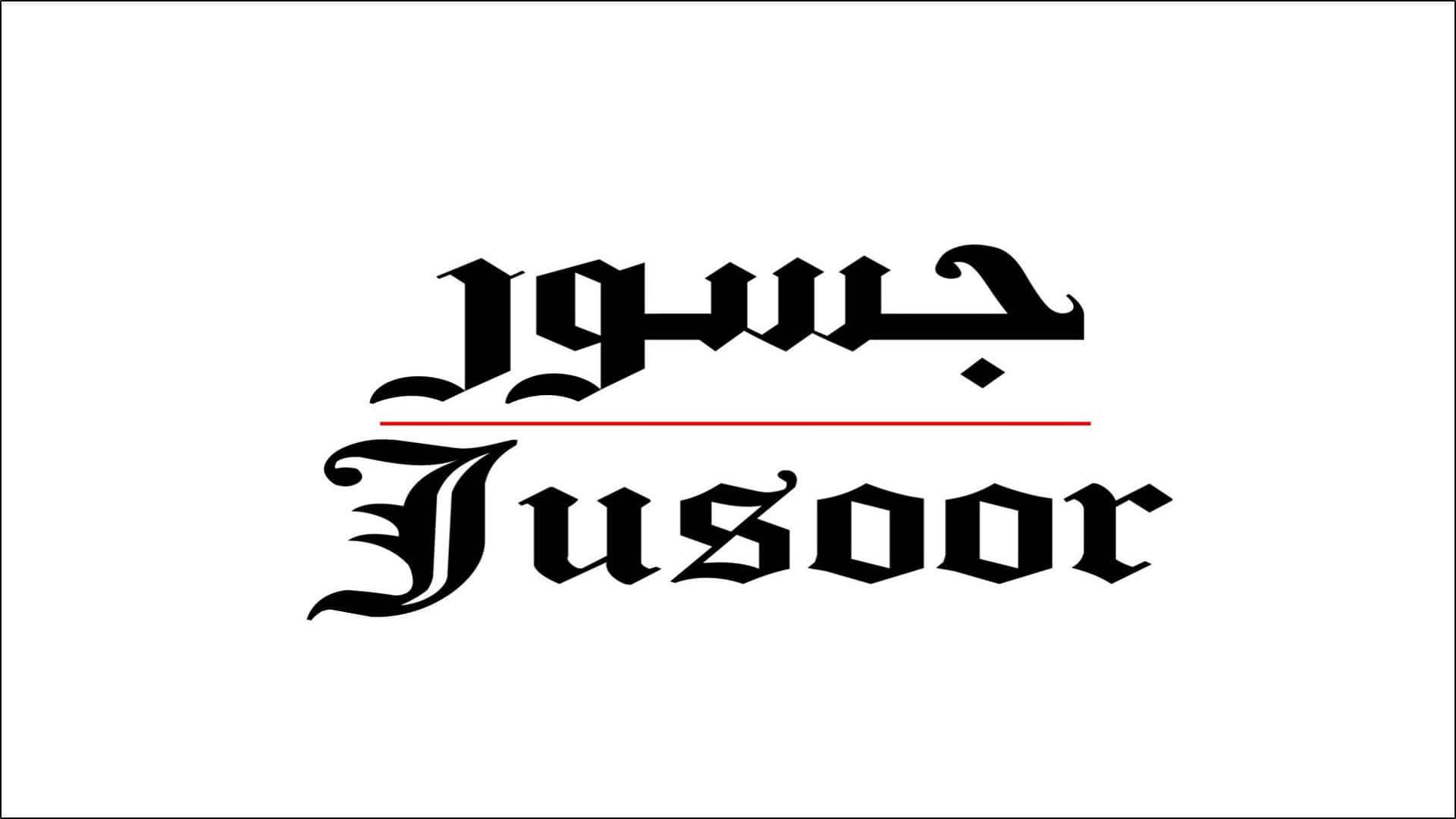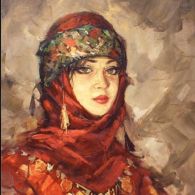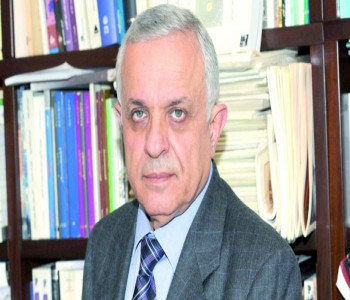«مشروع قانون شؤون المرأة» الأردني.. تمكينٌ تشريعي أم تهديدٌ للنسيج الأسري؟
«مشروع قانون شؤون المرأة» الأردني.. تمكينٌ تشريعي أم تهديدٌ للنسيج الأسري؟
وسط جدل مجتمعي واسع وانقسام حاد بين مؤيد ومعارض، يبرز مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، كأحد أكثر التشريعات إثارة للجدل في الأردن خلال الفترة الأخيرة.
ويهدف القانون -بحسب مؤيديه- إلى منح اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إطارًا قانونيًا يضمن استدامتها واستقلالها الإداري والمالي، ما يعزز قدرتها على تنفيذ سياسات تمكين المرأة ومكافحة العنف والتمييز ضدها، إلا أن الأصوات المعارضة ترى في هذا المشروع خطرًا على النسيج الاجتماعي، معتبرين أنه يفصل المرأة عن أسرتها ويهدد القيم المجتمعية السائدة.
تعود جذور هذا الجدل إلى المخاوف المتراكمة لدى قطاعات واسعة من المجتمع حول التشريعات التي تتناول قضايا المرأة، إذ تُتهم بعض القوانين بأنها تحمل في طياتها رؤية غربية لا تتناسب مع خصوصية المجتمع الأردني، ووفقًا لإحصائيات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية لعام 2023، فإن نسبة النساء اللاتي يتعرضن للعنف الأسري في الأردن تبلغ 21%، وهو رقم يُظهر الحاجة الملحة إلى أطر قانونية تحمي حقوق المرأة، إلا أن المعارضة لا تنكر ضرورة حماية المرأة من العنف، لكنها ترى أن التشريعات يجب أن تكون متوازنة وتحافظ على دور الأسرة كوحدة أساسية في المجتمع.
وتعد اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، التي تأسست في عام 1992، تُعد الجهة الرسمية المعنية بقضايا المرأة في المملكة، وهي تتمتع بصلاحيات تنسيقية واستشارية، إلا أن مشروع القانون الجديد يمنحها شخصية اعتبارية واستقلالًا ماليًا وإداريًا، وهو ما يراه المؤيدون خطوة ضرورية لضمان استمرارية عملها بكفاءة.
وفي هذا السياق، أوضحت مها العلي، الأمين العام للجنة، أن اللجنة تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدة أن هناك حاجة فعلية لإطار قانوني ينظم عملها ويمنحها صلاحيات واضحة.
لكن هذا الطرح لم يكن كافيًا لإقناع التيارات المعارضة، التي ترى أن منح اللجنة صلاحيات أوسع قد يؤدي إلى تدخلها في قضايا حساسة تتعلق بالأسرة والأحوال الشخصية، وهو ما قد يُحدث تغييرات غير مرغوبة في بنية المجتمع، وأشار النائب ناصر النواصرة، أحد أبرز معارضي المشروع، إلى أن القانون يفتح الباب أمام تبني تشريعات مستوحاة من اتفاقيات دولية قد لا تتماشى مع الهوية الثقافية والدينية للمجتمع الأردني.
ويستشهد المعارضون بتجارب سابقة في دول أخرى حيث أدى تبني سياسات مشابهة إلى تغييرات جذرية في القوانين المتعلقة بالأسرة والزواج، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الطلاق والتفكك الأسري.
القانون لا يتعارض مع الدستور
ويرى المؤيدون، ومن بينهم رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى العماوي، أن مشروع القانون لا يتعارض مع أحكام الدستور الأردني، بل إنه يأتي في إطار الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة للمساهمة في الحياة العامة بشكل أكثر فاعلية.
ويستندون في دعمهم للقانون إلى أرقام رسمية تشير إلى أن نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة في الأردن لا تتجاوز 14%، وهي من أدنى النسب في العالم، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، ويعتبرون أن منح اللجنة استقلالية أكبر سيمكنها من تطوير برامج تدريب وتأهيل تساعد النساء على دخول سوق العمل والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للأسر الأردنية.
ولم يقتصر الانقسام حول مشروع القانون على الأوساط السياسية فحسب، بل امتد إلى الشارع الأردني ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الأسابيع الأخيرة حملات متباينة بين من يرى في المشروع خطوة تقدمية نحو تعزيز حقوق المرأة، ومن يحذر من تداعياته السلبية على المجتمع، ووفقًا لاستطلاع أجرته مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، فإن 52% من الأردنيين يعارضون مشروع القانون، بينما يؤيده 35%، في حين لم يحسم 13% موقفهم بعد.
المخاوف من تفكيك الأسرة ليست مجرد هواجس لدى المعارضين، بل تستند إلى قراءة لتجارب مشابهة في المنطقة والعالم، حيث أدى تعزيز القوانين الداعمة للمرأة في بعض الدول إلى تغييرات في القيم التقليدية، مما دفع ببعض المجتمعات إلى إعادة النظر في التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويرى البعض أن الأولوية ينبغي أن تكون لدعم الأسرة كوحدة متماسكة، وليس للفصل بين أفرادها من خلال منح استقلالية مفرطة لأي من مكوناتها.
ويشدد المؤيدون على أن الحقوق لا ينبغي أن تكون محل جدل، وأن تمكين المرأة وحمايتها من العنف الأسري لا يتعارض مع الحفاظ على وحدة الأسرة، بل يعززها، ويشيرون إلى تجارب دول عربية أخرى، مثل تونس والمغرب، التي نجحت في تحقيق توازن بين تمكين المرأة وحماية الأسرة من التفكك عبر تشريعات مدروسة.
ومع احتدام الجدل، يبدو أن النقاش حول مشروع القانون لن يُحسم بسهولة، خاصة في ظل عدم وجود توافق مجتمعي واسع حوله، وبينما تستمر المداولات في مجلس النواب، يبقى السؤال الأبرز: هل يستطيع مشروع القانون تحقيق التوازن بين تمكين المرأة والحفاظ على القيم الأسرية، أم أنه سيؤدي إلى تغيير جذري في البنية الاجتماعية للأردن؟
مخاوف من تفكيك الأسر
قالت خبيرة حقوق الإنسان التونسية، مريم حمودة، إن مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة يثير جدلاً حادًا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، إذ يتقاطع مع مجموعة من المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لا سيما تلك المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز، وفي الوقت ذاته، يطرح إشكاليات تتعلق بالتوازن بين الحقوق الفردية والمفاهيم الاجتماعية التقليدية، ويستند المشروع إلى التزامات الأردن الدولية، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، التي صادق عليها الأردن مع تحفظات، ومع ذلك فإن الجدل يكمن في مدى توافق المشروع مع الإطار الدستوري الوطني الذي يؤكد على حماية الأسرة باعتبارها نواة المجتمع.
وتابعت حمودة، في تصريحات لـ"جسور بوست": من منظور حقوق الإنسان، فإن تأسيس لجنة وطنية معترف بها قانونيًا يعكس التزام الدولة بتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة وحمايتها من العنف والتمييز، وهو أمر يتوافق مع المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن "جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق"، كما أن المادة الثانية من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تلزم الدول الأعضاء باتخاذ تدابير تشريعية لضمان حماية الأفراد من التمييز على أساس الجنس بالتالي، فإن وجود لجنة مستقلة بشخصية اعتبارية وإدارة مالية مستقلة يمكن أن يسهم في تحقيق إصلاحات جوهرية على صعيد السياسات العامة المتعلقة بحقوق المرأة.
وقالت إن الانتقادات الموجهة لمشروع القانون تنبع من مخاوف تتعلق بإمكانية خروجه عن الدور الاستشاري إلى ممارسة سلطات تنفيذية قد تؤثر على النسيج الاجتماعي القائم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مبدأ التناسب بين الحاجة إلى تمكين المرأة وحماية الأسرة كوحدة اجتماعية.
وأشارت إلى أن إحدى الإشكاليات المطروحة تتعلق بمفهوم الاستقلالية القانونية والإدارية للجنة، إذ إن وجود هيئة مستقلة بهذا الشكل قد يثير تساؤلات حول مدى تعارضها مع صلاحيات الجهات الحكومية الأخرى المعنية بشؤون المرأة والأسرة، مثل وزارة التنمية الاجتماعية، فبينما تؤكد المعايير الحقوقية على أهمية وجود هيئات مستقلة لرصد حقوق الإنسان، فإن التجارب الدولية تشير إلى أن استقلالية هذه المؤسسات يجب أن تكون مقيدة بضوابط واضحة تمنع التضارب في الصلاحيات أو ازدواجية العمل المؤسساتي.
وقالت إن النقطة الأخرى التي تثير الجدل تتعلق بمدى قدرة اللجنة على العمل دون تضارب مع الأحكام الدينية والثقافية السائدة، حيث إن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكفل حرية الفكر والوجدان والدين، ما يعني أن أي تشريع يجب أن يراعي الخصوصية الثقافية والدينية للدولة، ومن هنا فإن التساؤلات المطروحة ليست حول ضرورة وجود اللجنة، بل حول آليات عملها وضمانات عدم تجاوزها للأطر الدستورية والثقافية.
وأتمت: أي تقييم حقوقي لمشروع القانون يجب أن يكون متوازنًا بين ضرورة حماية وتعزيز حقوق المرأة وفقًا للمعايير الدولية، وضمان عدم المساس بالبنية الاجتماعية التي تشكل جزءًا أساسيًا من الهوية الوطنية، فالإصلاحات التشريعية في مجال حقوق المرأة لا ينبغي أن تتخذ منحى تصادميًا مع المجتمع، بل يجب أن تعتمد على نهج تشاركي يضمن توافق جميع الفئات، بما في ذلك المؤسسات الرسمية والجهات الحقوقية والمجتمع المدني، للوصول إلى تشريعات تعزز المساواة دون الإضرار بالتماسك الاجتماعي.
تمكين أم تهديد للنسيج الاجتماعي؟
وقالت الناشطة الاجتماعية الأردنية، هبة أسعد، إن مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة يضعنا أمام مفترق طرق حاسم، حيث تتجاذبنا رؤى متباينة بين من يراه خطوة نحو تعزيز مكانة المرأة الأردنية وضمان حقوقها، ومن يخشى أن يكون مقدمة لتفكيك الأسرة والإضرار بالنسيج الاجتماعي، وكوني مواطنة أردنية، أتابع هذه القضية بقلق، وأشعر أن الجدل الدائر حوله ليس مجرد اختلاف في وجهات النظر، بل هو تعبير عن أزمة ثقة، خاصة في ظل غياب حملات توعوية قادرة على شرح أهداف القانون وفوائده أو تبديد المخاوف المشروعة التي يثيرها، فالنساء في الأردن عانين طويلًا من تحديات عديدة، سواء كانت قانونية أو اجتماعية.
وتابعت هبة أسعد، في تصريحات لـ"جسور بوست": لا شك أن هناك حاجة حقيقية إلى أطر تشريعية تحميهن من العنف والتمييز وتعزز مشاركتهن الاقتصادية والسياسية، ومع ذلك، فإن القوانين التي تخص الأسرة يجب أن تكون مدروسة بعناية، بحيث توازن بين التمكين المطلوب والحفاظ على استقرار المجتمع، وهناك كثيرون يرون أن القانون يعزز فكرة استقلالية المرأة قانونيًا وإداريًا، لكنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى تفكيك الرابط الأسري القائم على التكامل وليس الانفصال، والمشكلة أن هذه المخاوف لا تأتي فقط من أفراد تقليديين أو محافظين، بل حتى من بعض النساء أنفسهن اللائي يشعرن أن التمكين الحقيقي لا يمكن أن يكون بمعزل عن الأسرة، بل من داخلها وبالتنسيق معها.
واسترسلت: الإعلام الأردني لعب دورًا متفاوتًا في تناول هذه القضية؛ بعض وسائل الإعلام ركزت على الجانب الإيجابي للقانون باعتباره خطوة تقدمية لحماية المرأة وتعزيز حقوقها وفقًا للاتفاقيات الدولية، وفي المقابل، هناك أصوات إعلامية أخرى ركزت على المخاطر المحتملة متحدثة عن تأثيرات اجتماعية سلبية قد تنجم عن تشريعات قد تبدو في ظاهرها داعمة للمرأة، لكنها تحمل في طياتها تغييرات جذرية في مفهوم الأسرة ودور المرأة داخلها، وبين هذين الطرحين يبقى المواطن في حيرة.
وقالت إن المشكلة ليست فقط في محتوى القانون، بل في آلية إقراره والطريقة التي يُطرح بها للنقاش العام، فالمواطن الأردني تعوّد أن يكون آخر من يعلم في ما يخص القوانين التي تؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية، وغالبًا ما يجد نفسه أمام أمر واقع دون أن يكون جزءًا من النقاش أو أن تؤخذ مخاوفه بعين الاعتبار، هذا الشعور بالتجاهل يولّد بطبيعة الحال ردود فعل متشنجة ترفض القانون من منطلق عدم الثقة، وليس بالضرورة بناءً على قراءة دقيقة لبنوده.
وأوضحت: أريد أن أرى قوانين تحمي المرأة من العنف والتمييز، لكنني في الوقت ذاته أرفض أي تشريع قد يسهم في خلق فجوة بين المرأة وأسرتها، فالتمكين الحقيقي لا يعني فقط منح المرأة حقوقًا قانونية مجردة، بل يجب أن يكون جزءًا من مشروع وطني شامل يعزز الترابط الأسري ويحمي القيم المجتمعية، لا أن يضعها على المحك باسم التطور والتحديث.
وأتمت: إذا كان الهدف من القانون هو تحسين وضع المرأة الأردنية، فليكن ذلك من خلال مقاربة تشاركية تحترم الخصوصية المجتمعية وتراعي مخاوف المواطنين بدلاً من فرض رؤية قد تزيد من الانقسام بدلاً من أن تعالجه.