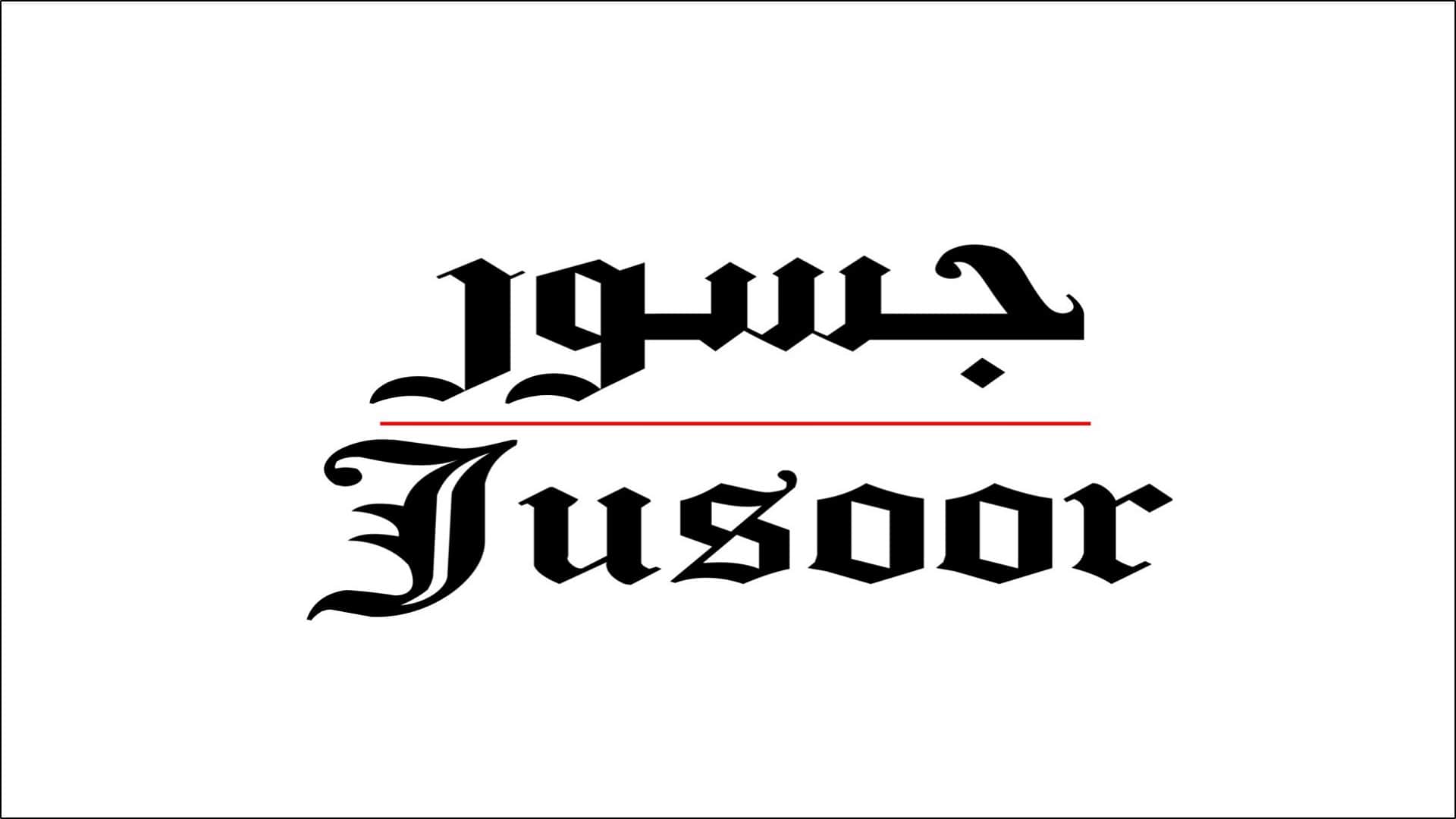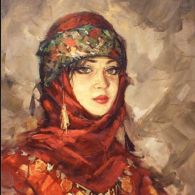الحضارات الإنسانية.. مرتكزات الوفاق ومنحنيات الافتراق
الحضارات الإنسانية.. مرتكزات الوفاق ومنحنيات الافتراق
ضمن أهم الإشكاليات الحديثة التي واجهت -ولا تزال- الإنسانية منذ بدايات العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يأتي الحديث عن قضية الحضارات الإنسانية، وهل هي حضارة واحدة، أم حضارات متباينة، بل لقد ذهب البعض في طريق أبعد من ذلك عندما تحدثوا عن حتمية المواجهة والصراع بين الحضارات، لا إمكانيات التلاقي بين الإنسانية عبر موجات التفاعلات البشرية التي عرفت باسم الحضارات.
ولعله من سوء الطالع أن سكان الأرض المعاصرين قد قدر لهم أن يعيشوا أحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول 2001، تلك التي أذكت "وهم" صدام الحضارات، لا سيما بين طرفين أساسيين حول الكرة الأرضية، العالم الغربي، والعالم العربي، وجوازي العالم المسيحي اليهودي، في مواجهة الإسلامي الكونفوشيوس، بحسب توصيف وتصنيف "صموئيل هنتنجتون".
وقد كان هذا الانطباع خاطئا، فأسامة بن لادن لم يكن ليمثل العالم العربي ولا الإسلامي، وبطريقة مماثلة لم يمثل جورج بوش الاتجاه الغربي السائد، وكان الأمر في حقيقته ليس أكثر من مجموعتين محددتين جداً من العوامل هما اللتان تتصادمان، وليس هو صدام الحضارات التي ننتمي إليها.
لكن حصر الوعاء الإنساني الحضاري في طرفي نقيض كما فعل هنتنجتون، أمر لا يستقيم فهناك عشرات الحضارات التي سادت ثم بادت، ومنها ما هو كائن في الحال، وعرضة للاضمحلال في الاستقبال، وبينها كذلك ما هو خارج دائرة تنويعات هنتنجتون القريبة من العنصرية.
هل تمضي البشرية في طريق البحث عن عولمة يتبادل فيها الجميع الخدمات لتسهيل حياة إنسان القرن الحادي والعشرين بغض النظر عن الهويات والانتماءات المكونة للحضارات المتباينة أم تعود البشرية إلى الوراء لتتقوقع على ذاتها ولترتد إلى ضيق التفكير القبلي والمجتمعات البطريركية المنغلقة؟
يدهش المرء في واقع الحال عندما تخرج أصوات مفكرين وباحثين غربيين بآراء تتنافى وتجافي فكرة العصرانية، ومرة ثانية نجد هنتنجتوون في المقدمة منهم، فضمن الدراسات التي لم يسلط الضوء كثيراً عليها، تلك التي كتبها في عدد شهري (نوفمبر– ديسمبر 1996) من مجلة شؤون خارجية، تحت عنوان مثير للغرابة بالفعل "الغرب: منفرد وليس عالميا، يفرق فيها بين التحديث Modernization وبين التغريب Westernization".
ويقول: "إن شعوب العالم غير الغربية، لا يمكن لها أن تدخل في النسيج الحضاري للغرب، حتى وإن استهلكت البضائع الغربية، وشاهدت الأفلام الأمريكية، واستمعت إلى الموسيقى الغربية، فروح أي حضارة هي اللغة والدين والقيم والعادات والتقاليد، وحضارة العرب تتميز بكونها وريثة الحضارات اليونانية والرومانية والمسيحية الغربية، والأصول اللاتينية للغات شعوبها، والفصل بين الدين والدولة، وسيادة القانون، والتعددية في ظل المجتمع المدني، والهياكل النيابية، والحرية الفردية".
ويضيف قائلا: "إن التحديث والنمو الاقتصادي لا يمكن أن يحققا التغريب الثقافي في المجتمعات غير الغربية، بل على العكس، يؤديان إلى مزيد من التمسك بالثقافات الأصلية لتلك الشعوب ولذلك فإن الوقت قد حان لكي يتخلى الغرب عن وهم العولمة، وأن ينمي قوة حضارته وانسجامها وحيويتها في مواجهة حضارات العالم. وهذا الأمر يتطلب وحدة الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ورسم حدود العالم الغربي في إطار التجانس الثقافي".
تستدعي كلمات هنتنجتون تلك عن العولمة تساؤلات عدة، فهل العولمة هي صيغة جديدة من صيغ المواجهة الحضارية التي يخوضها الغرب، بالمفهوم العام للغرب، ضد هويات الشعوب وثقافات الأمم، ومن أجل فرض هيمنة ثقافية واحدة، وإخضاع العالم لسيطرة حضارة واحدة؟
ربما حان الوقت الذي تتوحد فيه الإنسانية من أجل بناء مفهوم إنساني شامل، مفهوم ينتج لكل فرد الشعور بمكونات وعوامل انتمائية لكن أيضا بقوميته ولغته ومعتقداته دون أن يكون مجبراً على الاختيار.
في هذا السياق علينا أن نميز بين مكونات القيم الأساسية للمجتمعات التي يجب أن تكون مشتركة وإن ظهرت مختلفة، فالعالم القابل للتقدم هو العالم الذي يستطيع كل فرد فيه أن يعبر عن آرائه باللغة التي يختارها والمعتقد الذي ينتمي إليه ولا يشعر بأي نقص في انتمائه لهذه الفئة أو تلك، وعلى السلطات والشعوب ألا تجعل ذلك مقياسا للتميز فعندما لا يستطيع المرء أن يعبر بلغته عما يشعر به وعن معتقداته، وعن التعاون مع الآخر المختلف حضاريا عنه فذلك يعني أن العالم يسير إلى الوراء.
هل من مقياس حضاري أولى يدلنا على اتجاه سير البشرية، بمعنى هل هي ماضية قدماً في طريق الأسرة الكونية الكوسمولوجية الواحدة أم في طريق الهوية القبلية؟
يرى الكاتب الفرنسي الجنسية اللبناني الأصل "أمين معلوف" في محاولة للجواب على السؤال المتقدم أن مقياس الحضارات اليوم هو قبل كل شيء تقبل الآخر خاصة الذين يستقبلون مهاجرين ينتمون إلى حضارات أخرى، إذ يجب ألا يكون هذا الانتماء موضع مجابهة، وفي هذه المعركة تتحدد القيم الحضارية، فإن استطاع الغرب خاصة كسب هذه المعركة والانسجام بشكل حقيقي مع القيم التي يطالب بها، وهي قيم حضارية، عندئذ سيكون بمقدوره التغلب على جميع المشكلات التي تعترضه مع المهاجرين.
هل الدور الحضاري الإنساني الواحد في أيامنا هذه بات فرض عين على سكان البسيطة كلها؟
هذا السؤال نطرحه من جانبنا، ومبلغ الرأي هو أن الإنسانية اليوم، وهي في منتصف العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين تواجه أخطاراً جديدة لا مثيل لها في التاريخ، وتحتاج إلى حلولا شاملة مبتكرة، وإذا لم تتوافر هذه الحلول في مستقبل قريب، فلن يكون بالإمكان الحفاظ على شيء من كل ما صنع عظمة حضارتنا الإنسانية المشتركة وجمالها.
لا يملك المرء سوى الرجاء في أن يكون الغد أفضل وأرحب، وأن يخرج البشر من ضيق الأيديولوجيات إلى رحابة الأبستمولوجيا، وساعتها فقط ستعزز الحضارات من دورها الواجب الوجود من أجل خدمة "الإنسان الأعلى" المنشود، النموذج الذي سعى إليه نيتشه وتطلع إليه توماس كارليل على حد سواء.