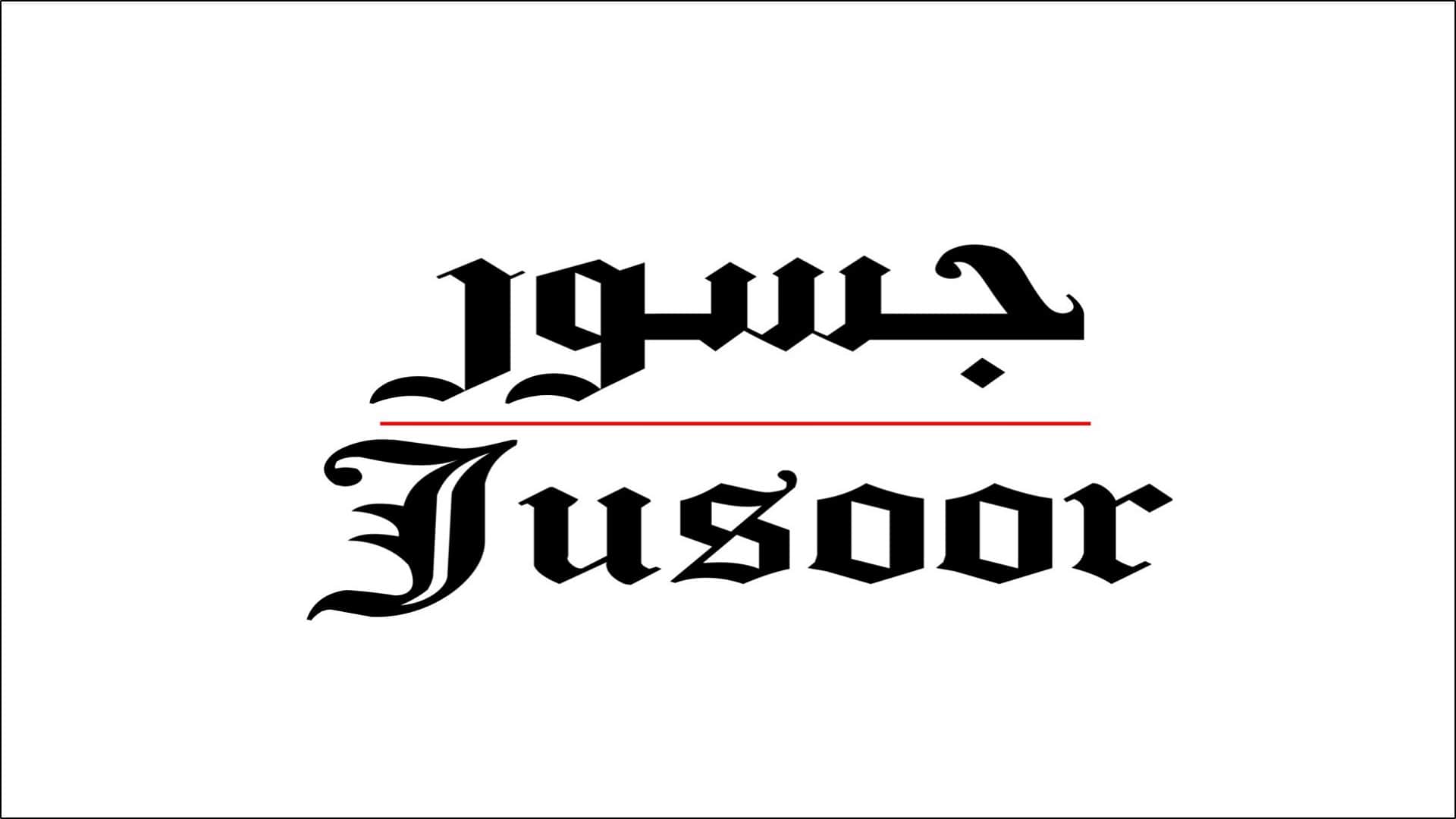تونس تحت خط العطش.. أزمة المياه تعيد تعريف المواطنة والحق في الحياة
تونس تحت خط العطش.. أزمة المياه تعيد تعريف المواطنة والحق في الحياة
لم تكن ريم بن خليفة، ابنة تونس، تتخيّل أن يصبح صوت الصنبور اليابس جزءاً من يومها، وأن يتحول الفراغ الذي ينساب منه الهواء فقط إلى لحظة صادمة تُعيد فيها حساباتها كل صباح.. في بيتها بحيّ شعبي في تونس، تختلط رائحة البلاستيك الفارغ بالقلق، وتتحوّل الأواني الخاوية إلى شهود صامتين على معركة يومية اسمها "البحث عن الماء".
في حديثها لـ"جسور بوست"، قالت: “انقطعت المياه ثلاثة أسابيع.. تخيل؟" كان السؤال معلّقاً في الهواء، أقرب إلى عتب منه إلى استفسار تحاول أن تُخفي انفعالها، لكنها تفشل؛ فالتعب يتسلل من صوتها وكأنها تحمل العالم على كتفيها لا دلواً صغيراً.
في ذلك اليوم، سمعت في الحي أن شاحنة صهريج ستصل قرب المسجد، تجمّعت النساء قبيل الظهيرة، بعضهنّ حملن أوعية متهالكة، أخريات حملن بيد وأمسكن بأطفالهن باليد الأخرى كانت الشمس فوق رؤوسهنّ.
عندما وصل الصهريج، اندفع الناس نحوه مثل أسراب طيور عطشى، لا تنتظر دوراً بقدر ما تبحث عن نجاة.. رجال ونساء، كبار وصغار، أيدٍ ممدودة، دلاء متدافعة، وجوه تلتقط ما تبقى من ماء على أمل ألا يعودوا خائبين.
وقفت ريم في الصف، تحمل دلواها وتخشى أن ينفد الماء قبل أن تصل إليه.. أحسّت للحظة أنها تتحول من مواطنة إلى متسوّلة حقها، هذا الحق الذي لا يحتاج تبريراً ولا توسّلاً، رفعت رأسها قليلاً، رأت امرأة مسنة تترنّح، يبدو أن الحرّ والغبار ومشقة الانتظار قضمت من قدرتها.. اقتربت منها، أمسكت بذراعها، ساعدتها على الثبات ابتسمت السيدة بامتنان خافت، ثم همست: يا بنتي وين وصلتنا الدنيا؟".
تستكمل ريم، في ذاك اليوم عدت إلى البيت محمّلة بدلوين، شعرت للحظة أنني فزت بجائزة ثمينة، رغم أن ما عدت به لا يكفي ليومين، دخلت المطبخ وأفرغت ما حصلت عليه في خزّان بلاستيكي قديم، ثم جلست قرب النافذة، تطالع الشمس وتحاول أن تهضم فكرة أن الماء لم يعد رمز حياة فقط، بل أصبح امتحاناً للقدرة على الاحتمال.
تسرد ريم: الحياة بلا ماء لا تشبه الحرمان فقط، بل تُغيّر الروح تُصبح الجدران أقل دفئاً، والأطفال أكثر توتراً، والأمهات أسرع انهياراً.
النساء والعبء الأكبر
تقول ريم: الحقيقة أن الأمور لا تتحسن النساء في تونس يتحملن العبء الأكبر في إدارة حياة بلا ماء، يحسبن الكميات، يقسمنها بين الشرب والطهي والغسيل، ويتركن لأنفسهن نصيباً قليلاً، كأنهن آخر من يحق له التمتع بحق أساسي.
تضيف ريم، إن بعض الجارات يخزنّ الماء في البراميل، رغم معرفتهن بخطورة ذلك الحرارة تجعل الماء مرتعاً للبكتيريا، لكن ماذا يفعلن؟ ليس لديهن خيار آخر، ومع ارتفاع درجات الحرارة في السنوات الأخيرة، أصبحت مشكلات الجلد والجفاف ونوبات الإعياء شائعة بين الأطفال بعضهم يصاب بإسهال حادّ نتيجة مياه غير آمنة، كبار السن يزداد وضعهم هشاشة، خصوصاً من يعانون أمراضاً مزمنة.
الفلاحون اليوم يتركون أراضيهم بعضهم هاجر نحو المدن بحثاً عن عمل، تاركين وراءهم بيوتاً من الطين وصوراً للمواسم الماضية، آخرون باعوا مواشيهم لأن الماء لم يعد يكفي، والحقول التي كانت تغذي البلاد أصبحت عطشى.
تفند ريم الوضع، قائلة: ما أعيشه ليس حالة فردية، آلاف العائلات تحمل الدلو نفسه، تطرق الصنبور نفسه، وتُصاب بالإحباط ذاته كل بيت يعيد ترتيب حياته وفق جدول غير معلن للمياه كل أم تتعلم كيف تقتصد في كل قطرة.
تونس اليوم تواجه أزمة تتجاوز حدودها الطبيعية أزمة تعكس سنوات من سوء التخطيط وإغفال الاستثمار في البنية التحتية، وتهميش المناطق الريفية، وترك مصير الناس معلّقاً بين وعود سياسية وواقع يزداد قسوة كثير من المواطنين يشعرون بأنهم منسيون، وأن دولتهم التي من المفترض أن تحميهم أصبحت تتعامل مع الماء كونه امتيازاً وليس حقاً.
ريم لم تكن يوماً ناشطة سياسية أو بيئية لكنها اليوم تشير إلى دلوها وتقول: "هاني وليّت ناشطة غصباً لأن الوضع يفرض علينا نحكوا"، تتحدث بوعي جديد، وبتشوّف لحلّ لا يأتي تقول إن كل ما يريده التونسيون ليس الكثير: "خطّة واضحة، استراتيجية طويلة المدى، عدالة في التوزيع، إصلاح للسدود والشبكات.
وبين الدلو الأزرق الذي ترفعه ريم كل يوم، ونداءاتها التي تتردد في أحياء كثيرة، تتضح صورة بلد يقف عند حافة أسئلة مصيرية، هل ستُدار موارده بشفافية؟ هل سيُعاد بناء شبكاته؟ هل ستُعامل المناطق المهمّشة بقدر من العدالة؟ وهل ستفهم الدولة أن العطش ليس رقماً في تقرير، بل حياة تُختنق؟
العطش في تونس
لم يعد عطش الريم قصة خاصة ببيت أو شارع هو رقم ملموس يشرح كيف انهارت منظومة إدارة الماء في تونس، السدود الوطنية التي كانت تُعدّ مخازن أمان ارتفعت وتراجعت خلال السنوات الأخيرة، وفي 13 فبراير 2025 كانت مخزونات السدود عند نحو 36% من طاقتها، وفق تقديرات المديرية العامة للسدود والأشغال المائية.
وفي منتصف سبتمبر 2025 ترددت أرقام أشدّ خطراً تشير إلى تراجع الاحتياطي إلى 28.7% لبعض المؤشرات القومية، ما يعني أن قدرة الاحتياط للاستجابة لموجات الجفاف تقلّ بصورة صارخة مقارنة بالمعدلات التاريخية هذا الانخفاض ليس مجرد رقم مائي، بل مرآة لارتفاع الطلب وتقلص الأمطار وتآكل المخزون الاستراتيجي.
على مستوى الموارد المتاحة للفرد، تصنّف المؤسسات الدولية تونس ضمن بلدان شديدة الفقر المائي التقديرات الحديثة تشير إلى متوسط يقارب 420 متراً مكعباً من المياه المتاحة سنوياً للفرد، وهو دون معيار الأمن المائي (1000 م³/سنة يُعتبر حدّ الفقر المائي)، ما يجعل تونس دولة تعيش فعلياً تحت عتبة القلق المستمر حول توفر الماء للاحتياجات الأساسية والزراعة.
البنية التحتية نفسها تسرق الماء يومياً من أبناء البلد تراكيبات التوزيع للشبكات الحضرية والريفية تمتدّ لأكثر من 48,241 كيلومتراً من الأنابيب ويديرها مشغّل وطني واحد، لكن التسريبات والفقد التقني يُقدّر بمعدلات مرتفعة.. دراسات وتقارير عام 2025 تشير إلى أن الشبكات تخسر نحو 30% من إجمالي العرض بسبب التسربات وعيوب الصيانة.
وفي مارس 2024 رفعت الدولة أسعار مياه الشرب لشرائح استهلاك محددة بزيادات تصل حتى 16% للمستهلكين الكبار والمرافق الفندقية، بينما تُعفى الشرائح الصغيرة جزئياً، وإجراءات مثل حصص استهلاك ومقاطعة المياه الليلية طُبّقت في السنوات الأخيرة.
رفع الأسعار بنسبة ملموسة له أثر مباشر على ميزانيات الأسر التي تضطر لشراء قارورات وصهاريج تمثل أحياناً 10% إلى 20% إضافية من نفقاتها الشهرية في بعض المناطق الحرجة.
تقارير صحية سجلت ارتفاعاً في حالات الإصابات المعوية والإسهالات خاصة لدى الأطفال في الفترات الأكثر حرارة، حيث يُرجع مقدمو رعاية إلى تزايد تخزين المياه في ظروف غير معقمة كعامل مساعد؛ وفي غياب دراسات وطنية متكاملة لعام 2025، تُظهر تقارير منظمة الأغذية والزراعة أن الإنتاج الحبيبي تحسن نسبياً عام 2024 ليصل إلى نحو 1.5 مليون طن بعد انهيار في 2023، لكن هشاشة الأمن الصحي والغذائي لا تزال مرتبطة بتقلبات توفر المياه والممارسات التخزينية غير الآمنة.
القطاع الزراعي يدفع الفاتورة الأكبر عملياً، الأرقام الوطنية والحقليّة توضح أن المزارع الصغيرة والمتوسطة فقدت نسب إنتاجية قد تصل إلى 30–50% في مواسم جفاف حادّة متكررة، ويبلغ عدد العائلات الريفية المتضررة عشرات الآلاف.
الفلاحون الذين يعتمدون على الضخ السطحي والآبار المكشوفة واجهوا ارتفاع تكاليف الري بنسبة قد تتجاوز 40% نتيجة لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف السحب وحاجة اللجوء إلى الصهاريج.
تقارير حقوقية ورسمية مجمعة خلال السنوات الأخيرة تشير إلى أن نسبة الفقر في المناطق الريفية قد تصل إلى 26% مقابل 10.1% في الحضر، في حين يُبيّن تحليل توزيع الموارد المائية أن 55% من الموارد السطحية و45% من المياه الجوفية، مع استنزاف لطبقات جوفية غير متجددة في جنوب البلاد تزيد من هشاشة المستقبل.
تغيّر المناخ وسبل العيش
قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة المصرية، إن المشهد الزراعي في تونس يشهد خلال السنوات الأخيرة تحولات حادة وغير مسبوقة، نتيجة التأثيرات المتراكمة لتغيّر المناخ وتراجع معدلات الأمطار، مشيراً إلى أن هذه التحولات لم تعد ظرفية أو موسمية، بل باتت تمثل مساراً مناخياً جديداً يفرض نفسه على المنطقة بأكملها.
وأشار فهيم في تصريحات لـ"جسور بوست"، إلى أن من أبرز ملامح هذا التحول المناخي انتقال الكتلة المطرية الرئيسية شرقاً، نحو مناطق الأردن وفلسطين والعراق ودول الخليج، وهو ما جعل تونس تقع على هامش المنخفضات الشتوية الثقيلة التي كانت تشكّل في السابق العمود الفقري للموسم المطري.
وأضاف أن هذا التغيّر الإقليمي في توزيع الأمطار انعكس بشكل مباشر على الموارد المائية المتاحة، وأدّى إلى عجز واضح في تغذية السدود والمخزون الجوفي.
وأوضح أن هذا النقص المائي ترك آثاراً قاسية على عدد من المحاصيل الاستراتيجية والحساسة، وفي مقدمتها القمح والشعير والزيتون والخضراوات، لافتاً إلى أن المزارعين باتوا يلاحظون تراجعاً في نسب الإنبات، وضعفاً في امتلاء سنابل الحبوب، إلى جانب تساقط ثمار الزيتون وصغر حجمها، وتقزم بعض المحاصيل، فضلاً على زيادة انتشار الآفات المرتبطة بالإجهاد المائي وارتفاع درجات الحرارة.
ولفت فهيم إلى أن ارتفاع درجات الحرارة ساهم كذلك في زيادة معدلات التبخر، وتصلّب الطبقة السطحية للتربة، وهو ما عوق نمو الجذور وأضعف كفاءة امتصاص المياه، وانعكس في النهاية على تراجع الإنتاجية الزراعية للدونم الواحد، حتى في المناطق التي ما تزال تحظى بريّ نسبي.
وأضاف أن التوسع العمراني غير المنضبط، إلى جانب استمرار بعض الممارسات الزراعية التقليدية ذات الاستهلاك العالي للمياه، زاد من الضغط على الموارد المتاحة، مؤكداً أن تداخل هذه العوامل جعل أزمة المياه بنيوية وممتدة، وليست مجرد ظاهرة طارئة يمكن تجاوزها في موسم أو اثنين.
وأشار فهيم إلى أن المزارعين يحاولون على المستوى الفردي التكيف مع هذا الواقع الصعب بوسائل مختلفة، أبرزها التحول إلى نظم الري بالتنقيط، وتقليص مساحات زراعة الحبوب، والاعتماد على أصناف أقل احتياجاً للمياه. لكنه أوضح أن شريحة واسعة من المزارعين ما تزال عاجزة عن إحداث هذا التحول بسبب ضعف الإمكانات المالية وصعوبة تغيير أساليب الزراعة التقليدية المتوارثة.
وأضاف أن بعض المزارعين يلجؤون إلى حفر آبار جديدة رغم ما تمثله من خطر على المخزون الجوفي، في حين يضطر آخرون إلى تقليل عدد الدورات الزراعية سنوياً، وهو ما ينعكس سلباً على دخلهم واستقرارهم الاجتماعي.
وختم فهيم بالتأكيد على أن المشهد، رغم قتامة ملامحه، لا يخلو من حلول عملية قادرة على تعزيز صمود المجتمعات الزراعية، مشيراً إلى أهمية تعميم نظم الري الحديثة، وتحسين قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه عبر التغطية العضوية، وتوسيع مشاريع حصاد مياه الأمطار، وتفعيل استخدام المياه المعالجة.
الجفاف كتهديد عالمي للحياة
قال الكاتب والإعلامي السوداني سيبويه يوسف، إن أزمة المياه التي تشهدها تونس اليوم لا يمكن قراءتها باعتبارها حالة محلية معزولة، بل هي جزء من مشهد عالمي أوسع تعيشه دول عدة في الجنوب العالمي، بل وتمتد آثاره إلى بعض دول العالم المتقدم، في ظل تسارع وتيرة التغير المناخي وتزايد حدّته عاماً بعد آخر.
وأشار يوسف في تصريحات لـ"جسور بوست"، إلى أن التغير المناخي بات أكثر شراسة في الدول التي تعاني أصلاً من اختلالات بنيوية في إدارة مواردها، موضحاً أن دولاً مثل تونس وعدد من الدول الإفريقية تواجه الأزمة بقدرات محدودة، نتيجة تراجع الاستثمارات في البنية التحتية وغياب استراتيجيات مائية شاملة تتعامل مع جذور المشكلة لا مع أعراضها فقط.
وأوضح أن الجفاف المائي لم يعد مجرد احتمال مستقبلي، بل أصبح واقعاً عالمياً مرشحاً للتعمق خلال السنوات القليلة القادمة، وهو ما يفرض على الدول اعتماد سياسات قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تستند إلى التخطيط العلمي والعدالة في توزيع الموارد ولفت إلى أن ما يحدث في تونس يمثل مؤشراً واضحاً على أزمة دولية كبرى.
وأضاف يوسف أن تأثير انقطاع المياه أو ندرتها لا يتوقف عند حدود العطش، بل يمتد ليضرب البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات، لا سيما المجتمعات الزراعية التي يُعدّ الماء فيها عصب الحياة ومحرّك الدورة الاقتصادية، وأشار إلى أن أي خلل في توفر المياه ينعكس فوراً على الإنتاج الزراعي، وعلى الأمن الغذائي، وعلى دخل الأسر، ما يفاقم معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية.
ولفت إلى أن للأزمة أبعاداً صحية خطِرة، إذ يؤدي نقص المياه إلى لجوء السكان لاستخدام مصادر غير آمنة، قد يتشارك فيها الإنسان والحيوان في آن، ما يزيد من مخاطر التلوث وانتشار الأمراض. وأضاف أن غياب المياه النظيفة يفتح الباب أمام أزمات صحية معقدة، تبدأ من الأمراض المعوية ولا تنتهي عند تراجع المناعة العامة للسكان.
وأشار يوسف إلى أن الماء ليس مجرد مورد اقتصادي، بل حق إنساني أساسي، وأن أي مساس به ينعكس مباشرة على صحة الإنسان الجسدية والذهنية، فالإنسان الطبيعي يحتاج إلى كميات محددة من المياه يومياً، وعندما يُحرم منها تبدأ أعراض الجفاف بالظهور، من وهن عام وعدم تركيز، وصولاً إلى تراجع القدرة على العمل والإنتاج، وهو ما يؤثر في النهاية على النمو الاقتصادي والدخل القومي للدولة.
وأوضح أن الدول التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على الزراعة أو الثروة الحيوانية تصبح أكثر عرضة للخطر في ظل شح المياه، حيث يتهدد الإنتاج الزراعي، وتصبح الثروة الحيوانية عرضة للأمراض أو النفوق، ما يضع الأمن الغذائي برمته أمام تحديات وجودية.
وأكد يوسف أن دور الإعلام في هذه المرحلة بالغ الأهمية، مشدداً على أن التعامل مع أزمة المياه لا يجب أن يكون في إطار الخبر العابر أو التغطية الموسمية، بل من خلال تحقيقات استقصائية معمقة تكشف الأسباب البنيوية، وتطرح حلولاً واقعية، وتنقل صوت المتضررين الحقيقيين.
وختم بقوله، إن ما تشهده تونس اليوم يتقاطع مع تجارب دول ومدن أخرى حول العالم، مشيراً إلى ما تعانيه مناطق في جنوب إفريقيا من جفاف مائي حاد يهدد بتحولها خلال سنوات قليلة إلى مناطق بلا مصادر مياه كافية، القضية لم تعد قضية دولة بعينها، بل قضية إنسانية عالمية، يتطلب التعامل معها وعياً إعلامياً، وإرادة سياسية، واستراتيجيات عادلة تضع الإنسان وحقه في الحياة الكريمة في صدارة الأولويات.