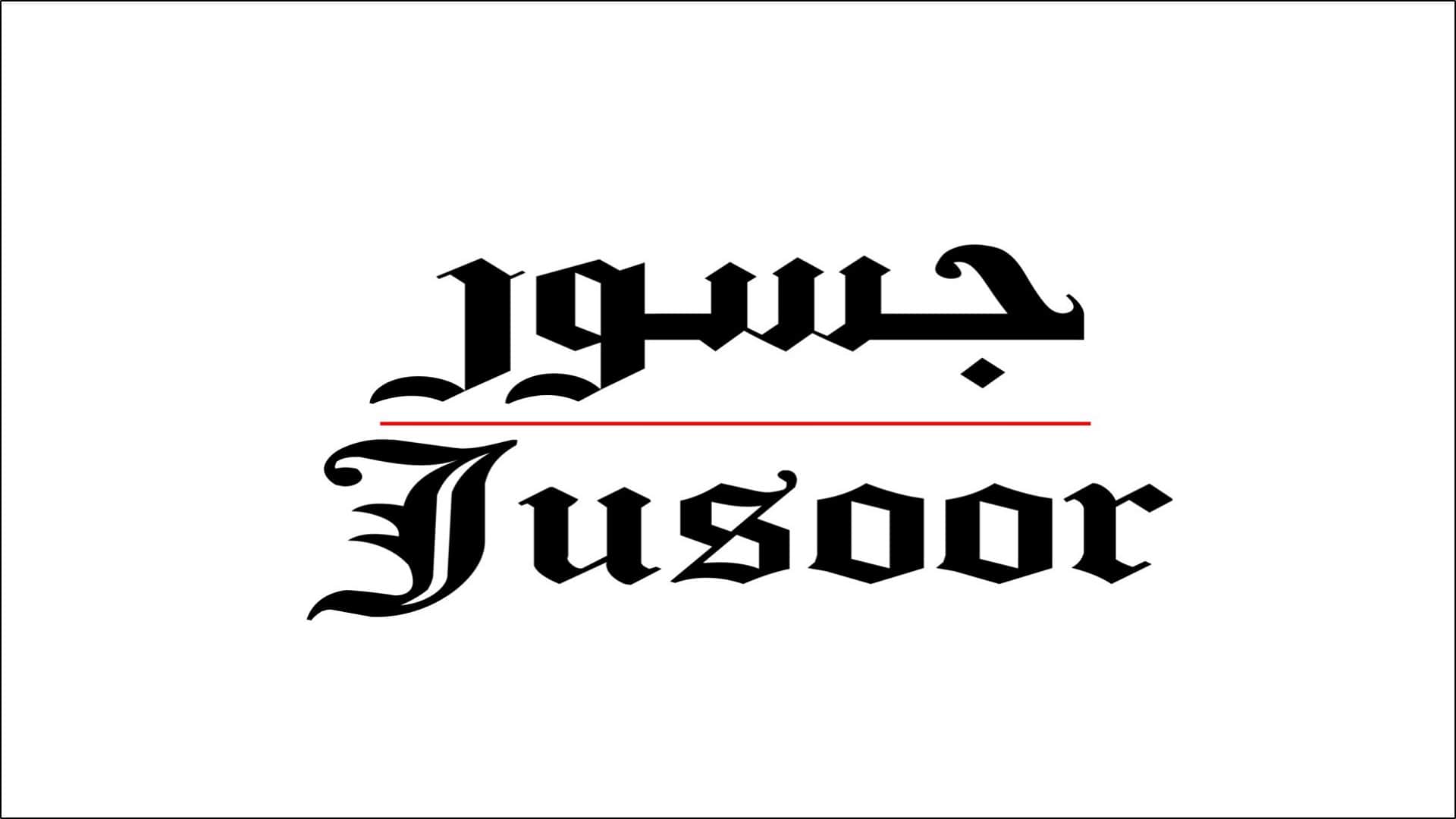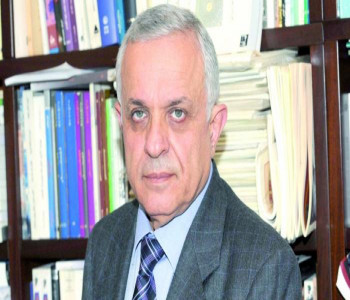رحلة محفوفة بالمخاطر.. "الهجرة غير الشرعية" طريق مجهول يسلكه الباحثون عن الأمل
رحلة محفوفة بالمخاطر.. "الهجرة غير الشرعية" طريق مجهول يسلكه الباحثون عن الأمل
"دفعتُ ألف دولار مقابل النور لكنّي دخلتُ عتمةً أعمق من الموت".. هكذا بدأ محمود الجاسم، ابن إدلب، حكايته التي تختصر مأساةً لا تُروى بالأرقام وحدها، لم يكن يسعى لحياة مرفّهة، بل لحقٍّ بسيط في النجاة.
يقول الجاسم بصوت منهك: "الهروب ما كان خياراً، كان البديل الوحيد عن الانتحار البطيء في وطن يطحن أبناءه بصمت".
في ليلة لا يميز فيها البصر بين ظلال الأشجار وظلال المقابر، وقف محمود على حدودٍ لا تُجيد سوى لغة الرصاص. بلا جواز، بلا وداع، وبجيب يحوي ألف دولار قال عنها: "دفعتها ثمناً للنور لكن النور لم يكن بيتًا آمناً، بل دربٌ معتمٌ عبر التهريب، محفوفٌ بالموت أو ما هو أسوأ منه"
يحكي محمود لـ"جسور بوست"، وهو يسترجع الرحلة بتنهيدة موجعة: "تعرفنا على ناس شغلتهم تهريب بشر، دفعت ألف، في ناس دفعت ألفين حسب الطريق. كنا 12 شخص من أماكن مختلفة، ما حدا حكى، لأن الخوف أخرس الكل".
في غابة كثيفة على الحدود التركية، بدأ فصل الرعب الحقيقي.. ظلام دامس، ألغام مبعثرة، أسلاك شائكة، قنابل غاز، وعيون تترصّد خلف الأشجار أحدهم أُصيب برصاصة، آخر لفظ أنفاسه، ومحمود نجا، لكنه لم يعرف أن عبور النهر بقارب مطاطي -مخصص لستة- ركبه اثنا عشر، سيكون أكثر لحظاته "أماناً".
على الضفة الأخرى، بدأ انتزاع ما تبقّى من الكرامة: "المهربون صادروا الأكل والشرب، وكأنهم يدرّبوننا على الموت البطيء، كلما اقتربنا من نقطة عبور، زاد الابتزاز، النساء طُلب منهن ما هو أثقل من المال، شيء ينهش الروح".
شهادات مفجعة للاجئات
تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2024 وثّق شهادات مفجعة للاجئات سوريات تعرضن للتحرش والابتزاز الجنسي من قبل مهربين وحرس حدود أتراك، شهادات تُظهِر أن الانتهاك لم يكن استثناءً، بل قاعدة صامتة لا يتحدث عنها أحد.
لاحقاً، اعتُقل محمود بعد عامٍ من العمل في ورش صغيرة، "كانت سنة عبودية حديثة" كما وصفها، أجر زهيد، بلا أوراق، بلا تأمين، بلا حق حتى في النوم تحت سقف، دفع ليستأجر زاوية في غرفة مزدحمة، وفي كثير من الليالي بات في الحدائق أو المساجد.
قصة محمود ليست شذوذاً، بل مرآة مشروخة لأزمة إنسانية مزمنة. وفقًا لتقرير منظمة العمل الدولية 2023، فإن 80% من العمال السوريين في تركيا يعملون في القطاع غير الرسمي، دون حماية قانونية أو حقوق.
وتشير بيانات المديرية العامة لإدارة الهجرة التركية إلى أن عدد السوريين المسجلين انخفض حتى يوليو 2025 إلى نحو 2.9 مليون، أكثر من نصفهم في سن العمل، يعيشون في هشاشة قانونية واجتماعية.
لكن الأكثر رعباً لم يكن الجوع أو الظلام، بل عصابات الظلال، يقول محمود: "في ناس ماتت وطلعوا أعضاءهم وباعوها، بعضهم كانوا رفاقي، والبعض اختفى وما عرفنا عنهم شي"، لم يكن ذلك محض خيال، ففي تحقيق استقصائي نشره موقع "درج" في منتصف 2024، كُشفت شبكات ناشطة في تجارة الأعضاء على الحدود الجنوبية لتركيا، تستهدف لاجئين غير موثقين لا يسأل عنهم أحد إذا اختفوا.
العودة قسريّاً إلى الجحيم
بعد عام من الجحيم، أُلقي القبض على محمود أثناء توجهه للعمل، ورُحّل قسرياً إلى إدلب، لم تكن العودة عودة إلى وطن، بل إلى مكان لم يعد يعرفه.. مدينة مدمرة، خيمة في العراء، ولا شيء سوى ذاكرة الجوع والخوف، "دفعت الألف مشان أهرب من القذائف، رجعت لقيتا بتستناني بس في شي جديد.. الجوع بلا نهاية".
الهجرة غير الشرعية، أو كما تسميها التقارير الحقوقية "الهجرة القسرية خارج الأطر القانونية"، لم تعد خياراً، بل صارت لغة الذين لا خيار لهم.
وفقًا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حتى 2025، أكثر من 6.8 مليون سوري فرّوا خارج البلاد، بينما نزح أكثر من 7 ملايين داخلياً، ما يجعل سوريا الأولى عالميًا بعدد المهجرين قسرًا.
لكن الأرقام لا تروي الكارثة، المأساة تسكن تفاصيل لا تُدوَّن.. في وجه أم أنجبت على طريق الهروب، في يد طفلٍ لم يُمسك يوماً كتاباً، في شابٍ يجهل كيف يبتسم لأنه لم يعرف السلام يوماً.
طرق الهروب من الجحيم السوري لم تمر فقط عبر تركيا من لبنان إلى قبرص، من ليبيا إلى إيطاليا، ومن الساحل السوري إلى البحر المفتوح، اختلفت المسارات واتحد المصير.
الموت في طريق الهجرة
منظمة "ميديتيرانيا" الإيطالية أكدت في تقرير 2023 أن واحداً من كل 6 مهاجرين عبر ليبيا إلى أوروبا، مات في الطريق، أما العابرون من سوريا، فقليل منهم مَن وُثّقت نجاته، وأقل من ذلك من عاد ليحكي.
في إدلب وحدها، بحسب تقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA) لعام 2024، يعيش أكثر من 2.9 مليون نسمة، نصفهم في خيام، وأكثر من 60% من الأطفال خارج المدارس، في حين تعتمد 80% من العائلات على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. اقتصاد منهار، قصف متقطع، وغياب تام لأي أفق.
قال محمود: "رجعت لأنهم طردوني، مش لأنو الوضع صار أحسن، على الأقل هون ما في شرطي يهددني بالترحيل، بس في جوع، وخوف، وألغام مدفونة تحت كل خطوة".
حين سُئل عن أحلامه، أجاب بصوت مكسور: "بدي بيت ما ينفجر بدي مدرسة لأولاد الجيران، بدي الألغام ينشالو من تحت التراب. ما بدي شي تاني".
الهجرة غير الشرعية ليست مجرد ملف سياسي أو أمن حدودي إنها مرآة تعكس حجم الانهيار الأخلاقي في نظام عالمي يغضّ الطرف، ويحسب عدد من عبروا، دون أن يسأل عن الذين لم يُكملوا الطريق.
المحاسبة لا تبدأ بتشديد المراقبة، بل بتفكيك الأسباب.. حلّ سياسي شامل، وقف النزاعات، إعادة الإعمار، ضمان حقوق الإنسان، وتأمين عودة كريمة للمهجرين. لا بد أن تعود سوريا وطناً لا مجرد مكان للعودة القسرية.
محمود لا يريد كثيراً لم يطلب حق اللجوء، ولا جوازاً، ولا منحة، يريد فقط ألا يخاف، ألا يُهجر مرتين؛ مرة من الأرض، ومرة من الحلم.
"أنا متعلم، درست تربية، وكنت حابب أصير أستاذ، يمكن لسه في وقت بس كل يوم بيضيع، بيضيع معو جيل كامل".
ربما قالها دون أن يدري أن شهادته صارت وثيقة، وأن صوته، بلا توقيع ولا ختم، هو المرآة الأصدق لسوريا ما بعد الحرب.
في قصة محمود، لا نحتاج كاميرا، نحتاج ضميراً لا يغضّ النظر، وعالماً لا يحتفل بالناجين فقط، بل يتساءل: من لم ينجُ؟ ولماذا؟
أملٌ مبيع على دروب الموت
أمام ذلك الصمت المريع للغياب والمفقودين، نرسم بأقلام الحقيقة رحلة اللاجئين الذين اختفوا في الطريق دون أن يتركوا أثراً ملموساً سوى بطاقة هوية أو حرارة ذكرى في منتصف البحر المتوسط، حيث يستقر الغياب غرفةً مقفلةً، سجلت منظمة الهجرة الدولية (IOM) منذ بداية عام 2025 حتى منتصف يونيو أكثر من 226 مفقودًا و234 قتيلًا على خط وسط البحر المتوسّط وحده، في حين أفادت بالعثور على 9,999 شخصًا تم اعتراض رحلاتهم وأعيدوا إلى ليبيا بعد اختراق مخاطر الموت على أمل الوصول إلى أرض الأمان.
هذا هو المشهد الأول: لا جثث، ولا قبور، فقط بطاقات هوية محفوظة في أدراج الأمهات، صور تُطلّ بانتظار أن تأتي الأرواح لتحتفي بها في عيد ما، كما لو أن الرأس ستعود من الغياب لتجلس على طاولة الطعام، أم لا تزال تطبخ كل عيد رغيفًا لابنها الغائب، كأنها ترسم حكاية غياب مزدوج: غياب الجسد، وغياب العدالة.
من قلب هذا الفقد، تنبع شظية الانفعال الحقوقي: العائلات التي لم تجد جثثًا أو قوارب تنقلهم، تظل أسيرة سؤال واحد يتوارد في أحلامها: أين هو؟ هل في البحر؟ هل في برية سوداء بين الحدود والمخابئ؟ هل تبقى جثته آخر رسالة من أرض الأحياء؟ مساحات الغياب تلك تُخلّد صور الغياب المزدوج؛ لا جسم، ولا جواب، ولا قصاص.
ومع استمرار العدّ القاتل، تؤكد بيانات Missing Migrants Project أن منذ عام 2014، راح 72 ألف إنسان على الأقل ضحية للهجرة غير المنظمة، وفُقد أكثر من 29 ألف جثة لم يُعثر عليها، معظمها على طرق البحر المتوسط؛ الطريق الأكثر دموية بين المسارات الدولية. في عام 2025 وحده، فقد البحر سجلًا جديدًا؛ فقد سُجّل نحو 93 شخصًا مفقوداً وأكثر من 24 ألفًا منذ 2014 على هذه الطريقة وحدها.
في قلب هذا الصمت المميت، يبرز فصلٌ ثانٍ عن "سماسرة الأمل" الذين يتحولون من وسطاء إلى تجار بشر، تجار يبيعون وعود الأمان بسعر مرتفع، باستغلال يشطب الكرامة.
تجارة تدر الملايين
يكشف تحقيق حديث أن هذه التجارة غير الرسمية تدرّ مئات الملايين من الدولارات سنويًا، إذ إن السوق لا يعرف الرحمة؛ فبينما يدفع البعض بضعة مئات يورو، هناك من يدفع آلافًا ويحصل في المقابل على مقعد متهالك على قارب بلا سقف ولا ضمانات إصلاح، وكأنهم يشترون لحظة موت محتومة.
شبكات التهريب، كما يظهر من تحقيقات صحفية، وجدت في اللاجئين سلعة رابحة. منعًا للصدام مع البيانات السرية، لا يمكن استنساخ قصة شخص، لكن يتضح من وثائق الحوادث أن سعراً متوسطاً قدره 3,300 جنيه إسترليني يُفرض لكل شخص عبر ليبيا إلى أوروبا، كما حصل في شبكة المهرب المصري أحمد إيبيد التي أشرفت على نقل حوالي 3,800 مهاجر عبر البحر المتوسط، واستثمارات تقدر بملايين الجنيهات الإسترلينية عوائد مباشرة من هذا السوق القاتل.
وليس فقط ذلك، ففي الشبكات الأوروبية، كما كشف تحقيق أمني بريطاني حديث، فإن مهربي القوارب من إقليم كردستان حققوا أرباحًا ضخمة، تُقدر بـ130 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 وحده، يعيدون فيها تدوير الأرباح في تمويل جرائم أخرى كتهريب الأسلحة والمخدرات.
والقارب الواحد الذي يحمل خمسين مهاجرًا يدر ربحًا يصل أحيانًا إلى 100 ألف جنيه في الرحلة الواحدة، وكأنهم يحوّلون خوف الناس إلى ذهب لا يشبع.
في سوق كهذا، يُصَنف اللاجئون حسب العمر والجنس والقدرة المالية: من هو "صالِح للعبور"، ومن يُترك لأهواء الطامعين. الأطفال والنساء تدفعهم أحيانًا عائلاتهم بالكامل لشراء نصيب في القارب، في حين يُحرم معظمهم من أوراقه الأخيرة، أو رصيده الأخير من الأمل.
أمل على قوائم الانتظار
في مشهد أسود محكوم بالاستغلال، تجلس أسرة ترتدي فقرها كما تلبس ثوبًا، تفاوض السمّاع على السعر الأخير: "تركتوا بيتكم وكل ما تملكتم لتبقوا في قائمة الانتظار على قارب، ليس كراكب، بل كميتٍ مؤجل"، التفاوض يدور حول السعر، لا حول الحياة.
يتبادل المهربون رموزًا هاتفية، صورًا للرحلة، أوصافًا بشرية مجمّدة في صورة "بيانات الزبون" على الهاتف، كأن الرحلة سلعة تُشكَّل في خلفية شاشة.
ورغم أن كل شيء يبدو تدفقًا للمال، فإن الأسماء لا تخرج من تحت الرموز. هنا، شخص المهرب الذي لم يعد يتذكر وجوه "العملاء"، بل الأرقام والحركات البنكية. وكل صفقة تستوجب مقرًا، ورابطًا، وتكلفة إضافية للمستقبل غير المكتوب.
وفي مواجهة سطوة هذه السوق السوداء، تقف المنظمات الدولية تُحذّر: "شركات التهريب لم تُخلق من الفراغ، بل من ضعف السياسات، من غياب آليات الهجرة الشرعية، ومن إصرار العالم على جعل التحرك محرمًا لا قانونيًا".
تنادي بإيجاد مسارات منتظمة وبدائل إنسانية تضمن الحماية، لكنها ترى أن الطريق لا يزال محفوفًا بالعرقلة بين القوانين التي تقتل وتُقصي، كما تنادي بيانات Missing Migrants Project بـ"ضرورة توفير مسارات آمنة ومنظمة بدلًا من دفع الأشخاص إلى أيدي شبكات قاتلة".
الأمواج تبتلع أحلام الأطفال
يقول الدكتور أيمن زهري، بخبرته الأكاديمية العميقة في سياسات الهجرة، وصوته المثقل بالشهادات والملفات والتقارير التي مرّت أمامه كقافلة من المآسي: "حين يغادر طفل سوري شاطئ طرطوس أو إدلب أو حتى مخيمًا في لبنان، ويصعد على قارب مطاطي متهالك، لا يكون قد اختار الحياة، بل يكون قد رفض الموت المتكرر في الوطن".
هكذا تبدأ الحكاية، لا كخبر أو إحصائية، بل كنقطة سوداء في قلب خارطة البحر الأبيض المتوسط، البحر الذي غدا شاهدًا على اختفاء أكثر من 3,500 طفل في السنوات العشر الأخيرة وحدها، كما وثقت منظمة "اليونيسف" في تقريرها الصادر في أبريل 2025 أطفالاً أغلبهم، ما يقارب 70% منهم، كانوا بمفردهم، لا أم تحتضنهم، ولا أب يحميهم، ولا حتى يد راشدة تمسك بهم وسط هيجان الأمواج أو في مواجهة ذئاب البر التي تقتات على اليأس.
أوروبا، كما يصفها أيمن في تصريحاته لـ"جسور بوست"، تتحول إلى ما يشبه "فخًا مطليًا بالأمل"، يُباع فيه الحلم بسعر مرتفع يُدفع بالدولار أو بالدم أو بكليهما. الأطفال الذين غادروا سوريا، لم يفعلوا ذلك بدافع المغامرة أو الطموح؛ بل لأن الموت صار أكثر حضورًا من المعلم في المدرسة، ومن الطبيب في المستشفى، ومن الخبز على المائدة. الحرب، الحصار، الانهيار الاقتصادي، فساد النظم، وانعدام الأمان، كلها أسباب دفعت الأمهات إلى توديع أطفالهنّ عند الموانئ، بأمل أن "الضفة الأخرى" قد تكون أكثر رحمة.
لكن الواقع -كما يراه زهري من موقعه بصفته مستشاراً سابقاً للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة- أبعد ما يكون عن الرحمة. "في عام واحد فقط، عام 2024، غرق وفُقد أكثر من 1,700 شخص في طريق البحر المتوسط الأوسط-الطريق الذي يربط شواطئ ليبيا وتونس بإيطاليا. كثير من هؤلاء كانوا أطفالًا من سوريا، من السودان، من إريتريا، ومن أفغانستان. كأن هذا المسار أصبح مقبرة مائية لا نهاية لها".
مراقبة الحدود لا تحل الأزمة
يضع أيمن إصبعه على الجرح المفتوح: "ما نراه هو فشل جماعي، لا يمكن أن نعالج هذه الأزمة بتكثيف المراقبة على الحدود أو الدوريات البحرية هذه إجراءات تلامس القشرة، لكن العفن في الداخل العفن الحقيقي في غياب التنمية، في تهالك التعليم، في انهيار الحماية الاجتماعية، في أنظمة طاردة للأطفال بدلًا من أن تكون حاضنة لهم".
ويردف بصوت لا يخفي انفعاله المهني والإنساني: "الهجرة غير الشرعية للأطفال السوريين ليست حدثًا منفصلًا، بل نتيجة منطقية لسلسلة طويلة من الإهمال والتجاهل والتسييس، حين يعيش الطفل وسط حرب بلا مدرسة، بلا عيادة، بلا أفق، ماذا تنتظر منه؟ أن ينتظر الموت بصمت؟ أم أن يختار أن يموت وهو يحاول أن ينجو؟".
وفي إيطاليا، الوجهة المفضلة لهؤلاء الهاربين، لا يجد الأطفال ما وُعدوا به. تشير تقارير منظمات حقوقية إلى أن مراكز الاستقبال التي يُحتجز فيها القُصّر كثيرًا ما تفتقر لأبسط معايير الإنسانية، الأطفال يُزجّ بهم مع بالغين، دون فصل أو حماية، دون متابعة نفسية أو تعليمية، ما يجعلهم فريسة سهلة للاستغلال الجنسي والاقتصادي، أو ببساطة، للهروب إلى شوارع غريبة يختفي فيها الأطفال كما اختفوا في البحر.
يقول أيمن: "هذا الانهيار الأخلاقي لا يُغتفر، أوروبا التي وقعت على اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعهدت في الميثاق العالمي للهجرة بحماية الأطفال، لم تترجم ذلك إلى أفعال، نرى الأطفال يُعامَلون كخطر محتمل، لا كضحايا محتاجين إلى رعاية. أين الحماية؟ أين التعليم؟ أين الطبابة؟ أين الحاضنة؟".
ولعل ما يزيد من مأساوية المشهد هو أن الأرقام، مهما بلغت من الدقة، لا تعبّر عن عمق الألم "كل رقم من هؤلاء الثلاثة آلاف وخمسمائة طفل، هو اسم، له صوت، هو ضحكة ضاعت، هو حلم بسيط باللعب أو الذهاب إلى المدرسة، اختصرناهم في جداول إحصائية، ونسينا أنهم بشر، هل يمكن أن نعيد النظر في سياساتنا لا من منظور السيادة والسيطرة على الحدود، بل من زاوية إنسانية؟
ويتابع زهري بنداء لا يخلو من الرجاء: "نحن بحاجة إلى هيئة دولية لا تكتفي برصد الأرقام، بل تلاحق مصير كل طفل من لحظة مغادرته إلى أن يجد مكانًا آمنًا، نحتاج إلى قاعدة بيانات مشتركة، إلى تنسيق فعلي بين الدول، إلى مسارات قانونية للهجرة الأهم، أن نتوقف عن شيطنة هذا الطفل، عن التعامل معه كأنه عبء".
ثم يختم أيمن حديثه بكلمات تحفر في الذاكرة: "نحن لا نواجه أزمة هجرة، بل أزمة ضمير، حين يموت الطفل السوري في عرض البحر، لا يموت لأنه فقير أو لاجئ... بل لأنه غير مرئي في حساباتنا، وآن أوان أن نراه".
قراءة في جذور الأزمة
بصفتها خبيرة في شؤون الهجرة، تقول الدكتورة بسمة فؤاد إن الإجابة على سؤال كيف نوقف الهجرة غير النظامية لا تكون في مؤتمرات أوروبية مغلقة، ولا في كاميرات حرارية على سواحل المتوسط، وقفها يبدأ من الصدق. مضيفة أن الصدق مع أنفسنا أن الهجرة ليست ظاهرة أمنية فقط، بل هي مرآة مكسورة لخلل عميق في أنظمة التنمية والعدالة والفرص.
وقالت فؤاد في تصريحات لـ"جسور بوست": "أزمة الهجرة لا تبدأ من القارب، بل من القرية، من مدينة مهملة، من شاب أنهى دراسته ولم يجد عملاً، من عائلة دفعت بابنها إلى البحر لأن اليابسة لم تعد تتسع له"… ولهذا ترى بسمة أن أي حديث عن الحل يجب أن يبدأ من الاستثمار في الجذور، لا فقط إدارة الفروع.
"نحن بحاجة إلى برامج اقتصادية حقيقية في المناطق المُصدّرة للهجرة، لا إلى منح طارئة تنتهي بانتهاء الصورة الصحفية" تقول، وتوضح أن المطلوب هو تعليم يرتبط بسوق العمل، وتدريب مهني يؤدي إلى وظيفة حقيقية، واستثمارات منتجة تُشرك المجتمعات المحلية، وتفتح نوافذ أمل. حين يجد الشاب فرصة في وطنه، لن يُخاطر بحياته في زورق بلا بوصلة.
تلك الهجرة، تقول د. بسمة، لا يمكن كبحها بقرارات حدودية فقط، بل بقوانين داخلية صارمة في بلدان المنشأ، تجرّم شبكات التهريب، وتلاحق سماسرة الأمل الكاذب، يجب أن تُعاقب الأسر التي تدفع أبنائها للموت، لا بدافع الحاجة فقط، بل أحيانًا بدافع الربح.
"في بعض القرى، صار إرسال الابن إلى أوروبا تجارة، والمُهرب صار يشبه مدير مشروع. لهذا نحن بحاجة إلى حملات توعية جادة، تحكي قصص الذين غرقوا، لا الذين وصلوا".
ثم تنتقل بسمة إلى شق آخر من المعادلة: "الذين وصلوا"، تقول إن الدول المستقبلة، خصوصًا في جنوب أوروبا، تحتاج إلى إعادة نظر جذرية في طريقة تعاملها مع المهاجرين، حيث تكون البداية من الاعتراف بأن هؤلاء ليسوا "غير شرعيين"، بل ضحايا واقع غير إنساني. ومراكز الاستقبال، كما تصفها، يجب أن تكون إنسانية، بإشراف منظمات دولية مستقلة، كاليونيسف أو الصليب الأحمر، لا أن تتحول إلى أماكن احتجاز أو انتظار للعقوبة.
وتخصّ بالذكر مراكز تأهيل المهاجرين في دول مثل إيطاليا، حيث تشير إلى أن كثيرًا منها لا يتمتع بأي رقابة أمنية فعلية، ما يجعلها بيئة للهروب أو الاستغلال. "بعض المراكز، للأسف، تُسهّل هروب الأطفال حتى لا تتحمل مسؤولية تأهيلهم".
أما من ناحية السياسات، فترى بسمة ضرورة تنسيق حقيقي بين وزارات الصحة والتعليم والداخلية في الدول المستقبلة، بدلًا من العمل كلٌّ على حدة، كما لو أن الهجرة شأن أمني فقط. يجب أن نتعامل مع المهاجر بصفته إنساناً له احتياجات شاملة: نفسية، وجسدية، وتعليمية، وقانونية.
التعاون الدولي، بحسب بسمة، لا يجب أن يظل حبراً على ورق. تطالب بتوقيع ميثاق إلزامي بين دول المنشأ والعبور والاستقبال لحماية المهاجرين، خاصة القُصَّر، تحت إشراف أممي، مع تقارير دورية معلنة للناس، لا فقط للدبلوماسيين، كما تدعو لإنشاء مكاتب أمنية مشتركة على حدود العبور -في ليبيا، وتونس، ومصر- تتعقب شبكات التهريب، وتمنع جريمة مكتملة الأركان تحدث كل يوم.
وتضيف: "نحتاج قاعدة بيانات موحدة أوروبية-إفريقية، تُراقب الأطفال غير المصحوبين وتمنع ضياعهم في الظل".
كما ترى أهمية إشراك المنظمات المجتمعية على الأرض، التي تعرف الحكايات والوجوه، وتفهم الخريطة أكثر من مكاتب السياسات البعيدة.
أما عمن وصلوا بالفعل، فتؤمن بسمة أن الحل في منحهم وضعًا قانونيًا مؤقتًا، لا يُجبرهم على دخول دهاليز اللجوء المعقّدة، بل يحميهم إلى أن تتضح الصورة. تُشدد على دمجهم في المدارس، وتوفير كادر تربوي يتعامل مع الصدمة قبل التعليم، وتخصيص عيادات متنقلة في مراكز الاستقبال تعتني بأجسادهم ونفسياتهم الممزقة.
وتختم بسمة تصريحاتها، برسالة واضحة: "لا أحد يترك وطنه طوعًا، حين نريد وقف الهجرة غير النظامية، علينا أن نبني أوطانًا تُغني عن الهرب".