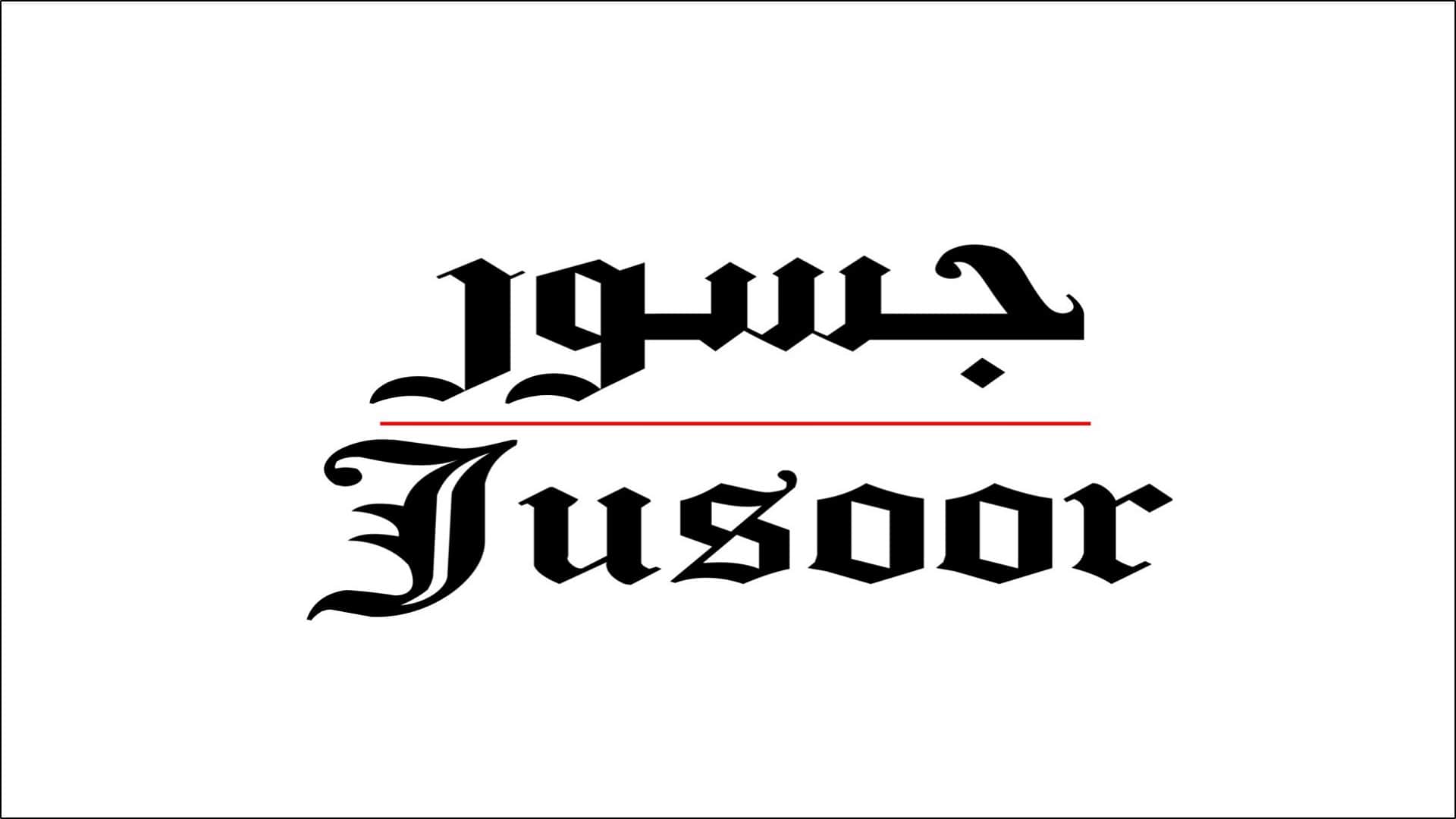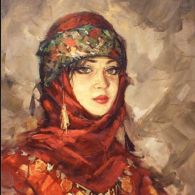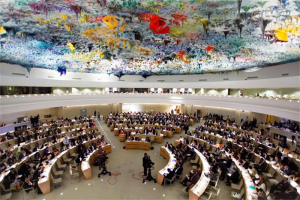عن الجذور العربية للروح التسامحية
عن الجذور العربية للروح التسامحية
من بين أهم القضايا الفلسفية والفكرية التي تبقى مثيرة للجدل عبر الأزمنة والأمكنة، نجد الحديث عن قضية التسامح، لما لها من تأثير مباشر على النفس البشرية في كل مناحي حياتها وتفاعلاتها.
في هذا الإطار يعن لنا أن نتساءل: “هل للتسامح جذور تاريخية في الفكر العربي والإسلامي، ما يعني أن الحديث عنها مجدداً في حاضرات أيامنا ليس إلّا إحياء للجذور التنويرية في مواجهة الهجمات الأصولية الظلامية المغشوشة في حاضرات أيامنا؟”.
لعل من يقرأ في كتاب “لسان العرب” لابن منظور، يجد كم أن كلمة التسامح وما يدور حولها من مفاهيم، ثرية المعاني، فالفعل مشتق من سمح، والسماح والمسامحة: الجود والعطاء عن كرم وسخاء، وليس تسامحاً عن تنازل أو منة، والمسامحة: المساهلة وتسامحوا: تساهلوا، لأن “السماح رباح”، كما جاء في الحديث الشريف، بمعنى أن المساهلة في الأشياء تريح صاحبها.
وتقول العرب: “عليك بالحق فإن فيه لمسمحاً، أي متسعاً. فالتسامح حق يتسع للمختلفين. وعموماً يستخدم التعامل مع كل ما لا يوافق عليه، ويصبر عليه، ويجادل فيه بالتي هي أحسن، ويتقبل وجوده بوصفه حقاً من حقوق المخالفة، ولازمة من لوازم الحرية التي يقوم عليها معنى المواطنة في الدولة المدنية الحديثة.
ولعل أبدع مشهد يكشف عن مساحة التسامح في النفس العربية قد جرت به أحوال التاريخ في الأندلس، حيث عاش العرب والمسلمون قرابة الخمسمئة عام، دون نفي أو عزل، وبلا إبعاد أو إقصاء للآخر، وعندما سقطت دولة الموحدين في مواجهة فرديناند وأيزابيلا الأرجونية، فضل يهود الأندلس الرحيل مع المسلمين إلى بلادهم، عوض أن يتحولوا إلى المسيحية قسراً، الأمر الذي عرف بظاهرة المتنصرين في الخارج، أو من يطلق عليهم “يهود المارانوث”، وعاشوا في بلاد المغرب العربي وسط المسلمين، وامتد بهم المقام في أرجاء العالم العربي، في دمشق وبغداد، وفي القاهرة والقيروان، تحت ظلال من التسامح الحقيقي، ذاك الذي في ظله أورقت أشجار الحضارة العربية، وملأت الدنيا علماً وأدباً وفكراً… من أين استمد أولئك العرب المسلمون روح التسامح تلك؟
على أن قائلاً يقول إن مفردة التسامح لم ترد نصاً في القرآن الكريم، وعليه فإن مفهوم التسامح هو مفهوم غربي لم يعرفه العرب أو المسلمون في تاريخهم وفي أصل عقيدتهم؟
تبقى هذه ولا شك فرية من أكاذيب نفر من المستشرقين الموتورين، غير الموضوعيين، الكارهين للعرب والمسلمين كراهية أصولية يمينية غربية، وقد تصدى للجواب عن هذه الإشكالية الكاتب والمفكر والدبلوماسي الإماراتي الدكتور يوسف الحسن في كتابه الكبير القيمة “أسئلة الهوية والتسامح وثقافة الحوار”، وعنده أن القرآن الكريم مليء بالألفاظ والمعاني، ما يترجم معنى التسامح إلى واقع.
فالدعوة القرآنية إلي العفو والإحسان، والبر والقسط في حق الغير، ممن لم يقاتلنا في الدين، ولم يخرجنا من ديارنا، هي دعوة للتسامح، ومثلها “لا إكراه في الدين”، والمجادلة بالتي هي أحسن، وبالحكمة والموعظة الحسنة، واحترام كرامة الإنسان، واللين والمعروف، وسعة الصدر التي تفسح للآخر المختلف أن يعبر عن رأيه، حتى لو لم يكن موضوع تسليم أو قبول، فضلاً عن العدل في المعاملة دون تمييز حتى مع المغايرين والمخالفين، والوفاء بالعهد لأهله، مهما اختلفت عقائدهم ولغاتهم وألوانهم، وقيم الرحمة تجاه العالمين والتي تعني قبول الآخر المغاير.
وفي كل الأحوال فقد أظهر أئمة وفقهاء المسلمين في زمن المد الحضاري الخلاق، أريحية واسعة وعريضة للتسامح، ما يعني أن قيم التسامح وثقافته في تلك العصور العربية والإسلامية الزاهية، تحولت إلي قيم أخلاقية معاشة، لا شعارات جوفاء مرددة، وثقافة مجتمعية بأبعاد فكرية ومعنوية وسياسية واجتماعية وحقوقية، وهي أيضاً “القدرة على تحمل الرأي والرأي الآخر”، والتعايش مع الآخر في سياق الاختلاف والوئام الإنساني، ونستحضر هنا كلام الإمام أبي حنيفة النعمان “كلامنا هنا رأي، فمن كان عنده خير منه فليأتِ به”، كما نستحضر قولاً آخر للإمام الشافعي “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب، ومن جاء بكلام أفضل مما قلناه قبلناه”.. كان هذا المفهوم مفتاح نهضة العرب في زمن الازدهار، لا الانحدار.
التسامح مفتاح للقفز على الضغائن والأحقاد إلى عالم السعادة الحقيقية غير المنحولة، وهو ركيزة الإعمار الفكري المستقبلي للبشرية، وبدونه تتحول البسيطة إلى جحيم مستدام من الكراهية والتعصب والتعاسة… هل ينتشر فيروس التسامح حول العالم العربي؟
يأمل المرء ذلك، وما هو على الله بعزيز.