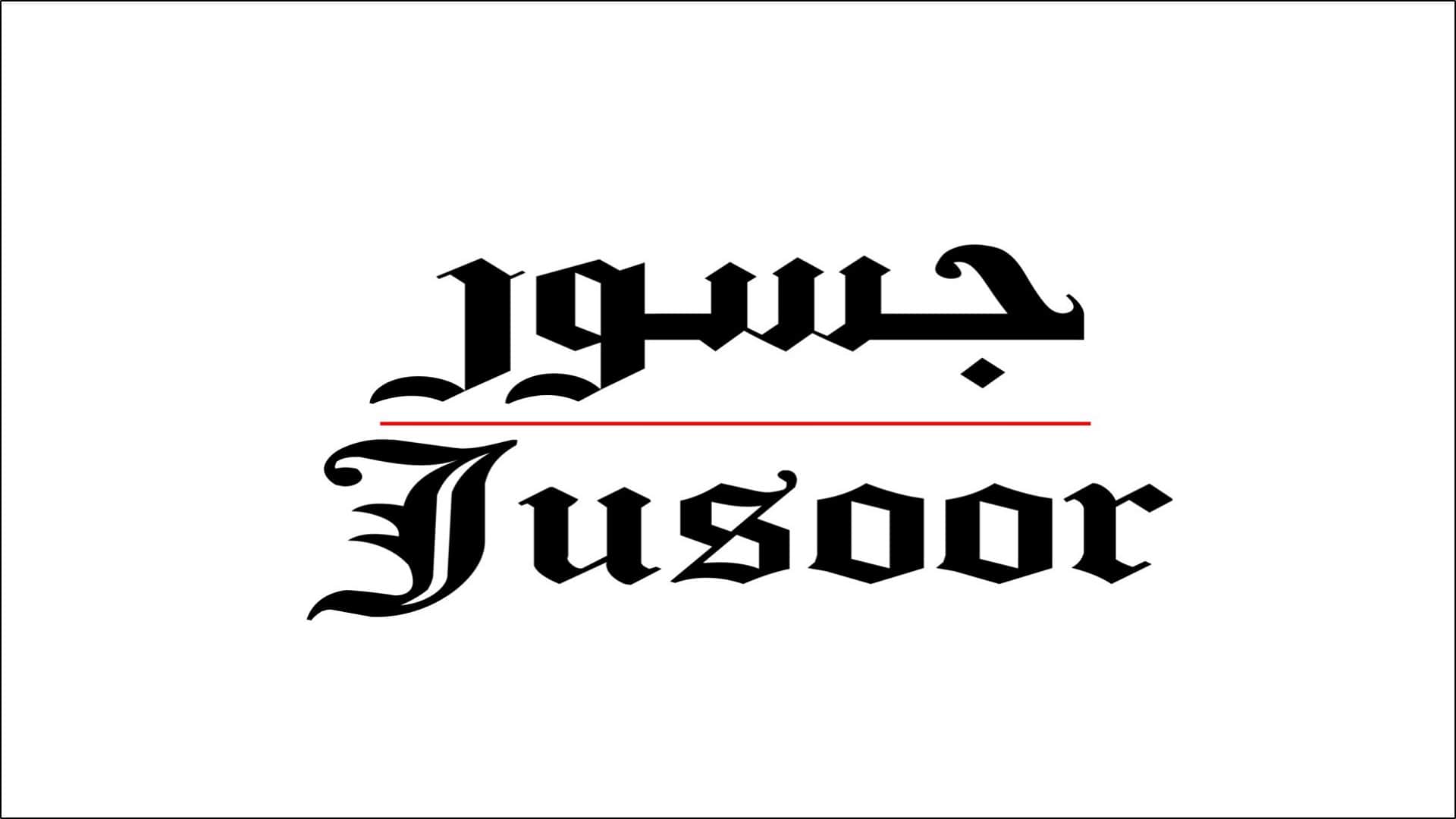العنف القائم على النوع الاجتماعي في العالم العربي.. وباء صامت يقوض التنمية والعدالة
العنف القائم على النوع الاجتماعي في العالم العربي.. وباء صامت يقوض التنمية والعدالة
يُعد العنف القائم على النوع الاجتماعي واحدًا من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم، إذ لا تقتصر آثاره المدمرة على الأفراد فحسب، بل تمتد لتُعطل التنمية وتزعزع استقرار المجتمعات، وفي المنطقة العربية، تتشابك التقاليد والأعراف المجتمعية مع أزمات اقتصادية وسياسية، لتُنتج مزيجًا معقدًا من العنف الموجه بشكل رئيسي ضد النساء والفتيات، غالبًا في صمت وخلف الأبواب المغلقة.
يتخذ العنف القائم على النوع الاجتماعي أشكالًا متنوعة تتجاوز حدود الأذى الجسدي لتصل إلى النيل من كرامة الضحايا وحريتهم وأمنهم الاقتصادي والاجتماعي، ومنها العنف الجسدي كالضرب والحرق والتشويه، والعنف الجنسي ويشمل الاغتصاب، والتحرش الجنسي، وختان الإناث، والزواج القسري والمبكر، والعنف النفسي أو العاطفي ويشمل الإهانة، التهديد، العزل الاجتماعي، والتحكم، والعنف الاقتصادي مثل منع المرأة من العمل، أو الاستيلاء على دخلها، والعنف الرقمي: كالتشهير عبر الإنترنت، والابتزاز، وانتهاك الخصوصية.
تؤكد المنظمات الأممية والحقوقية أن هذه الأنماط ليست منفصلة، بل غالبًا ما تتداخل، لتخلق دوائر معقدة من المعاناة يصعب كسرها دون تدخل جاد.
مؤشرات مقلقة
على الرغم من محدودية البيانات الرسمية في العديد من الدول العربية نتيجة الحساسية الاجتماعية والقيود المؤسسية، فإن الأرقام المتاحة تعكس حجم الأزمة: ففي قضية عنف الشريك الحميم بينت دراسات محلية، تعرض نحو ربع النساء المصريات للعنف الجسدي على يد الشريك، فيما بلغت النسبة في الأردن قرابة 19% عام 2018، وحول العنف الرقمي فإن ثلث الشابات الفلسطينيات أفدن بتعرضهن للتحرش عبر الإنترنت، بحسب الباروميتر العربي.
وفي دول مثل سوريا واليمن والسودان، ترتفع معدلات الزواج القسري والاتجار والاستغلال الجنسي، وهو ما أكدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تقاريرها الأخيرة.
هذه الأرقام ليست سوى غيض من فيض، إذ إن آلاف الحالات لا تصل أصلًا إلى مرحلة التوثيق بفعل الصمت والخوف.
تجارب عربية واعدة في الإصلاح التشريعي
رغم التحديات الكبيرة، شهدت بعض الدول العربية خطوات مهمة خلال السنوات الأخيرة لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر إصلاحات تشريعية واستراتيجيات وطنية، ففي تونس، تم اعتماد القانون الأساسي عدد 58 لعام 2017، الذي يُعد من القوانين الأكثر شمولًا في المنطقة، إذ يجرّم جميع أشكال العنف ضد النساء ويوفر آليات حماية ودعم للناجيات، أما في لبنان، فقد عُدّل القانون رقم 293 في عام 2020 لإلغاء بعض الثغرات القانونية وتعزيز حماية النساء من العنف الأسري، وإن كان لا يزال بحاجة إلى مزيد من التطوير ليشمل العنف خارج نطاق الأسرة، وفي المغرب، دخل القانون 103-13 حيز التنفيذ عام 2018، مجرّمًا العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، ومُقرًّا بإجراءات جديدة مثل إنشاء وحدات لاستقبال ضحايا العنف في المحاكم والمستشفيات، وهذه الإصلاحات، رغم كونها غير مكتملة بعد، تُعدّ مؤشرات على نمو الوعي بأهمية توفير بيئة قانونية أكثر عدالة وأمانًا للنساء.
دور وسائل الإعلام والتواصل
يؤدي الإعلام التقليدي ووسائل التواصل الاجتماعي دورًا مزدوجًا في ملف العنف القائم على النوع الاجتماعي، من جهة، أسهمت الحملات الإعلامية والبرامج التوعوية في رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر العنف وأهمية الإبلاغ عنه، وساعدت في كسر حاجز الصمت، كما ساعدت مواقع التواصل في منح مساحة للضحايا والناشطين للتعبير ومشاركة القصص، لكن في المقابل، لا يزال الإعلام في كثير من الأحيان يُعيد إنتاج الصور النمطية التي تُعزز التمييز ضد النساء، عبر محتوى يُظهِر النساء في أدوار هامشية أو يبرر العنف ضدهن، كذلك تنتشر على منصات التواصل مظاهر خطاب الكراهية والتنمر والتحريض، مما يزيد من معاناة الضحايا ويثني بعضهن عن الإفصاح والتبليغ، من هنا، تُصبح مسؤولية الإعلام مضاعفة ممثلة في الموازنة بين حرية التعبير ودوره في نشر ثقافة احترام حقوق الإنسان.
فاتورة العنف.. خسائر اقتصادية تتجاوز الأفراد
لا يقتصر أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على معاناة الضحايا نفسيًا وجسديًا فحسب، بل يمتد ليكبد المجتمعات خسائر اقتصادية باهظة، حيث تقدر الأمم المتحدة أن التكلفة العالمية للعنف ضد النساء قد تصل إلى نحو 1.5 تريليون دولار سنويًا نتيجة انخفاض الإنتاجية، وتكاليف الرعاية الصحية، والدعم القانوني والاجتماعي، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية طويلة الأمد الناتجة عن فقدان فرص التعليم والعمل، وفي العالم العربي، حيث ترتفع معدلات البطالة بين النساء أصلًا، يؤدي العنف إلى تعطيل مساهمتهن الاقتصادية، ويعمّق الفجوة في التنمية، وهذا البُعد الاقتصادي يعكس بوضوح أن مكافحة العنف ليست مجرد التزام أخلاقي أو إنساني، بل استثمار ضروري لمستقبل أكثر عدلاً واستقرارًا وازدهارًا.
حواجز تعرقل الوصول للعدالة
رغم الاعتراف الدولي بأن حماية الناجيات أولوية حقوقية وإنسانية، فإن الواقع في كثير من الدول العربية يشير إلى تحديات كبرى منها:
الخوف من الوصمة الاجتماعية حيث تجبر الخشية من العار والنبذ الكثيرات على الصمت.
ثغرات تشريعية ممثلة في وجود قوانين غير مكتملة أو غير مفعّلة بالشكل الكافي، حتى في بعض الدول التي ألغت قوانين مثل "زواج المغتصب من ضحيته"، لا يزال التطبيق العملي قاصرًا.
ضعف آليات الحماية ممثلاً في نقص في مراكز الإيواء والدعم النفسي والقانوني، إضافةً إلى تعقيد إجراءات الإبلاغ.
الضغوط الاقتصادية حيث تعد تكلفة الإجراءات القضائية المرتفعة عائقًا هائلًا أمام الضحايا.
الأزمات الإنسانية: في مناطق النزاعات، تزداد صعوبة الوصول للعدالة مع انهيار أنظمة الدولة وانتشار الفوضى.
محاولات لتغيير المشهد
في مواجهة هذه التحديات، ظهرت مبادرات رسمية وأهلية تسعى لإحداث فرق حقيقي من خلال إعداد وتطوير قوانين جديدة في بعض الدول لتجريم كل أشكال العنف، وإنشاء مراكز دعم متخصصة للناجيات تقدم المشورة النفسية والقانونية والطبية، مع تنفيذ حملات توعية لتغيير المواقف الاجتماعية وتشجيع الضحايا على الإبلاغ، وكذلك وضع برامج تدريب تستهدف رجال الشرطة والقضاة لتعزيز استجابتهم لقضايا العنف، إضافة إلى عمل شراكات بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتطوير بيانات دقيقة تساعد في صياغة سياسات أفضل، ورغم أن هذه الجهود مهمة، فإنها لا تزال متفرقة، وتحتاج إلى إرادة سياسية قوية واستدامة مالية لضمان فاعليتها.
العنف القائم على النوع الاجتماعي في سياق عالمي
على الصعيد العالمي، تعترف الأمم المتحدة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي كعائق رئيسي أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتقدّر منظمة الصحة العالمية أن واحدة من كل ثلاث نساء حول العالم تتعرض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، وهو ما يترك آثارًا نفسية وجسدية واقتصادية عميقة.
وقد أطلق المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان بالدول العربية حملة تحت عنوان (#ليس_أمراً_طبيعياً)، بهدف التصدي لخطر اعتبار العنف القائم على النوع الاجتماعي أمراً طبيعياً، ويشمل ذلك العنف الجنسي والممارسات الضارة، وخاصة أثناء الحالات الإنسانية.
تاريخيًا، أسهمت الحركات النسوية والمنظمات الحقوقية في فضح هذه الانتهاكات، وتقديمها كقضية عامة وليست شأناً خاصًا بالأسرة، ومع ذلك، لا تزال مجتمعات كثيرة تنظر لهذا العنف باعتباره "شأنًا عائليًا"، ما يعقد مكافحته.
توصيات منظمات دولية
وقدمت المنظمات الأممية مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) توصيات واضحة لمواجهة هذه الظاهرة منها تطوير قوانين وطنية شاملة وتنفيذها بفعالية، وتوفير مراكز إيواء وخدمات متكاملة للناجيات، وتدريب العاملين في منظومة العدالة والصحة والتعليم، وجمع بيانات مصنفة بشكل دوري حول حالات العنف، إضافة إلى إشراك الرجال والفتيان في حملات التوعية لتغيير المفاهيم الذكورية الضارة.
وفي الختام، يظل العنف القائم على النوع الاجتماعي تحديًا معقدًا ومتجذرًا في البنى الاجتماعية والثقافية، لكن كسره يبدأ بالاعتراف به كجريمة لا كسلوك اجتماعي "مقبول"، إن إنصاف الضحايا لا يُعيد لهن ما فقدنه من أمان وصحة نفسية فحسب، بل هو خطوة أساسية نحو مجتمعات عادلة ومستقرة.
المسار طويل وشاق، لكن الإرادة السياسية، والعمل الجماعي، والتعليم، وتمكين النساء، كفيلة بتحويل هذا الملف من "وباء صامت" إلى قصة نجاح تُكتب لصالح العدالة والكرامة الإنسانية.