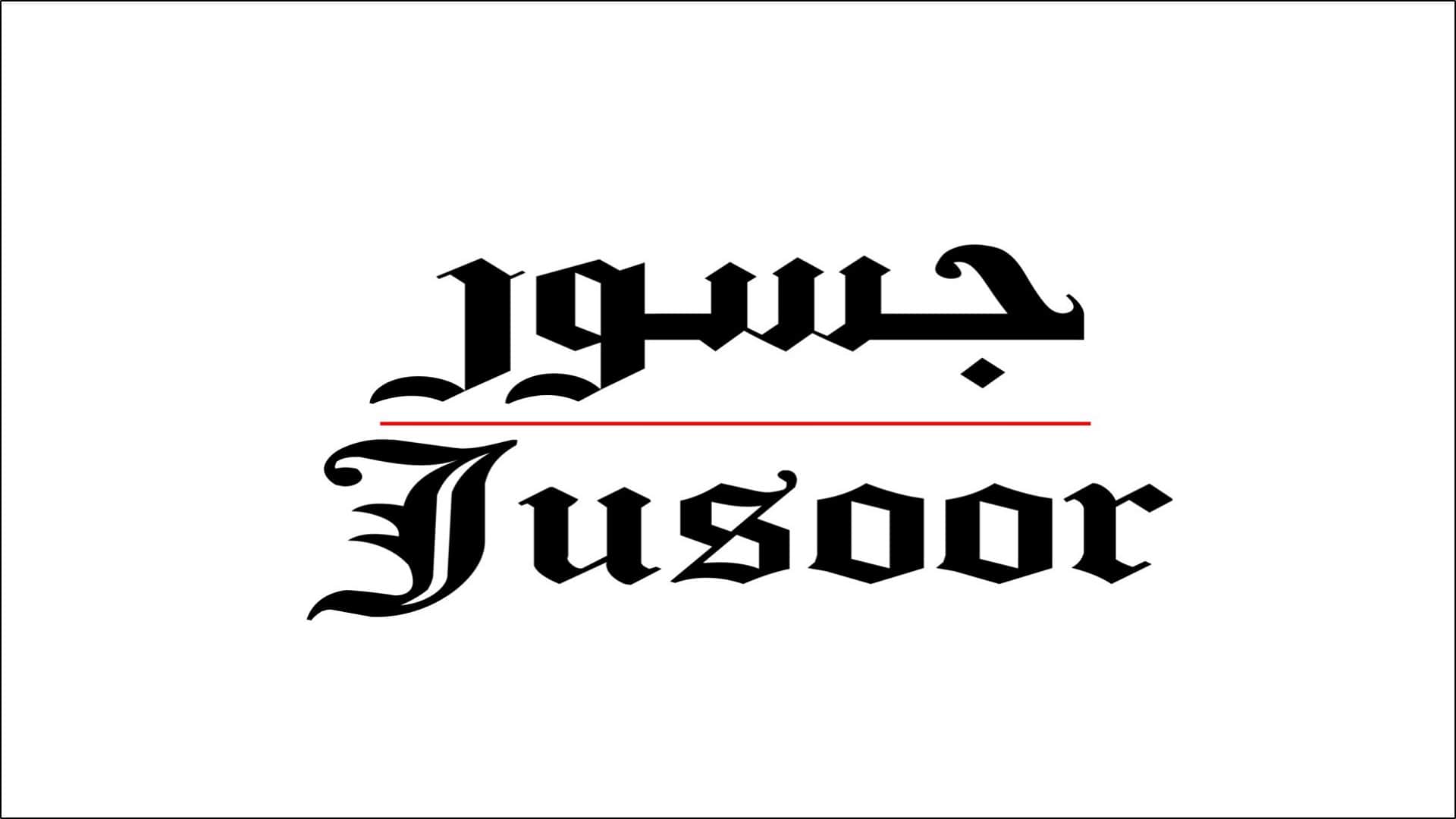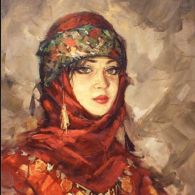علاج الأمراض النفسية بالعالم العربي يصطدم بغياب الوعي والخوف من الوصم الاجتماعي
علاج الأمراض النفسية بالعالم العربي يصطدم بغياب الوعي والخوف من الوصم الاجتماعي
تظل الصحة النفسية في العالم العربي موضوعًا حساسًا يكتنفه الصمت والوصمة الاجتماعية، ما يضع الأفراد الذين يعانون اضطرابات نفسية في مواجهة تحديات جسيمة دون دعم كافٍ.
وتتجلى هذه الوصمة في نظرة المجتمع إلى المرضى النفسيين على أنهم ضعفاء أو غير قادرين على مواجهة متطلبات الحياة، ما يدفع الكثيرين إلى إخفاء معاناتهم وتجنب طلب المساعدة خوفًا من التمييز أو العزلة. هذا التصور المغلوط يعزز مشاعر الخجل والعزلة لدى الأفراد المصابين، ويدفعهم إلى التعامل مع معاناتهم بصمت، ما يزيد من تفاقم حالتهم.
ولا تقتصر هذه الظاهرة على الأفراد فقط، بل تمتد لتشمل عائلاتهم، ما يزيد من تعقيد المشكلة ويؤدي إلى مزيد من التهميش والعزلة.
وتشير الإحصاءات إلى انتشار مقلق للاضطرابات النفسية في المنطقة، ففي لبنان على سبيل المثال، أشارت الدراسات إلى أن 17% من السكان يعانون اضطرابات نفسية تراوح بين القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، وهي معدلات تفاقمت بفعل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها البلاد.
نقص الوعي والمعرفة
بالإضافة إلى الوصمة الاجتماعية، يواجه العالم العربي نقصًا ملحوظًا في الوعي والمعرفة حول الصحة النفسية. كثير من الأفراد يجهلون ماهية الاضطرابات النفسية وأعراضها، ولا يعرفون كيفية الوصول إلى الخدمات المتخصصة.
ورغم هذه الأرقام المرتفعة، فلا يزال الوعي العام منخفضًا، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج. تشير بعض الدراسات إلى أن أكثر من 60% من المرضى النفسيين في العالم العربي لا يسعون إلى العلاج بسبب الجهل بطبيعة الاضطراب أو بسبب الخوف من نظرة المجتمع لهم، ويؤدي هذا إلى استمرار المعاناة النفسية لسنوات طويلة دون تدخل علاجي.
وتلعب العوامل الثقافية والدينية دورًا مهمًا في تشكيل التصورات حول الصحة النفسية. في بعض المجتمعات العربية، يُعتقد أن المشكلات النفسية ناتجة عن ضعف الإيمان أو تقصير ديني، ما يزيد من حدة الوصمة المرتبطة بهذه الاضطرابات، وهذا الاعتقاد يثني الأفراد عن البحث عن المساعدة المهنية، ويدفعهم إلى اللجوء إلى الحلول التقليدية أو الروحية فقط، دون الاستفادة من العلاجات النفسية الحديثة، كما أن اللجوء إلى الشعوذة أو العلاجات غير العلمية في بعض المجتمعات يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للمرضى بدلاً من مساعدتهم.
ويُعَد نقص الخدمات النفسية المتخصصة وتوزيعها غير المتكافئ من التحديات البارزة في العالم العربي. في دول عدة، تتركز الخدمات النفسية في المدن الكبرى، ما يجعل الوصول إليها صعبًا لسكان المناطق الريفية أو النائية، بالإضافة إلى ذلك، قد تكون تكلفة العلاج مرتفعة، والتأمين الصحي لا يغطي دائمًا هذه الخدمات، ما يزيد من صعوبة الحصول على الرعاية اللازمة.
وفي دول مثل العراق وسوريا واليمن، حيث تعاني البنية التحتية الصحية أزمات متفاقمة، يكاد يكون الوصول إلى خدمات الصحة النفسية شبه مستحيل، ما يجعل التداعيات النفسية للحروب والنزاعات تتضاعف دون تدخل حقيقي.
تأثير العوامل الاجتماعية والاقتصادية
تؤثر العوامل الاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير في الصحة النفسية للأفراد. البطالة، الفقر، النزاعات المسلحة، والضغوط الحياتية اليومية تزيد من معدلات القلق والاكتئاب، ففي المجتمعات التي تعاني صراعات أو ظروفًا اقتصادية صعبة، يكون الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات النفسية، مع قلة الموارد المتاحة للعلاج والدعم.
كما أن الهجرة واللجوء القسري بسبب الحروب تزيد من معدلات الاضطرابات النفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة، وهو ما أكدته تقارير الأمم المتحدة التي أشارت إلى أن 35% من اللاجئين السوريين يعانون مشكلات نفسية خطِرة.
وتستدعي هذه الأمور ضرورة أن تسن الحكومات قوانين وسياسات تدعم الصحة النفسية وتدمجها في الخطط الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لدعم تطوير برامج الصحة النفسية، ويمكن للقطاع الخاص أن يلعب دورًا محوريًا في تمويل المشاريع الصحية النفسية، وتوفير برامج دعم داخل بيئات العمل لتقليل الضغط النفسي على الموظفين.
التحديات النفسية بالمجتمعات العربية
أكد استشاري الصحة النفسية، الدكتور علاء الغندور، أن أحد أكبر الأمراض التي تؤثر في المجتمعات العربية هو "الجهل" وعادات وتقاليد بالية قديمة استمرت قرونًا عدة، ما ينعكس سلباً على الصحة النفسية للأفراد.
وأشار الغندور، في تصريحات لـ"جسور بوست"، إلى أن هذه العادات، مثل ما يُطلب من العروس في بعض المجتمعات أن تقدم "المنديل الأبيض" دليلًا على بكارتها في صباح اليوم الأول من زواجها، هي نماذج لثقافة اجتماعية تفرز آثارًا نفسية مدمرة على الفتاة، هذه التقاليد ما هي إلا وسيلة اجتماعية تراقب سلوك الأفراد بشكل يؤدي إلى تدمير نفسياتهم، بل قد تشكّل عبئًا اجتماعيًا يؤدي إلى مشكلات نفسية خطِرة، خاصة في المجتمعات التي تفتقر إلى الوعي الكافي.
وتابع، أنه من الواضح أن هذا النوع من الممارسات الاجتماعية ينتشر في المجتمعات التي تفتقر إلى الفهم الواعي لمفهوم الصحة النفسية، حيث إن الأمور الحياتية مثل التربية والعلاقات الأسرية تتأثر بشكل كبير بالعادات المتوارثة دون النظر إلى تأثيرها في نفسية الأفراد، وأكد أن عدم وجود الوعي في مناطق معينة يجعل الناس عاجزين عن مواجهة المجتمع ومشكلاته، خاصة عندما يتعلق الأمر بتربية الأطفال.
وأشار الغندور إلى أن المجتمعات الغربية، مثل المجتمع الأمريكي، تختلف تمامًا في طريقة تربية الأطفال، حيث يتم تعليم الأطفال منذ الصغر كيفية التعامل مع المواقف الحياتية، مثل قول "لا" و"نعم"، ومعرفة متى يجب قول كل منهما ولماذا، ولفت إلى أن هذه الفجوة الثقافية بين المجتمعات العربية والغربية تؤدي دورًا كبيرًا في تكوين شخصية الطفل وكيفية تفاعله مع المجتمع في المستقبل.
وأضاف: "في الماضي، كانت الأمهات في المجتمعات العربية تربي أطفالهن بالفطرة، لكن اليوم، ومع تقدم التعليم، نجد أن العديد من الأمهات لا يمتلكن الأدوات اللازمة لتربية الأطفال بشكل سليم، نظرًا لغياب التأهيل النفسي والتربوي المناسب"، وعدّ 99% من الشعوب العربية يعانون اضطرابات نفسية بسبب سوء التربية والعنف الأسري والتفكك الاجتماعي.
وركز الغندور في حديثه على الفرق بين الأمراض النفسية والعقلية، مؤكدًا أن المرض العقلي يتسبب في تلف خلايا الدماغ مثل مرض البرانويا والشيزوفرينيا، في حين أن الأمراض النفسية تنشأ بسبب صدمات عصبية أو حياتية مثل اكتئاب الحمل أو اكتئاب ما بعد الولادة نتيجة التعرض للعنف أو التحرش. وأوضح أن هناك نقصًا في الوعي المجتمعي حول هذا التفريق، وأنه يجب التوضيح بشكل أكبر للجمهور كيف أن الأمراض النفسية لا تعد جنونًا، بل هي حالات صحية يمكن علاجها مثل الأمراض العضوية.
وأشار إلى أنه يجب أن يؤمن المجتمع العربي بأن العلاج النفسي أمر طبيعي مثل العلاج البدني تمامًا، وأنه يجب أن تكون هناك آليات واضحة للتعامل مع هذه القضايا.
وشدد الغندور على ضرورة زيادة الوعي الثقافي والديني بين الأفراد للتعامل مع هذه القضايا، مع التركيز على أهمية إفهام الأفراد أن المال هو "أضعف أنواع الرزق"، وأن على الناس تقدير نعم الله التي ينعمون بها، وتعلم كيفية تقبل الآخرين دون النظر إلى مستوى دخلهم أو وضعهم المالي. كما أكد ضرورة أن تضع الدول العربية آليات عملية وواقعية للتعامل مع هذه القضايا وتوفير الدعم النفسي المطلوب للأفراد في مراحل حياتهم المختلفة.
غياب الوعي يشلّ التعافي
حذّر أستاذ كشف الجريمة في مركز البحوث الجنائية والاجتماعية، فتحي قناوي، من تصاعد الأزمات النفسية في المجتمعات العربية، مؤكدًا أن الوعي بكيفية التعامل مع المرض النفسي ما يزال غائبًا رغم انتشاره المتزايد، وموضحًا أن الأمر لم يعد يقتصر على الحالات المزمنة فحسب، بل يشمل أيضًا اضطرابات وأزمات مؤقتة لا يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة.
وشدد قناوي، في تصريحات لـ"جسور بوست"، على أن المرض النفسي ليس وصمة، بل هو حالة إنسانية يمكن إدارتها وعلاجها إذا ما توفر الفهم الصحيح والدعم المناسب.
وأضاف أن النظرة الاجتماعية التقليدية في العالم العربي ما زالت تفتقر إلى الفهم العميق لطبيعة الاضطرابات النفسية، "الإنسان العربي له تركيبته الخاصة، حيث تتضخم الأنا بشكل قد يؤثر في تكوين الشخصية"، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الأفراد يرفضون مبدأ المشاركة أو تقبل الرأي الآخر، وينطلقون من تصور متضخم عن الذات: "أنا الريس، أنا الملك"، وهو ما يُضعف العمل الجماعي ويحول دون بناء بيئة تعاونية صحية.
وأشار إلى أن بعض الاضطرابات النفسية الشائعة في المجتمعات العربية تأخذ أشكالًا اجتماعية معقدة، مثل التبعية والتعالي، إذ يعيش كثيرون تحت وهم التفوق على الآخرين، وهذا في جوهره يُعد خللًا نفسيًا واجتماعيًا يُنتج أنماطًا من السلوك المتسلط، ويغذي التنافر بين أفراد المجتمع. وأكد أن الشخصية المريضة لا تتوقف عند ذاتها، بل تزرع سمومها في محيطها، مؤثرة في الأسرة والمجتمع معًا، فالعلاقات تصبح مشوّهة، والقرار مشلول، والتفاعل الإنساني هش، تتخلله الانفعالات السامة بدلًا من التفهم والتراحم.
وانتقد أستاذ الجريمة تعاطف البعض مع الجناة والمجرمين، مؤكدًا أن هذه الظاهرة بحد ذاتها مؤشر على اختلالات نفسية تحتاج إلى معالجة مجتمعية وأخلاقية. كما دعا إلى ضرورة تبني ميثاق إعلامي وأخلاقي واضح في تغطية أخبار الجريمة، بحيث لا تُعرض التفاصيل بشكل قد يحفّز آخرين على تقليدها، مضيفًا: "علينا أن ندرك أن الجرائم معدية اجتماعيًا، وتكرار عرضها بدون معالجة قد يسهم في إنتاج موجات جديدة من العنف والانحراف".
وفيما يتعلق بعلاج هذه الأزمات، شدد قناوي، على أهمية التفرقة بين الحالة المؤقتة والمرض المزمن، وعلى ضرورة فهم جذور المشكلة النفسية بدلًا من الاكتفاء بتصنيفات سطحية. وتساءل مستنكرًا: “كيف نعالج المريض النفسي إن لم نمتلك أدوات الفهم؟ كيف نساعده إن كنا نعده عبئًا أو خطرًا؟”. وأوضح أن غياب البنية العلاجية المناسبة، من عيادات متخصصة وكوادر مؤهلة، يؤدي إلى تراكم الأزمات، مشيرًا إلى أن العيادات النفسية في كثير من الدول العربية لا تزال نادرة ومحدودة، في حين أن الدول المتقدمة توفرها في كل حي وشارع تقريبًا.
وفي ختام حديثه، أكد أهمية كسر حاجز الصمت والخجل المرتبط باللجوء إلى الأطباء النفسيين، داعيًا الآباء والأمهات إلى عدم التردد في استشارة المختصين عند ملاحظة اضطرابات نفسية لدى أبنائهم.