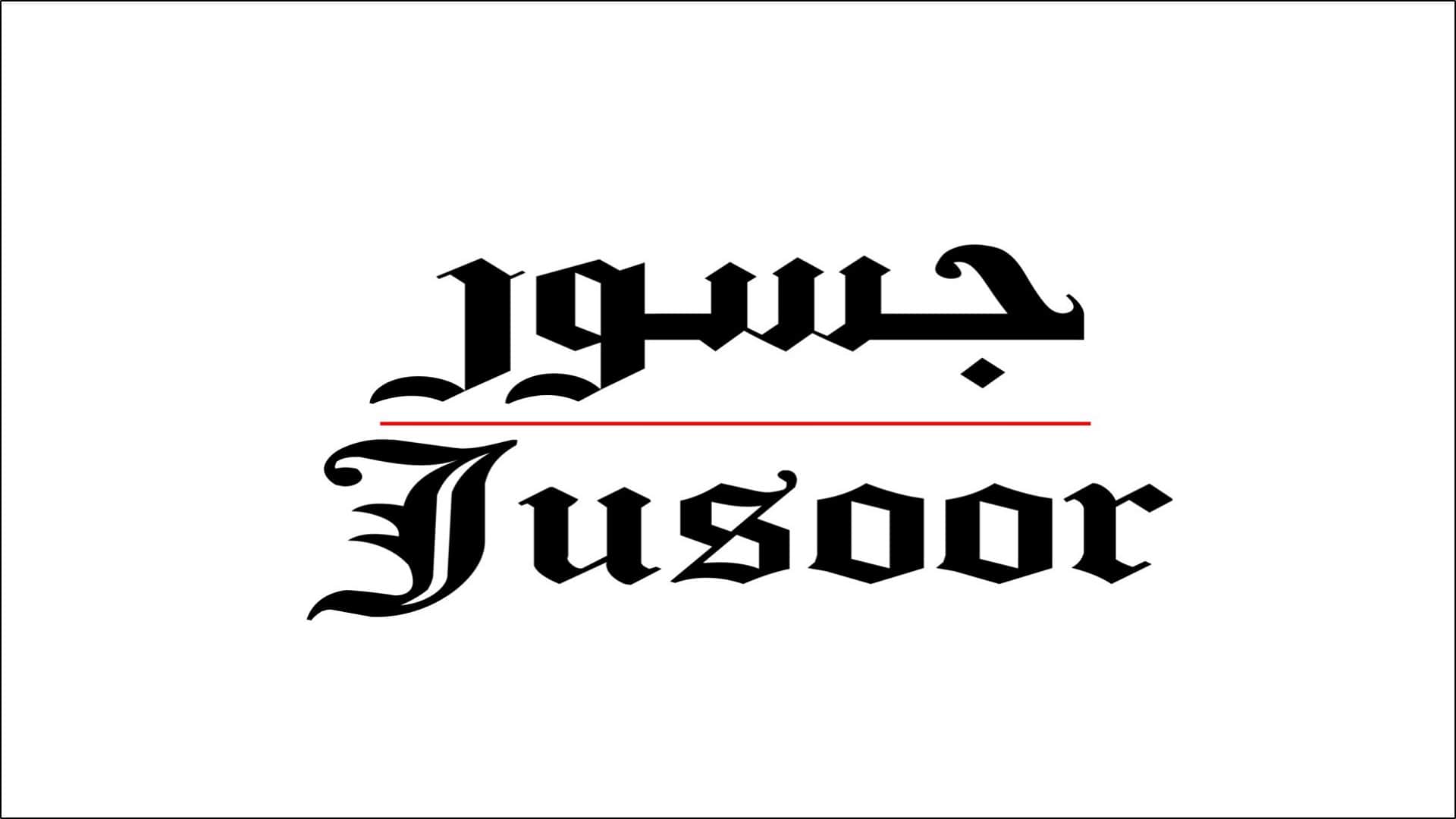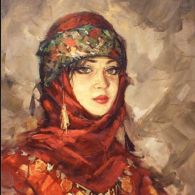فجرتها قضية زينب ياسين.. أزمة الحجاب على شاشة الدولة اللبنانية تثير الجدل
فجرتها قضية زينب ياسين.. أزمة الحجاب على شاشة الدولة اللبنانية تثير الجدل
يواجه لبنان اليوم تحديًا جديدًا يكشف عن هشاشة التعايش والتزاماته الرسمية بشعارات التعددية، فقضية الإعلامية زينب ياسين التي استقالت من منصبها في تلفزيون لبنان بسبب منعها من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها الحجاب، تسلط الضوء على التمييز الممنهج والممارسات التمييزية المتغلغلة في المؤسسات الإعلامية الرسمية، وهذه الحادثة ليست مجرد استقالة، بل هي رمز للهوة بين القيم الدستورية والممارسات الواقعية التي تحدد من يمكن أن يكون له صوت في الفضاء العام.
ومن خلال منع ياسين من الظهور على الشاشة، تبرز مشكلة عميقة في الإعلام الرسمي اللبناني. يعد الحجاب، في هذه الحالة، عنصراً من عناصر الهوية الشخصية والدينية، التي ترفض بعض المؤسسات القبول بها في فضاء يعدونه "مهنيًا"، فالحجاب، الذي يعكس خيارًا دينيًا شخصيًا، أصبح في هذا السياق قضية خلافية، وأداة للتأكيد على عدم القبول بالهوية الدينية التي تختلف عن المعايير المعتمدة من قبل السلطة الإعلامية.
ولم يكن الحياد البصري الذي يروج له التلفزيون الوطني في يوم من الأيام قاعدة قانونية، بل كان مجرد عرفٍ غير مكتوب، يمس الحق في التعبير والتنوع.
أرقام لا تكذب
يكشف تقرير لجنة دعم الصحفيين لعام 2024 حقيقة مريرة حول التمييز الموجه ضد الإعلاميات المحجبات في لبنان. إذ تشير الإحصاءات إلى أن 28% من الإعلاميات المحجبات واجهن تمييزًا مهنياً بشكل مباشر أو غير مباشر، بما في ذلك تقييد أدوارهن المهنية ومنعهن من الظهور على الشاشات، وتكشف هذه الأرقام عن بنية مؤسسية متحيزة، تعزز من تهميش جزء كبير من الإعلاميات اللواتي يشكلن جزءًا كبيرًا من المجتمع اللبناني.
استقالة ياسين لم تكن مجرد خطوة فردية للابتعاد عن العمل، بل هي دعوة إلى تفكير أعمق حول حق الإنسان في أن يعبر عن هويته دون الخوف من التمييز أو الاستبعاد، وأشارت في رسالتها، إلى أن المؤسسة التي عملت فيها لم تكن "وطنية لجميع موظفيها، بل لأولئك الذين لا يرتدون الحجاب"، وكان لتعبيرها البسيط دلالة عميقة، إذ وصف الوضع الذي تعانيه الإعلاميات المحجبات، والذي يُظهر أن "الوطنية" في بعض المؤسسات تعتمد على معايير الشكل والمظهر لا على القيم الإنسانية.
ولم تكن قضية زينب ياسين هي الوحيدة؛ فالإعلامية ندى الحوت، التي عملت في تلفزيون لبنان لأكثر من عشرين عامًا، واجهت المصير ذاته بعد أن قررت ارتداء الحجاب. تم سحبها من تقديم البرامج، وأُبعدت عن الشاشة، وتكررت هذه الممارسات بشكل صريح في مؤسسات إعلامية يفترض أن تعكس التنوع الاجتماعي والديني، ولكنها في الواقع تعكس صورة أحادية تسهم في تهميش الاختلاف.
قانون في مواجهة تقاليد مؤسسية
المشكلة الأعمق التي تكشفها هذه الحوادث تتعلق بعدم وجود سياسات قانونية واضحة تحمي التنوع في الإعلام اللبناني. عدم وجود آليات قانونية لحماية الحقوق الدينية والشخصية للإعلاميين يجعل من أي خلاف يُحل في كواليس الإدارة بعيدًا عن المساءلة القانونية، وأصبح الحديث عن الحرية في لبنان حديثًا معلقًا بين أيدي القوانين البيروقراطية التي لا تحترم التنوع.
وبدأ العديد من النواب والمنظمات الحقوقية تحركًا فعّالًا لمحاربة هذه الممارسات. النائبة عناية عز الدين دعت إلى تحقيق شفاف، في حين أكدت لجنة دعم الصحافيين أن ما حدث ليس حادثة فردية بل هو جزء من تحدٍ مؤسساتي يواجه النساء في الإعلام اللبناني، لتكون الحرية مضمونة، يجب أن تتغير السياسات الإعلامية في لبنان لتشمل قوانين تحمي التنوع وتعترف به.
اعتداء على الحريات
عبّرت الناشطة النسوية والصحفية اللبنانية مريم ياغي، عن رفضها القاطع لقرار منع إعلامية لبنانية من الظهور على الشاشة بسبب ارتدائها الحجاب، معدةً هذا القرار لا يُشكّل فقط خرقًا للدستور اللبناني، بل يمثل انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية والمواثيق التي التزم بها لبنان في إطار حقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت ياغي، في تصريحات لـ"جسور بوست"، على أن مقدمة الدستور اللبناني تنصّ بوضوح على احترام الحريات العامة وحرية الرأي والمعتقد، وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية دون قيد أو تمييز، وبالتالي فإن منع امرأة من ممارسة مهنتها بسبب ارتدائها رمزًا دينيًا يُعدّ تعارضًا مباشرًا مع هذه المبادئ الدستورية.
وأوضحت أن المادة 18 من العهد الدولي تكفل حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده في العبادة والممارسة والتعليم والمظهر، في حين تضمن المادة 19 حرية التعبير وتبادل ونقل المعلومات، مشددة على أن الحجاب هو ممارسة دينية لا تؤثر في مهنية الإعلامية، بل يُعد جزءًا من حريتها الشخصية.
وعدّت تبرير القناة المعنية بمنع ظهور الرموز الدينية بحجة الحيادية هو في حقيقته تلاعب لغوي ومفاهيمي بمفهوم الحياد الإعلامي، فالحياد لا يُقاس بالمظهر الخارجي للعاملين في الوسائل الإعلامية، بل بمضمون التغطية الإخبارية ومدى التزامها بالمهنية والموضوعية. وأضافت أن منع الحجاب لا يعكس حيادية، بل يُمثّل طمسًا للهويات الفردية وفرضًا لنموذج ثقافي أحادي، وهو ما يناقض تمامًا جوهر الديمقراطية والتعددية التي يفترض أن تحترم التنوّع الديني والثقافي للمجتمع اللبناني.
وأكدت مريم أن لبنان، بتاريخه وتكوينه الطائفي الغني، لا يمكن أن يُختزل في سياسة إقصائية تمارسها بعض المؤسسات، مشيرة إلى أن التنوّع الديني جزء لا يتجزأ من هوية البلد. واستشهدت بحضور الرموز المسيحية بشكل علني في المناسبات والأعياد على الشاشات اللبنانية، حيث لم يُعد ارتداء الصليب أو رسمه على الجباه سلوكًا يمس المهنية. وتساءلت: إذا كانت هذه المؤسسة تعد نفسها حيادية وتمنع الرموز الدينية، فلماذا يُسمح بهذه المظاهر في مناسبات معينة دون اعتراض؟ ولماذا يُستثنى الحجاب من هذا التسامح؟
وشدّدت على أن ما جرى مع الإعلامية زينب ليس استثناءً، بل تكرار لنمط إقصائي مارسته المؤسسة نفسها مع الإعلامية ندى الحوت، التي اضطرت لتقديم استقالتها بعد وقف برنامجها الاقتصادي، فقط لأنها قررت ارتداء الحجاب.
ورأت أن استخدام المؤسسة لتبريرات واهية من قبيل أن زينب تثير البلبلة الإعلامية مجرد عذر أقبح من ذنب، يُخفي في طيّاته تمييزًا صارخًا ضد النساء المحجبات، وينتهك مبدأ المساواة في الحقوق، بما في ذلك حق الظهور على الشاشة كإعلامية محترفة، مثلها مثل زملائها من الرجال.
وذهبت مريم إلى أبعد من ذلك، معدة هذا التمييز ليس محصورًا في الحقل الإعلامي، بل هو ممارسة متجذّرة في مؤسسات الدولة نفسها، مستشهدة بإجبار النساء في بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية على خلع الحجاب كشرط للالتحاق بالعمل. وأكدت أن السياسات التي تستند إلى معايير تتعارض مع الاتفاقات الدولية لا يمكن اعتبارها مقدّسة أو غير قابلة للتعديل، بل يجب أن تُراجع وتُصلح بما يتماشى مع حقوق الإنسان ومع الدستور اللبناني الذي يُعلي من شأن الحريات الفردية والدينية.
واختتمت تصريحها بدعوة وزارة الإعلام وإدارة تلفزيون لبنان إلى مراجعة سياساتها الداخلية، وتعديلها بما ينسجم والتزامات لبنان الدولية، وبما يضمن حق الجميع، رجالًا ونساءً، محجبات وغير محجبات، في العمل والمشاركة في الحياة العامة دون تمييز. وأكدت أن احترام التنوع والتعددية لا يمكن أن يكون شعارات مرفوعة فقط، بل يجب أن تُترجم إلى ممارسات يومية تحترم الكرامة الإنسانية وتصون الحريات الأساسية.
الحجاب حق دستوري
من جانبه، قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي والخبير بالشؤون الدستورية، إن أي قرار تتخذه مؤسسة -إعلامية كانت أو غيرها- يقيّد حرية الأفراد في إظهار معتقداتهم الدينية، مثل فرض خلع الحجاب أو منع ارتداء رموز دينية، يُعد من حيث المبدأ خرقاً واضحاً للدستور اللبناني، وانتهاكاً لمنظومة قانونية ودولية متكاملة تضمن حرية العقيدة والممارسة الدينية بشكل صريح وغير قابل للتقييد إلا في أضيق الحدود.
وتابع السعداوي، في تصريحات لـ"جسور بوست"، المادة التاسعة من الدستور اللبناني تُعدّ حجر الأساس في حماية حرية المعتقد، حيث تنص بوضوح على أن "حرية الاعتقاد مطلقة"، وأنه يجب على الدولة كفالة حرية إقامة الشعائر الدينية، شريطة ألا تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام.
وبيّن أن هذا النص الدستوري لا يضمن فقط الحياد السلبي للدولة، أي عدم تدخلها في الخيارات الدينية للأفراد، بل يفرض كذلك الحياد الإيجابي، الذي يوجب على الدولة أن تحمي هذه الخيارات وتوفر لها المناخ القانوني الآمن لممارستها.
وشدد السعداوي على أن الدستور اللبناني لم يأتِ منفصلاً عن السياق الدولي، بل جاء منسجماً مع مجموعة من المواثيق والاتفاقات التي أقرّها المشرّع اللبناني، وأصبحت ملزمة له قانوناً، وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق العربي لحقوق الإنسان، إضافة إلى الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والإعلان الدولي للقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، الصادر عن الأمم المتحدة في 5 نوفمبر 1981، وهي اتفاقات كرّست جميعها حق الإنسان في إظهار دينه أو معتقده.
وأضاف أن السياسة التشريعية التي تبناها لبنان عبر دستوره وقوانينه تعكس أعلى درجات الحياد الديني، وتمنع الدولة من تقديم دين على آخر، أو تقييد شعائر دينية دون مبرر مرتبط بالإخلال الفعلي بالنظام العام. وأوضح أن منع الأفراد من ارتداء الحجاب، أو ممارسة مظاهر دينية معينة، يتناقض مع الفهم الموسع الذي تبناه الدستور اللبناني لمفهوم حرية المعتقد، والذي لم يقتصر على القناعة الفكرية، بل شمل أيضًا الجانب المظهري للشعائر الدينية كجزء لا يتجزأ من حرية العقيدة.
وأشار إلى أن حرية الإنسان في إظهار إيمانه علناً لا يجوز تقييدها إلا بضوابط شديدة الدقة، أبرزها عدم التحريض على الكراهية أو إثارة النعرات الطائفية أو تحقير شعائر دينية أخرى، وهو ما يدخل تحت إطار "النظام العام" بالمفهوم الضيق لا الواسع. وبالتالي، فإن قيام المؤسسات الإعلامية أو غيرها بفرض حظر على الرموز أو المظاهر الدينية -ما لم يكن هناك مساس فعلي بالنظام العام- يُعد تجاوزاً خطِراً للصلاحيات، ومساساً بالحقوق الدستورية.
وختم الدكتور السعداوي حديثه بالتأكيد على أن حرية المعتقد ليست مسألة إدارية أو تنظيمية يمكن أن تخضع لاجتهادات المؤسسات أو مصالحها، بل هي حق دستوري وإنساني أصيل يعلو على التنظيمات الداخلية والسياسات المؤسسية، وأي تقييد له دون سند قانوني واضح يخضع للنظام العام المحدد قانونًا، يمثل إخلالاً بالشرعية الدستورية والدولية، ويستوجب المراجعة والمساءلة القانونية.