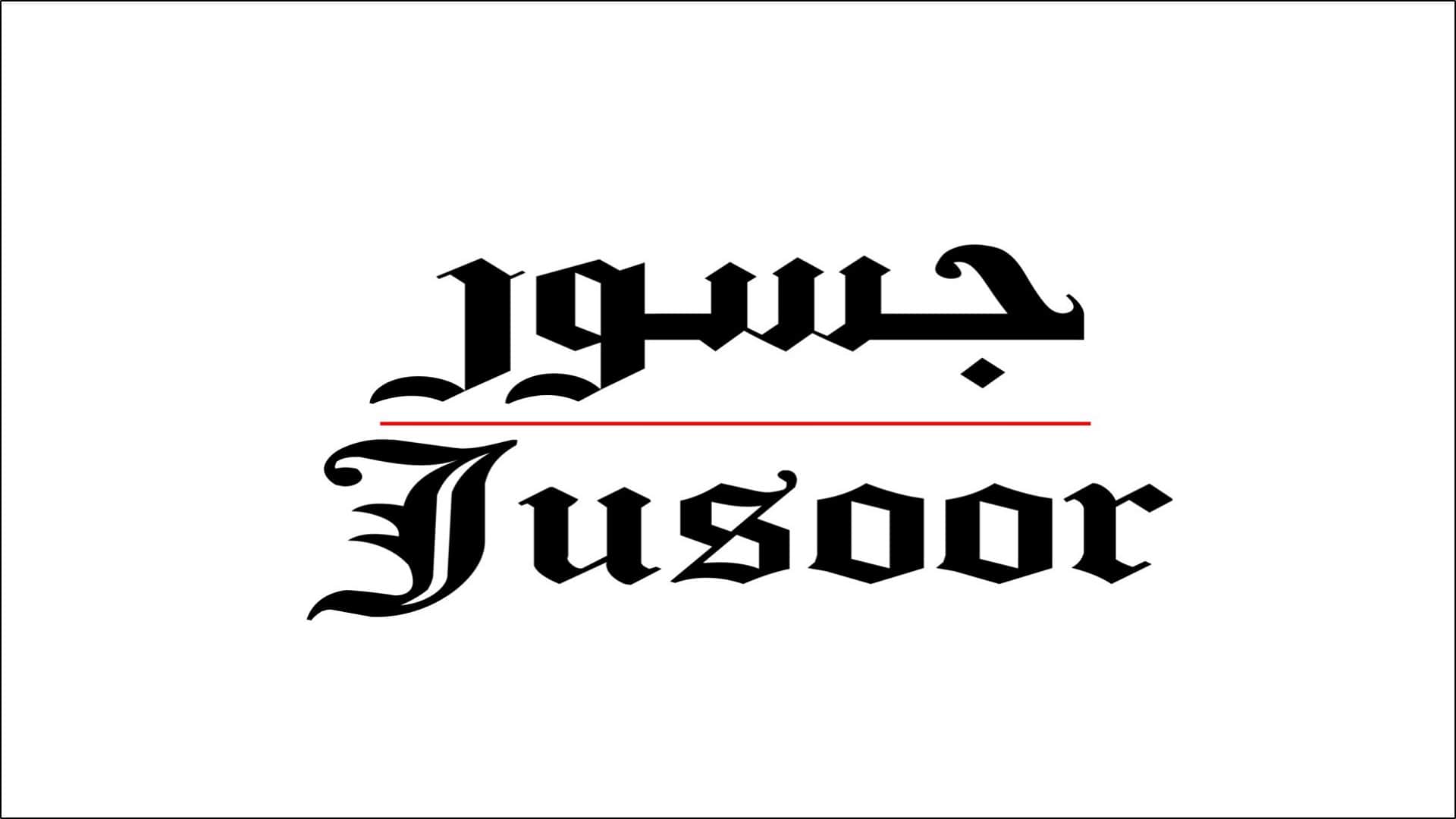من البيت إلى الشارع.. كيف جُرِّد آلاف اللبنانيين من حقهم في السكن؟
تحت ضغط الإيجارات وانهيار الحماية
لم يكن الليل قد اكتمل حين وقف راضي سعد، في عتمة الدرج الضيّق، في العاصمة اللبنانية بيروت، يمدّ يده المرتجفة نحو مفتاح الباب للمرة الأخيرة.. خلفه، كانت أنفاس زوجته تتكسّر وهي تحاول ألّا تبكي أمام الأطفال، فيما يختلط صوت ارتطام الكراسي المكدّسة في شوالات برائحة الغبار العتيق، ووقع خطوات ناطور المبنى الذي اعتاد هذا المشهد.. عائلة تخرج مطأطئة، مسرعة، كأنها تهرب من ذنب لم ترتكبه.
في الليلة السابقة، قال له صاحب البيت بلهجة جافة لا تحتمل النقاش: "من أول الشهر بدي 400 دولار.. ما بيناسبك، الباب بيوسّع".. لم يكن الرجل بحاجة إلى تهديد.
التهديد الحقيقي كان في نظرة الزوجة التي فهمت قبل اكتمال الجملة أن موعد الرحيل قد حان.. لم يكن في يد راضي ما يواجه به هذا القدر، سوى حيرة ثقيلة: يدفع ما لا يملك، أم يرحل إلى المجهول؟
عقد بلا حماية
يعرف راضي، كما آلاف المستأجرين، أن الانتقال في لبنان ليس قراراً، بل فعل اقتلاع.. كان الإيجار قبل سنوات قليلة عبئاً محتملاً؛ 150 دولاراً شهرياً. "ثلاث سنوات فقط فصلتني عن هذا الرقم".
يقول، "لكن ثلاث سنوات في لبنان كفيلة بتحويل الزمن إلى حفرة".. قفز الإيجار إلى 350، ثم إلى 400 دولار، بلا مفاوضات ولا مراعاة. العقد غير مكتوب، والقانون -وإن وُجد- لا يُطبّق.
ويضيف: "على الورق في قانون يحدّد الزيادة كل ثلاث سنوات، بس على الأرض؟ أنا اللي بخسر"، يقول راضي.. رفع دعوى يعني انتظاراً قد يمتد سنوات، مع احتمال المضايقات: قطع الماء، الكهرباء، أو ضغط يومي يدفع المستأجر للرحيل طوعاً.
ويبقى سؤال الحماية معلّقاً: من يحمي الحلقة الأضعف في بلدٍ صارت فيه العدالة رفاهية؟
ومع انهيار الليرة اللبنانية، كان أول ما تكسّر هو معنى البيت، لم يعد السكن مساحة أمان، بل خزنة يريد المالك ملأها بالدولار.. يتقاضى راضي قرابة ألف دولار شهرياً، رقمٌ كان حلماً يوماً، لكنه اليوم بالكاد يغطي الإيجار وسلسلة فواتير لا تنتهي: كهرباء رسمية ومولّد، ماء دولة وصهريج، إنترنت، هاتف، ناطور، ومازوت تدفئة شتاءً.. "في لبنان، ما في فاتورة وحدة"، يقول مبتسماً بمرارة، "كل شي فاتورتين".
الإيجار هنا ليس 400 دولار فقط؛ هو 400 مضافاً إليها 150 للكهرباء، 30 للإنترنت، 50 للماء، 200 للمازوت… ومعها كلفة البحث، والقلق، والوجع.. يصبح المنزل كتلة استنزاف نفسي ومالي، ويصير الخوف من الطرد هاجساً يومياً.
البحث عن مأوى
البدائل؟ يضحك راضي ضحكة قصيرة تفصل بين السخرية والانكسار. القرب من العاصمة مكلف، والبعد عنها يعني أعباء تدفئة ونقص خدمات.. في الأحياء الشعبية، الماء شحيح، والكهرباء خاضعة لتقنين خاص، والعقود غالباً لسنة واحدة تُفتح بعدها شهية الزيادة.. البحث عن بيت بعد الأزمة يشبه السير في حقل ألغام: كل خطوة تحمل خسارة محتملة.
تأتي الحرب لتدفع الأزمة إلى ذروتها. آلاف الوحدات السكنية دُمّرت، وآلاف العائلات اندفعت فجأة إلى سوق إيجارات ضيّق.. "دمّرت الحرب مئات آلاف الوحدات… كلهم صاروا بدهم بيوت"، يقول راضي، ومع ارتفاع الطلب، ترتفع الأسعار بلا رحمة. تزداد المنافسة في المناطق الشعبية، حيث يتزاحم الفقراء على ما تبقّى، فيما يضيف وجود لاجئين يبحثون عن سكن ضغطاً إضافياً على سوق مأزوم.
ويأتي السؤال: أين الحماية؟ "موجودة بالقانون، مش موجودة بالحياة"، يجيب راضي. يدعو إلى دورٍ فاعل للبلديات: منع التأجير بلا سند، وضع سقف للزيادات، وتمكين المستأجر من تقديم شكوى تُقابل باستجابة.. لكن الواقع يقول إن المخفر ليس ملجأً، بل غرفة مزدحمة بشرطي مرهق يختصر الانهيار بجملة: "وهلّق بدك وجّعلي راسي بصاحب البيت؟".
هكذا يخوض اللبناني معركته اليومية: مع سقف غرفته، مع فاتورة المولّد، مع جنون الدولار، ومع مالك يرفع السعر متى شاء السوق. حماية المستأجر ليست قضية سياسية، بل مسألة وجودية: عقد لا يتحوّل إلى أداة ابتزاز، وقانون لا يبقى حبراً على ورق.
أزمة عربية أوسع
ليست لبنان وحدها.. من مصر إلى العراق، ومن الأردن إلى تونس، تتكرر أزمة الإيجارات غير المنظَّمة، حيث ترتفع الأسعار بأسرع من الرواتب، في لبنان، تشير تقديرات 2024–2025 إلى زيادات تقارب 200% منذ 2019، مع تجاوز الإيجارات في بعض أحياء بيروت 800 دولار شهرياً، بعدما كانت نحو 300 قبل الأزمة. آلاف العائلات أُجبرت على الرحيل، خصوصاً من يتقاضون رواتب بالعملة المحلية.
الظاهرة نفسها تنتشر في دول أخرى، حيث يشير تقرير "الاقتصاد العربي 2025" الصادر عن "المؤسسة العربية للبحث الاقتصادي" إلى أن الإيجارات في بعض المدن الكبرى مثل القاهرة وعمّان وبغداد قد زادت بنسب تتراوح بين 50% و80% منذ بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2020.
في مصر، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار الإيجارات في العاصمة القاهرة بنسبة 60% في الأعوام الخمسة الماضية، وهي زيادة ترافقها قفزات في فواتير الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء، وهو ما جعل السكن بعيد المنال بالنسبة للكثير من الأسر المتوسطة والفقيرة.
وتشير البيانات إلى أن ما يقارب 30% من العائلات في العاصمة المصرية يضطرون اليوم إلى دفع أكثر من 40% من دخلهم الشهري على الإيجار، وهو ما يتجاوز المعايير الدولية التي تحدد أن النسبة المثالية لدفع الإيجار لا تتجاوز 30% من الدخل الشهري.
أما في العراق فالوضع لا يختلف كثيراً، حيث يعاني المواطنون في بغداد من ارتفاع غير مبرر في أسعار الإيجارات بعد تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق، مما دفع الآلاف من اللاجئين السوريين والفلسطينيين إلى العودة إلى العراق، ما زاد من الطلب على الوحدات السكنية.
وفقاً لبيانات "مؤسسة الإحصاء العراقية" لعام 2025، زادت الإيجارات في بغداد بنسبة 90% منذ عام 2020، وهو ما وضع مزيداً من الضغوط على الطبقات الفقيرة والطبقة المتوسطة التي كانت قد بدأت في إعادة بناء حياتها بعد سنوات من الحرب والدمار.
لكن المشكلة لا تقتصر فقط على زيادة الأسعار، المشكلة تتعقد بشكل أكبر حين نلقي الضوء على غياب القوانين الفعّالة لحماية المستأجرين، وهو ما يعمّق الفجوة بين المستأجرين والمالكين في الأردن، على سبيل المثال، لا توجد قوانين محددة بشأن تحديد سقف للإيجارات السنوية، ما يترك السوق عرضة للتلاعب.
ورغم وجود قانون يحمي المستأجرين من الزيادة العشوائية في الإيجارات، فإن تطبيقه به العديد من الثغرات، حيث يشتكي الكثيرون من أن إجراءات الشكاوى تستغرق وقتاً طويلاً، وأحياناً لا يجدون أي استجابة من الجهات المعنية وتشير الدراسات إلى أن نحو 25% من المستأجرين في عمان يشعرون بعدم قدرتهم على حماية حقوقهم في ظل غياب وجود جهة تنظيمية فعالة، بحسب تقرير "الاستدامة السكنية في الأردن" الذي أعدته "المجموعة الاستشارية العربية للتنمية" في منتصف 2024.
من منظور حقوقي، تشير الأمم المتحدة في تقريرها السنوي عن حقوق الإنسان في الدول العربية لعام 2025 إلى أن أزمة الإيجارات تُعد من أبرز مظاهر الفقر المدقع في المنطقة، حيث يواجه الكثيرون خطر التشرّد أو العيش في ظروف لا إنسانية.
وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك أكثر من 10 مليون لاجئ في المنطقة العربية يعيشون في ظروف صعبة، وأكثر من نصفهم يعيشون في إيجارات مرتفعة يتجاوز معظمهم قدرتهم على الدفع ويتزايد الضغط على اللاجئين السوريين في لبنان والأردن، الذين هم بالأساس في وضع اقتصادي هزيل، بسبب هذه الزيادات الكبيرة في أسعار الإيجارات ومن المتوقع أن تتفاقم المشكلة إذا استمر غياب تدابير الحماية الفعّالة من قبل الحكومات.
وفي الوقت الذي تواصل فيه الحكومات العربية إهمال هذه الأزمة، يبقى تأثيرها الاجتماعي مدمراً؛ فالعديد من الأسر تواجه صعوبة في توفير احتياجاتهم الأساسية من طعام وتعليم وصحة، حيث يتم استنزاف دخلهم بالكامل تقريباً في دفع الإيجار.
في تونس، التي تعاني أيضاً من أزمة اقتصادية خانقة، أظهرت دراسة للمركز التونسي للإحصاء في 2025 أن 15% من العائلات التونسية تعيش في منازل مهددة بالانهيار بسبب عدم قدرة أصحابها على إصلاحها، و40% من العائلات الأخرى يضطرون لدفع أكثر من 50% من دخلهم الشهري على الإيجار.
لكن الوضع الاجتماعي يتعقد أكثر في ظل التداعيات الاقتصادية والسياسية في بعض الدول في سوريا، التي لا يزال النزاع المستمر فيها يعصف بالبلاد، أصبح توفير السكن حلماً بعيد المنال بالنسبة للكثيرين فوفقاً لتقرير "المنظمة السورية لحقوق الإنسان" في 2025، دُمرت أكثر من 100 ألف وحدة سكنية بسبب الحرب، وما تبقى منها لا يمكن أن يستوعب أعداد اللاجئين العائدين من دول الجوار أو حتى المواطنين السوريين الذين نزحوا داخلياً.
هشاشة المجتمع والاقتصاد
قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن أزمة السكن تُعد من أعمق الأزمات التي يمكن أن تواجه أي دولة، لأنها لا تعكس فقط خللاً في سوق العقارات، بل تكشف بشكل مباشر عن قدرة الدولة واقتصادها على ضمان أحد أهم الحقوق الأساسية للمواطنين، وهو الحق في السكن الآمن واللائق.
وأشار الشافعي في تصريحات لـ"جسور بوست"، إلى أن توفر السكن يُعد أحد المؤشرات الجوهرية التي يُقاس بها استقرار وقوة الاقتصاد الوطني، سواء في مصر أو لبنان أو أي دولة أخرى، موضحاً أن قدرة الدولة على تمكين مواطنيها، لا سيما محدودي الدخل، من الحصول على مسكن آمن تعني أن هذا الاقتصاد يتمتع بدرجة أعلى من الاستقرار والرفاه الاجتماعي وأضاف أن السكن ليس رفاهية إضافية، بل هو أول درجات الرفاه وأساس أي مسار تنموي حقيقي.
وأوضح أن الحديث عن تنمية مستدامة أو تحسين نوعية الحياة يصبح بلا معنى في غياب السكن، لأن الإنسان لا يمكن أن ينمو أو ينتج أو يشارك في بناء المجتمع دون شعور بالأمان والاستقرار ولفت إلى أن السكن يمثل "سكينة" بالمعنى الإنساني العميق، فهو الملاذ الذي يحتمي فيه الفرد والأسرة من تقلبات الظروف المناخية والمعيشية، ومن خلاله تتشكل نواة المجتمع المستقر.
وأضاف الشافعي أن غياب السكن أو عدم القدرة على توفيره يقود بالضرورة إلى سلسلة من الأزمات الاجتماعية المتراكمة، تبدأ بظاهرة التشرد ومراكز الإيواء، ولا تنتهي عند التفكك الأسري وغياب الروابط الاجتماعية السليمة، وأشار إلى أن المجتمعات التي تعجز عن تلبية احتياجات مواطنيها السكنية تكون أكثر عرضة لارتفاع معدلات الجريمة والانحراف السلوكي، نتيجة فقدان الاستقرار وانعدام الشعور بالأمان.
ولفت إلى أن السكن يُعد أحد أعمدة الهدوء المجتمعي، مؤكداً أنه لا يمكن الحديث عن أسرة مستقرة أو نواة اجتماعية سليمة في ظل غياب المسكن، الإنسان قد يتسامح مع نقص بعض متطلبات الحياة الأخرى، لكنه لا يستطيع التعايش دون مكان يأوي إليه، لأن البديل في هذه الحالة يكون الشارع أو مراكز الإيواء، وهو ما ينسف فكرة المجتمع المتماسك من أساسها.
وأشار الشافعي إلى أن غياب السكن ينعكس سلباً على قدرة الأفراد على الاستفادة من بقية الخدمات الأساسية، مثل التعليم والصحة، موضحاً أن المواطن الذي لا يمتلك مسكناً مستقراً يفقد القدرة على الاستمرار في التعليم أو الحفاظ على وضع صحي سليم، لأن كل هذه الخدمات تفترض وجود عنوان ثابت وبيئة مستقرة.
وأكد أن السكن يمثل العمود الفقري لحياة آمنة ومستقرة للأفراد والأسر والمجتمعات، وأن توفيره ينعكس إيجاباً على كل المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، في حين أن غيابه يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً، ارتفاع تكاليف الإيجارات وأسعار العقارات يطرح سؤالاً جوهرياً حول مدى قدرة الدولة على التدخل لحماية الفئات غير القادرة، وضمان ألا يتحول السكن إلى امتياز لفئة دون أخرى.
وختم الشافعي بالتأكيد أن معالجة أزمة السكن ليست خياراً سياسياً، بل التزاماً حقوقياً واقتصادياً، لأن السكن هو الأساس الذي تُبنى عليه حياة كريمة، ومجتمع متماسك، واقتصاد قادر على الاستمرار. وأضاف أن أي دولة تسعى للاستقرار الحقيقي لا بد أن تضع الحق في السكن في صدارة سياساتها العامة، باعتباره مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
قانون الإيجارات وإفقار المجتمع
قال ياسر محمد ياسر سعد، المحامي المهتم بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن أزمة السكن الحالية لا يمكن فهمها بمعزل عن المسار السياسي والاقتصادي الذي سلكته الدولة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي، مؤكداً أن ما يجري اليوم هو نتيجة تراكمات طويلة وليست أزمة طارئة أو خللاً عابراً في سوق الإيجارات.
وأشار سعد، في تصريحات لـ"جسور بوست"، إلى أن عام 1992 شكّل نقطة تحوّل مفصلية مع بدء تبنّي سياسات الخصخصة، حيث بدأت الدولة تنظر إلى العلاقة بين المالك والمستأجر باعتبارها علاقة يجب زعزعة استقرارها، لا تنظيمها أو حمايتها، هذه الرؤية انعكست في سلسلة من القرارات المرتبطة بإسكان العمال وشركات قطاع الأعمال، لكنها بلغت ذروتها في صدور القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي أعاد تشكيل هذه العلاقة على أسس غير متوازنة.
وأوضح أن هذا القانون لم يضع المالك في مواجهة المستأجر فحسب، بل وضع القوي في مواجهة الضعيف، بغضّ النظر عن صفته القانونية، معتبراً أن النتيجة الطبيعية لهذا الاختلال هي تصاعد التوتر والعنف الاجتماعي وأن القانون نقل الصراع من كونه خلافاً تعاقدياً إلى صراع وجودي، تُحسم نتائجه وفق المركز القانوني والسياسي والاجتماعي لكل طرف.
وأضاف سعد أن الخطاب السائد الذي يصوّر الأزمة على أنها صراع بين "ملاك أغنياء" و"مستأجرين فقراء" هو خطاب مضلل، لأن الواقع الاجتماعي أكثر تعقيداً، فجزء كبير من الملاك في مصر، بحسب تعبيره، هم في الأصل من محدودي الدخل الذين لا يملكون سوى عقار صغير يدرّ عليهم دخلاً زهيداً، كان في وقت ما بالكاد يغطي الحد الأدنى من احتياجاتهم، وفي المقابل، يجد المستأجرون أنفسهم في مواجهة ضغوط اقتصادية خانقة، ما يجعل الطرفين في نهاية المطاف ضحيتين لبنية اقتصادية غير عادلة.
وأضاف أن نتائج هذه السياسات لا تتوقف عند حدود أزمة السكن، بل تمتد لتطول بنية المجتمع ككل، حيث يدفع الفقر المتزايد قطاعات من الناس إلى اللجوء إلى أنشطة غير رسمية أو غير مشروعة كوسيلة للبقاء، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مؤكدا أن هذا العنف لا يظهر فقط في الجرائم ضد الأشخاص أو الممتلكات، بل يتجلى أيضاً في أشكال خفية من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار إلى أن النساء يتأثرن بصورة مضاعفة بهذه الأوضاع، إذ تدفعهن هشاشة السكن وانعدام الأمان الاقتصادي إلى العمل في أنشطة غير رسمية تفتقر إلى أي حماية قانونية، ما يعرّضهن لمزيد من الاستغلال داخل الاقتصاد غير المنظم.
وختم سعد تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة، منذ عام 1992، تسير في اتجاه تكريس عدم الاستقرار في العلاقات الإيجارية، في إطار سياسة إفقار ممتدة، محذراً من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الانقسامات الاجتماعية وزيادة العنف، ما لم يُعد النظر جذرياً في فلسفة التشريع، ويُعد الاعتبار للحق في السكن بوصفه حقاً إنسانياً أصيلاً، لا مجرد مسألة تعاقدية تخضع لمنطق السوق وحده.