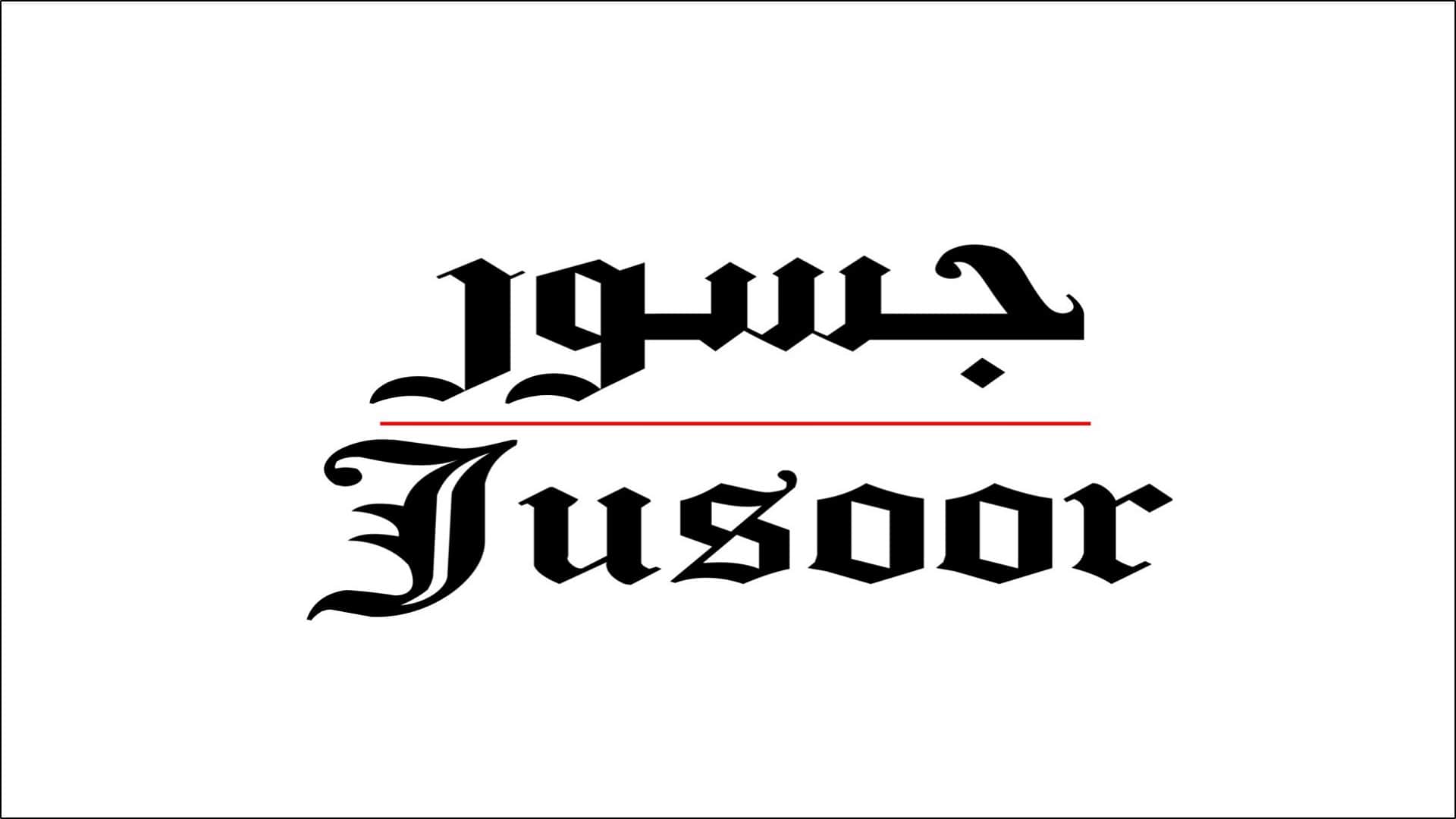ترامب طالب بإعفائها من منصبها.. فرانشيسكا ألبانيزي امرأة كسرت حصار الصمت عن غزة داخل الأمم المتحدة
ترامب طالب بإعفائها من منصبها.. فرانشيسكا ألبانيزي امرأة كسرت حصار الصمت عن غزة داخل الأمم المتحدة
في سابقة نادرة، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمم المتحدة بإعفاء المقررة الخاصة لحقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز من منصبها، متهمًا إياها بـ"التحيّز الصارخ ضد إسرائيل" إثر تقاريرها الحادة التي كشفت جرائم إسرائيل.
في عام 1977، ولدت فرانشيسكا ألبانيز في بلدة أريانو إيربينو بجنوب إيطاليا، منبثقًا من بوتقة ثقافية عريقة، حيث شذا الزيتون الممتد على التلال يحكي قصصًا عميقة عن الأرض والتاريخ، في أسرتها، التي كانت تتناقش حول قضايا تقرير المصير والعدالة الاجتماعية، بدأت تتعمق مبكرًا حقول الفكر والضمير. افتُتنَت بالمأساة الإنسانية منذ طفولتها، خاصة فور معرفتها مجزرة صبرا وشاتيلا في عام 1982، حيث جسدت هذه الحادثة المروّعة ذاكرتها السياسية الأولى، ومهدت الطريق لتشكّل قناعاتها المتعلقة بحقوق الفلسطينيين وضرورة محاسبة المسؤولين.
دمجت ألبانيز تجربة طفولتها التي تربط الأرض بالمحتلّ مع دراساتها المتخصصة، استكملت تعليمها القانوني بامتياز في جامعة بيزا (1995–1999)، حيث لم تكن مجرد طالبة تختزن المعرفة، بل باحثة في ذروة وعيها الأخلاقي، محاولة تعزيز الفكرة: القانون أداة للعدالة لا للسيطرة أو التجميل، وخلال فترة تواجدها في لندن (2000–2001) للدراسة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS)، غاصت في ملفات الصراع العربي الإسرائيلي من منظور شامل، نصوصيًا وأخلاقيًا، ما أعطاها القدرة على دمج التجربة الإنسانية القانونية بالأسس الأكاديمية الصارمة.
مجال دراستها ارتفع لاحقًا عبر أطروحة دكتوراه في قانون اللاجئين الدولي بجامعة أمستردام، وامتدت في نشاطات بحثية في معهد جورج تاون لدارسات الهجرة ومعهد عصام فارس في الجامعة الأميركية ببيروت. هذا الدمج بين التربة الإيطالية والوعي الميداني والعالمي، وعلاقاتها بالأكاديميات الأميركية واللبنانية والعربية، منحتها أدوات فريدة لدخول التاريخ كواحد من أبرز الأصوات الحقوقية في فترة منتصف العقد الثالث من الألفية الثالثة.
أونروا والجسر بين القانون والواقع
بدأت ألبانيز مسيرتها داخل المنظمة الدولية في عام 2003، وذلك ضمن القسم القانوني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس. هذه التجربة الواقعية كانت نقطة فاصلة؛ إذ لم تَخض القضية كمسألة إدارية باردة، بل كوجوه بشرية: أمهات يحملن مفاتيح لمنازل لا تزال مفقودة، أطفال يتعلمون في خيام رديئة، ونساء رُحّل أطفالهن تحت ضغط الحصار، في مشهد يظهر الخذلان الأممي “المزمن”.
هنا تشكل الوعي الحي؛ إذ احتكّت ألبانيز مباشرة بفعل العجز القانوني حين كان القرار الدولي ينحاز إلى رايات مصالح أو يظلّ حبيس حجج البروتوكولات، في حين أن الواقع يصرخ بالحاجة إلى إنقاذ، وهذا التناقض بين صوت القانون وصوت الواقع شكّل مبناها الفكري، إذ أيقنت أن القانون، في جوهره، ينبغي ألا يقف خلف الحبال الدبلوماسية، بل أمام القوى التي تشرّد المواطنين وتخطف هويتهم.
لاحقًا، تنقلت إلى المغرب للعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبعدها إلى مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف، حيث أُضيفت لها تجربة فريدة: التفاعل مع مؤسسات حقوق الإنسان على مستوى وطني، ودعمها لكفاءتها في الشرق الأوسط وآسيا، ضمن عملية جمع ما بين عقل دولة ومشاعر فعاليات المجتمع المدني. باتت في هذه الفترة تحكم أن العدالة الدولية تكون ذات مصداقية حين تُدافع عن الضحايا الأضعف والمحرومين، ولا تتقاطع مع محور القوة مهما كان اسمها أو حجمها.
الترسيم القانوني للفلسطيني
في مارس 2022، تغيّر مسار ألبانيز حين تمّ تعيينها مقرّرة خاصّة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، خلال الدورة الـ49 لمجلس حقوق الإنسان، وأضافت هذه المسؤولية توقيعًا غير مسبوق في خطاب الأمين العام؛ إذ لم يكن منصبًا تقليديًا للمتابعة الأكاديمية، بل منصة تقول فيها: “في مواجهة الاستعمار… القانون لا يحتمل الحلول الوسط”.
وبشكل فوري، رفضت وصم القضية الفلسطينية كنزاع بين طرفين، رغم أن هذا المصطلح يسهل تبرير العنف والتطهير العرقي. وصفتها بـ“حالة استعمار استيطاني”، معلنة صراحة أنها تنحاز “للعدالة والقانون الدولي والحقوق الأساسية”، وأن وصفها بالانحياز للفلسطينيين هو بالضرورة نتيجة انحياز الاحتلال - وهذا كان تغييرًا في طابع الخطاب الدولي.
في أكتوبر 2022، أصدرت تقريرها الدولي الأول بعنوان “إنهاء الاحتلال الاستيطاني”، معتبرة فيه أن ما يفرضه الاحتلال الفلسطيني على الفلسطينيين يندرج تحت نظام فصل عنصري موصوف، داعية إلى خطة واضحة لإنهاء هذا النظام، وشكل هذا التقرير انقلابًا في استخدام المفردة داخل الجسم الدولي، إذ اعتبره قسم غير قليل “دقّة قانونية في وصف واقع سياسي”، واعتبره آخرون تجاهلاً لصدقية الوساطة.
الضربة الكبرى جاءت في مارس 2024 حين صدر تقريرها “تشريح عملية إبادة”، الذي وصف بأدق لغة الصراع المتواصلة ضمن أروقة الأمم المتحدة، واستند التقرير إلى مئات الشهادات الميدانية والوثائق القانونية، وصور الأقمار الصناعية التي رصدت علامات التدمير المنهجية، حيث أكّدت أن ما جرى في غزة ليس خطأ حرب، بل حملة إبادة جماعية ممنهجة، وإن كان الهدف احتجاز فلسطين على طاولة الذاكرة الدولية دون تحقيق العدل الحقيقي.
هذا التوصيف لم يكن شكليًا، وكانت كيانات حقوقية ودول مثل اليونيسف وعضوية أكاديمية في حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق. وصار خطابها آلية ضغط جديدة ضد أجندة الاحتلال، ومدخلًا للحديث عن محاسبات قد تتم أمام المحاكم الدولية.
تشويه واحتواء صوت العدالة
ما إن صدرت كلمات ألبانيز، حتى بدأت محاولات الإماتة حيث أول رد فعل رسمي جاء من إسرائيل التي منعت دخولها العملي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بحجة أن تصريحاتها “تحريض ومغالاة وتحيّز”، وهذه الخطوة تزامنت مع حملات تشوية بدأت من الولايات المتحدة حين وقع 18 نائبًا من الكونغرس “رسالة علنية” إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالب بعزلها فورًا، نتيجة الاتهام الذي وصفه المراقبون “طفوليًا”، حيث تبرّرها النغمة الرسمية القائمة على أن الحكم على الاحتلال لا يتوافق مع ما يسمّى “حيادية المنظمة”.
من داخل العقود الدولية ظهرت رسائل من التحقيقات الإدارية تقول إن ألبانيز ربما استخدمت أموالًا من جهات غير معلنة بهدف تمويل أنشطتها، وأن هناك سؤالًا حول تكاليف سفرها، التي يُقال إنها تبلغ ٢٠ ألف دولار دفعة واحدة إلى أستراليا، هذه المزاعم، أَدّت إلى حملة تشويه مع تبرّؤ أكاديمي دولي، حيث أصدرت مجموعة تضم 65 باحثًا وحقوقيًا بيانات تؤكد أن هذا التشويه يهدف إلى إسكات صوت يحمل منظومة قيم ولا يخضع لتأجيل المحتل الغاشم.
وفوق ذلك كله، تلقّت تهديدات صريحة خلال إعداد تقرير “تشريح عملية إبادة”، ما يجعل من الحملة ضدها جزءًا من استراتيجية أخلاقية لتصفيتها رمزيًا، لا ماديًا فقط، ويعتبر أنصارها هذه الحملات تستهدف منع مثول الاحتلال أمام حوار ضميره، وأن الضحايا يُمنعون من الحديث ونسيان الصوت الذي يكافح لإثبات الحقائق.
رمز دولى للقانون
فرانشيسكا ألبانيز تجاوزت حدود منصبها الرسمي، لم تعد ممثلة أوروبية تشغل منصبًا تابعًا للأمم المتحدة، بل أصبحت رمزًا دوليًا للقانون الذي يتحدث عبر من يسكن قلبه، لا عبر من تحميه أجهزة الدولة وحساباتها الباردة.
بكلماتها: “كل طفل فلسطيني يُقتل هو اختبار للعدالة في هذا العصر”، تلخّص المسافة بين صيغة خطاب وتقارير مرهقة بنصوص القانون، وبين فعل يضفي وزنًا أخلاقيًا: القانون يجب أن يجنّد لحماية الحياة، لا تبرير قتلها. أسلوبها يمزج بين الصرامة القانونية والحرارة الأخلاقية، فتجعل من بيانات الأمم وثائق مشهوداً بها أمام الضمير لا التاريخ فقط.
لا تتقوقع أبدًا في المظهر الدبلوماسي؛ هي لا تصرخ، لكنها تقول كلمتها بحجر من برودة الدبلوماسية، فتنهار عليه الأقنعة. وتلتحق بعدها الطوابير التي تصطف خلفها: الشهود، الضحايا، الأكاديميون الذين يعبرون عن صوت جديد للضمير.
كباحثة، أنتجت أعمالًا علمية أسهمت في ترسيخ قضايا اللجوء في القانون الدولي، مع دراسات تحليلة للأبعاد النفسية والقانونية، وأعادت بناء ملفات اللاجئين الفلسطينيين كموروث قانوني قابل للحماية لا مجرد نصوص أطلقت منذ النكبة.
أما على المستوى الرمزي فحضورها مؤثر إذ صنعت تماثلية بين امرأة تلبس ثوبها الأكاديمي وتتحدث من داخل الأوساط الدولية، وبين امرأة فلسطينية تملك قطعة خبز لطفل تحت الحصار، هذان الخطابان يجتمعان في صوت واحد، يجعل صوت القانون قوياً، وأقوى حين لا يخشى القلم الذي يروي الحكاية.
تأثير ألبانيز في الخطاب الحقوقي
لم تكن تقارير فرانشيسكا ألبانيز مجرد وثائق تقنية صادرة عن مقررة أممية، بل تحوّلت إلى ظاهرة مؤسِّسة في طريقة تعاطي القانون الدولي مع القضايا ذات الطبيعة المركّبة كالقضية الفلسطينية. هذا التحول لم ينحصر في المضمون، بل امتد إلى البنية الخطابية الأممية ذاتها، التي كانت غالباً تُلجِم نفسها داخل اللغة الحيادية إلى حدّ التبلّد.
شكّلت تجربة ألبانيز نموذجًا مختلفًا؛ فهي لا تصوغ تقاريرها من خلف ستائر المكاتب الأممية في جنيف أو نيويورك، بل تنحتها من تربة المعاناة الحيّة. التقارير التي أنتجتها منذ توليها المنصب -وعلى رأسها “إنهاء الاحتلال الاستيطاني” و“تشريح عملية إبادة”– أدّت إلى اتساع دائرة المصطلحات المعتمدة ضمن منظومة الأمم المتحدة، بحيث لم تعد كلمات مثل "الاستعمار"، "الفصل العنصري"، "الإبادة الجماعية"، غريبة أو موضع تشكيك لغويّ حين ترتبط بإسرائيل، بعدما ظلت لسنوات ضمن قاموس “المسكوت عنه”.
إحدى النتائج المحسوسة لتأثيرها كانت انتقال عشرات المنظمات الحقوقية الدولية إلى اعتماد تقاريرها مرجعاً أساساً في طعونها أمام المحاكم الدولية أو لجان حقوق الإنسان، بل إن بعضها -كمنظمة “هيومن رايتس ووتش” و“بتسيلم”- بدأ يتبنى خطابًا أكثر صرامة يقترب من طروحاتها، بعد سنوات من اعتماد لغة توازن هشّة.
ومع هذه التحولات، بدأت ملامح تحول داخل الجهاز الحقوقي الأممي ذاته. مقرّرون سابقون -مثل مايكل لينك- عبّروا عن دعمهم لطروحات ألبانيز، رغم ما فيها من "تفكيك لأقنعة الحياد المصطنع". هذا التبدّل دفع بكثير من الأصوات داخل الأمم المتحدة إلى إعادة طرح أسئلة جوهرية عن ماهية وظيفة المقررين الخاصين: هل هم ناقلو معلومات ميدانية فقط؟ أم حملة ضمير يبلّغون المجتمع الدولي بما لا يريد سماعه؟
وهنا تحديدًا بدأت ألبانيز تُزعج نمط الإدارة البيروقراطية للمنظومة الأممية؛ إذ لم تُخفِ رأيها بأن السكوت عن الجرائم هو تواطؤ غير مباشر، وأنّ تكرار الدعوات إلى "وقف فوري لإطلاق النار" دون محاسبة فعلية، ليس إلا إعادة تدوير للكارثة نفسها. في ذلك، دخلت خطًا نادرًا في تاريخ المقررين: الخط الذي لا يقف عند التوصيف، بل يدفع نحو تفكيك بنيات الإفلات من العقاب.
في المقابل، بات واضحًا أن هناك محاولات لتطويق هذا التأثير، عبر الضغط على مكاتب الأمم المتحدة لعدم تعميم تقاريرها، أو اعتبارها “وجهة نظر شخصية”. إلا أن التسريبات الإعلامية، واحتضان عدد كبير من الجامعات الدولية لخطابها (خاصة في أميركا اللاتينية وأفريقيا)، أدّى إلى ما يشبه تكاثر صوتها، لا عزله. إنها لم تكن مقرّرة أممية فقط، بل محرّك ضمير داخل جهاز بالغ التشابك، أثبت أن الجرأة على توصيف الجريمة هي الخطوة الأولى في طريق العدالة، لا آخره.
رمزية ألبانيز في المشهد النسوي
فرانسيسكا ألبانيز لم تفرض حضورها فقط كمقرّرة أممية متمرّسة، بل كإمرأة تحمل مشروعًا أخلاقيًا حادًّا في عالم تحكمه المقاربات الذكورية للقوة والسياسة. في هذا الإطار، تجلّت ألبانيز كأيقونة نسوية من طراز فريد؛ إذ لم تبنِ مشروعها على “التمثيل الشكلي للمرأة” كما يحدث في كثير من مؤسسات القرار، بل على تفكيك المعايير التي تُقصي النساء عن مراكز التأثير الأخلاقي والقانوني.
اللافت أن ألبانيز لم تستخدم قطّ هويتها الجندرية أداةً خطابيةً، لكنها -دون أن تعلن ذلك- جسّدت حضور المرأة في موقع المواجهة الأخلاقية، لا فقط الإدارية. في عالم غالبًا ما يُصوِّر النساء الدبلوماسيات كصاحبات لغة ناعمة أو مواقف وسطية، جاءت هي لتقلب هذه الصورة رأسًا على عقب، وكانت كلماتها حادة، صوتها واضحًا، وتحليلاتها بلا تردّد، ومع ذلك، ظلّت ملتزمة بجمالية الإنصات والإصغاء، ما أضفى على شخصيتها مزيجًا قلّ نظيره: الصرامة المبدئية مع الحسّ الإنساني الدقيق.
في مؤتمرات دولية كبرى، تجرأت على مواجهة السفراء والساسة بلغة حقوقية لا تسمح بالمراوغة، بل تضع الجميع أمام مسؤولياتهم. وأصبح يُستشهَد بتقاريرها ضمن المؤتمرات النسوية العالمية كنموذج لـ"العدالة الجندرية في الحقول القانونية"، ما دفع بعض الباحثات إلى دراسة خطابها ضمن ما يُعرف بـ"التقاطع بين النسوية والعدالة الكونية"، وهكذا، دون أن تُعلن نفسها ممثلة لأي تيار، باتت ألبانيز مرآة عاكسة لصوت نساء الحقوق اللاتي لم يجدن بعدُ منصات تعبّر عنهن بحزم القانون وشفافية الوعي.
أكثر ما منح رمزية وجودها بُعدًا عميقًا هو كونها امرأة تواجه دولًا، لا منظمات فقط، امرأة لا تحتمي بمجموعات ضغط، بل تحتمي بصوت الضحايا،ومن داخل هذا الواقع، تحوّلت إلى نموذج يلهم الباحثات الشابات في مراكز القانون الدولي، إذ بات يُنظَر إلى مسارها كمثال نادر على التوفيق بين التخصّص الأكاديمي، والعمل الميداني، والموقف المبدئي دون أن تتنازل عن أي من هذه الأبعاد.
لم يكن هذا التأثير دون ثمن. التهديدات، محاولات التشويه، وحتى التشكيك بمهنيتها كلها صارت أدوات تُستخدم لمحاولة إضعاف صوتها. لكن ما لم يدركه خصومها هو أنها تنتمي إلى جيل نسائي جديد يعتقد أن المنصب ليس غاية، بل أداة لإعادة تعريف الوظيفة الأخلاقية للعدالة الدولية.
فرانسيسكا ألبانيز لم تُكتب فقط في دفاتر الأمم المتحدة، بل كُتبت في الذاكرة النسوية الحقوقية كصوت يقود بلا صراخ، ويصوغ القوة من صدق الموقف لا من حجم المرافعة. نموذج امرأة لم تنتظر منصة لتقول كلمتها، بل جعلت من الكلمة منصة للعالم.