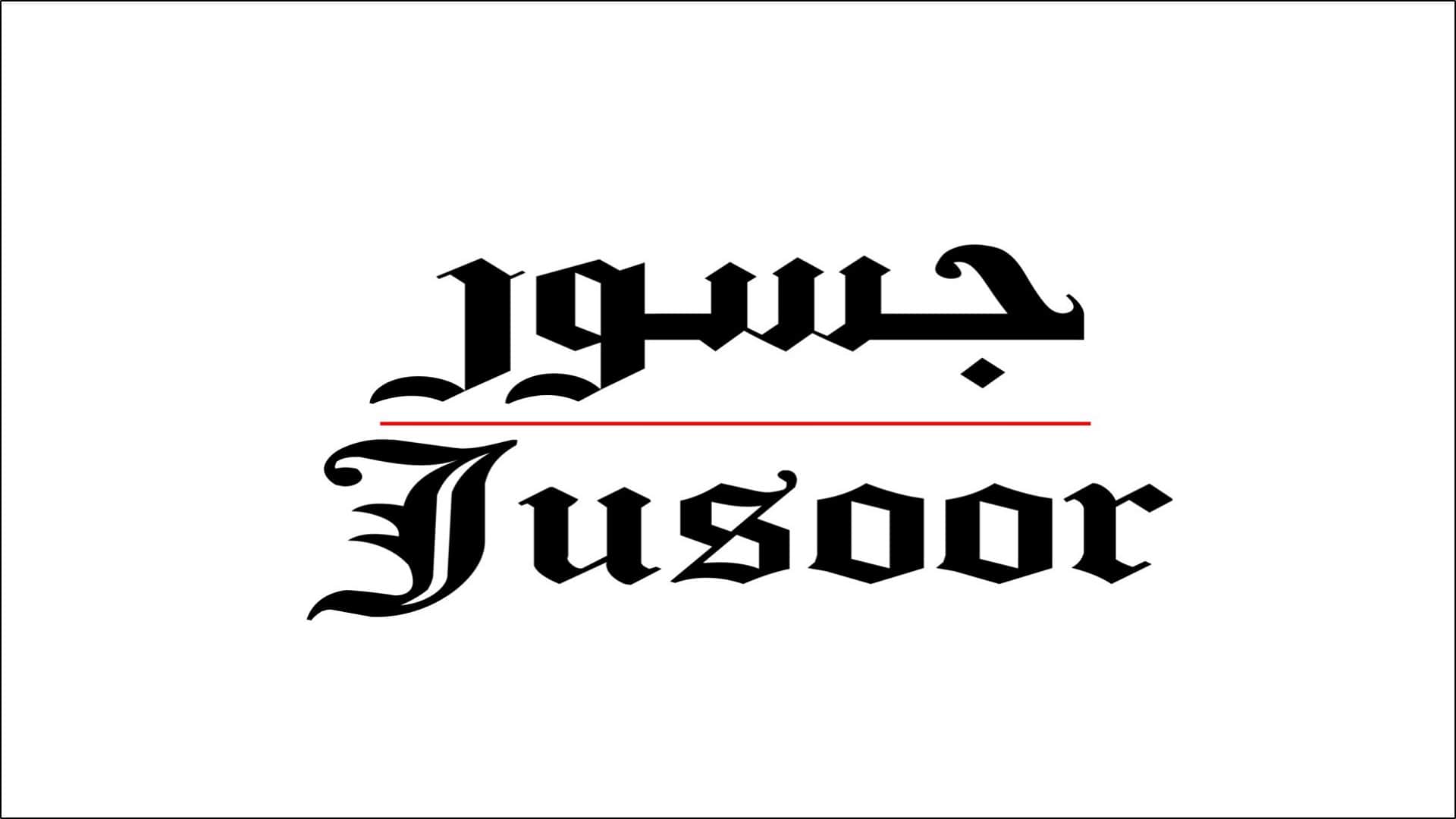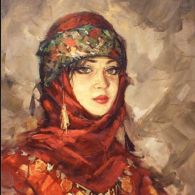قوانين مكافحة الإرهاب.. سيف ذو حدين يهدد المجتمع المدني وحقوق الإنسان
قوانين مكافحة الإرهاب.. سيف ذو حدين يهدد المجتمع المدني وحقوق الإنسان
في أعقاب تصاعد ظاهرة الإرهاب العالمية، سارعت دول عدة إلى سن وتعديل قوانين مكافحة الإرهاب بهدف حماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات المتزايدة، ومع ذلك، وعلى الرغم من أهمية هذه القوانين في التصدي للإرهاب، فإن تطبيقها غالبًا ما يثير مخاوف جدية بشأن تداعياتها السلبية على المجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وبينما تسعى الحكومات إلى تعزيز قدراتها الأمنية، يمكن أن تُستخدم هذه التشريعات أداةً لقمع المعارضة السلمية، وتضييق الخناق على النشطاء، وتقييد الحريات الأساسية، ما يُهدد النسيج الديمقراطي، ويُقوض جهود بناء مجتمعات مستقرة وعادلة.
"جسور بوست" تُلقي في هذا التقرير نظرة تحليلية معمقة على هذه القضية، مُستعرضة أبرز التحديات التي تُشكلها قوانين مكافحة الإرهاب على المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان، ومُدعمًا ذلك بتقارير المنظمات الحقوقية والأممية.
توسع قانوني على حساب الحقوق
في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001، تبنت دول عدة -بما فيها الديمقراطيات العريقة- تشريعات صارمة لمكافحة الإرهاب، وبحسب تقرير أصدرته المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تضمّنت هذه القوانين تعريفات فضفاضة للغاية للإرهاب، تصل في بعض الحالات إلى حد تجريم التعبير السلمي أو المشاركة في الاحتجاجات.
ويشير التقرير الأممي إلى أن بعض الدول استخدمت مصطلحات مبهمة مثل تهديد الأمن القومي أو التحريض على الإرهاب لاعتقال صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان، بل وأحيانًا لحظر منظمات بأكملها.
وتقدّر منظمة فريدوم هاوس أن أكثر من 75 دولة سنت أو عدّلت قوانين لمكافحة الإرهاب منذ عام 2001، من بينها دول ديمقراطية وأخرى ذات أنظمة سلطوية، وفي تقريرها لعام 2024، رصدت هيومن رايتس ووتش ما لا يقل عن 250 حالة في عشر دول تم فيها احتجاز نشطاء أو ملاحقتهم قضائيًا استنادًا إلى قوانين مكافحة الإرهاب، فقط بسبب عملهم السلمي.
استهداف منظمات المجتمع المدني
تُعد قوانين مكافحة الإرهاب، في كثير من الأحيان، فضفاضة وغير محددة بشكل كافٍ، ما يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة تُستخدم لتجريم أنشطة غير إرهابية بطبيعتها، من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المدني ما يأتي:
تجريم النشاط السلمي، حيث يمكن أن تُستخدم هذه القوانين لتجريم التظاهرات السلمية، والتعبير عن الرأي المخالف، وحتى العمل الخيري والإنساني، فبعض القوانين تُجرم "تمويل الإرهاب" بطريقة فضفاضة تُمكن السلطات من استهداف المنظمات غير الحكومية التي تُقدم المساعدات الإنسانية في مناطق يُنظر إليها على أنها تحت سيطرة جماعات إرهابية، حتى لو كانت المساعدات مُحايدة.
تقييد حرية التعبير، حيث تُفرض قيود صارمة على حرية التعبير تحت ذريعة مكافحة "التحريض على الإرهاب" أو "نشر الأفكار المتطرفة". هذا يُمكن أن يُستخدم لقمع الصحفيين، والمدونين، والنشطاء الذين ينتقدون السياسات الحكومية أو يُسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان، حتى لو كانت تصريحاتهم لا تُشكل تهديدًا مباشرًا للأمن.
المراقبة الجماعية والتجسس، حيث تُمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة للمراقبة والتجسس على الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك جمع البيانات الشخصية والتنصت على الاتصالات، دون ضمانات كافية لحماية الخصوصية. هذا يخلق مناخًا من الخوف ويُعوق عمل النشطاء الذين يحتاجون إلى سرية في تواصلهم وحماية لمصادر معلوماتهم.
تجميد الأصول وحظر المنظمات، حيث تُمنح الحكومات صلاحيات تجميد أصول المنظمات أو حظرها بالكامل، بناءً على اتهامات غير مُثبتة بـ"الارتباط بالإرهاب"، ما يُشل عملها ويُقوض قدرتها على خدمة المجتمعات.
نشطاء حقوقيون في مرمى النيران
يُعد نشطاء حقوق الإنسان من أكثر الفئات استهدافًا بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، وتُقدم هذه القوانين ذريعة للسلطات لـ:
الاعتقال التعسفي والاحتجاز المطول، حيث يُعتقل النشطاء ويُحتجزون لفترات طويلة دون محاكمة، أو بناءً على اتهامات غامضة بالإرهاب، ما يُعرقل عملهم ويُشكل انتهاكًا لحقهم في المحاكمة العادلة.
المحاكمات الجائرة، حيث يُحاكم العديد من النشطاء أمام محاكم استثنائية أو عسكرية، تفتقر إلى ضمانات العدالة الأساسية، وتُفرض عليهم أحكام قاسية بناءً على أدلة سرية أو اعترافات مُنتزعة تحت الإكراه.
التعذيب وسوء المعاملة، حيث تُشير تقارير عدة إلى تعرض نشطاء حقوق الإنسان للتعذيب، وسوء المعاملة خلال الاحتجاز بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، بهدف انتزاع المعلومات أو إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
حملات التشويه والتحريض، حيث تُشن حملات تشويه وتخوين ضد نشطاء حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الرسمية، تُصوّرهم كـ"متعاطفين مع الإرهاب" أو "أعداء للوطن"، ما يُعرضهم للخطر ويُضعف دعمهم الشعبي.
وتؤكد منظمة العفو الدولية أن كثيرًا من هذه القوانين تُستخدم لتقييد تمويل الجمعيات المستقلة ومراقبة أنشطتها، ففي تركيا مثلاً، استُخدم قانون مكافحة الإرهاب لإغلاق مئات الجمعيات والصحف منذ محاولة الانقلاب عام 2016، تحت تهمة دعم تنظيمات إرهابية، تقول هيومن رايتس ووتش إن بعض هذه الكيانات لم يثبت بحقها أي دليل ملموس، لكن الإجراءات العقابية دمّرت قدرتها على العمل.
يوثق تقرير الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان شهادات لنشطاء تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء الأمني المتكرر بعد انتقادهم سياسات حكومية، ويقول التقرير إن مجرد التحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان أو المشاركة في ورش عمل تدريبية أصبح في بعض البلدان سببًا كافيًا للاتهام بترويج أفكار إرهابية.
في السودان مثلاً، تعرض محامون ومدافعون عن حقوق الإنسان للملاحقة بموجب مواد قانون مكافحة الإرهاب بعد مشاركتهم في توثيق حالات تعذيب.
حجة الأمن القومي
غالبًا ما تُبرر الحكومات هذه السياسات بأنها ضرورية لمواجهة تهديدات حقيقية، خاصة بعد تصاعد الهجمات الإرهابية عالميًا، غير أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحذر في تقريرها الأخير من أن تجاهل التوازن بين الأمن والحرية يُقوّض الثقة بين المواطنين والدولة ويؤدي إلى نتائج عكسية، بما في ذلك دفع بعض الأفراد نحو التطرف بدلًا من منعه.
يرى خبراء أن أثر هذه القوانين يتجاوز استهداف النشطاء المباشرين، فمجرد وجودها يخلق حالة رقابة ذاتية واسعة النطاق: مؤسسات المجتمع المدني تتجنب مناقشة ملفات حساسة مثل حقوق الأقليات، التعذيب أو الفساد خوفًا من العقاب.
في الأردن، دفعت قوانين مكافحة الإرهاب بعض الجمعيات إلى إلغاء ورش عمل تتعلق بحرية التعبير، وفي المغرب، اضطر صحفيون إلى التوقف عن تغطية موضوعات حساسة خشية اتهامهم بالإضرار بالأمن القومي.
التداعيات على المجتمعات
التأثير لا يتوقف عند النشطاء والمنظمات، بل يمتد ليشمل المجتمع بأكمله. بحسب تقرير مشترك صدر عن لجنة الحقوقيين الدولية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، يؤدي استهداف الأصوات المستقلة إلى إضعاف المساءلة العامة، إخفاء الحقائق حول الانتهاكات، وغياب المعلومات الموثوقة أمام الرأي العام.
ويؤكد التقرير أن غلق المنظمات المدنية يضرّ بقطاعات خدمية حيوية كالتعليم والصحة، حيث تقدم هذه الجمعيات خدمات لا تستطيع الحكومات وحدها تغطيتها.
وفي 2023، أصدر المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة تقريرًا دعا فيه الدول إلى «إعادة النظر فورًا» في قوانين الإرهاب ذات التعريفات الواسعة، وأكد أن هذه القوانين غالبًا ما تُستخدم أداةً لإسكات المجتمع المدني وتقويض الديمقراطية.
وأشارت المفوضية الأوروبية بدورها إلى ضرورة التمييز بين العمل السلمي المشروع والنشاط الإرهابي الحقيقي، مشددةً على وجوب أن تكون أي قيود ضرورية ومتناسبة.
دعوات للإصلاح
تطالب المنظمات الحقوقية بإجراء إصلاحات جوهرية، من بينها: تحديد تعريف دقيق للإرهاب في القوانين الوطنية، وضمان رقابة قضائية مستقلة على كل الإجراءات، وحماية حرية التعبير والاجتماع السلمي، وإلغاء العقوبات الجماعية مثل حظر المنظمات أو تجميد أموالها دون حكم قضائي نهائي.
وترى منظمة العفو الدولية أن مكافحة الإرهاب يجب ألا تكون مسوِّغاً لسحق المجتمع المدني، بل إن وجود مساحة مدنية حرة وشفافة هو جزء أساسي من مكافحة التطرف.
وبينما يظل الخطر الإرهابي حقيقيًا، يشير كثير من الخبراء إلى أن القوانين الفضفاضة لا تحقق الأمان بقدر ما تهدم الثقة وتضيّق مساحة الحوار الحر، ما يُضعف في النهاية قدرة المجتمعات على مقاومة التطرف، ويظل التحدي الحقيقي هو إيجاد التوازن الدقيق: حماية الأمن دون التضحية بالحرية.