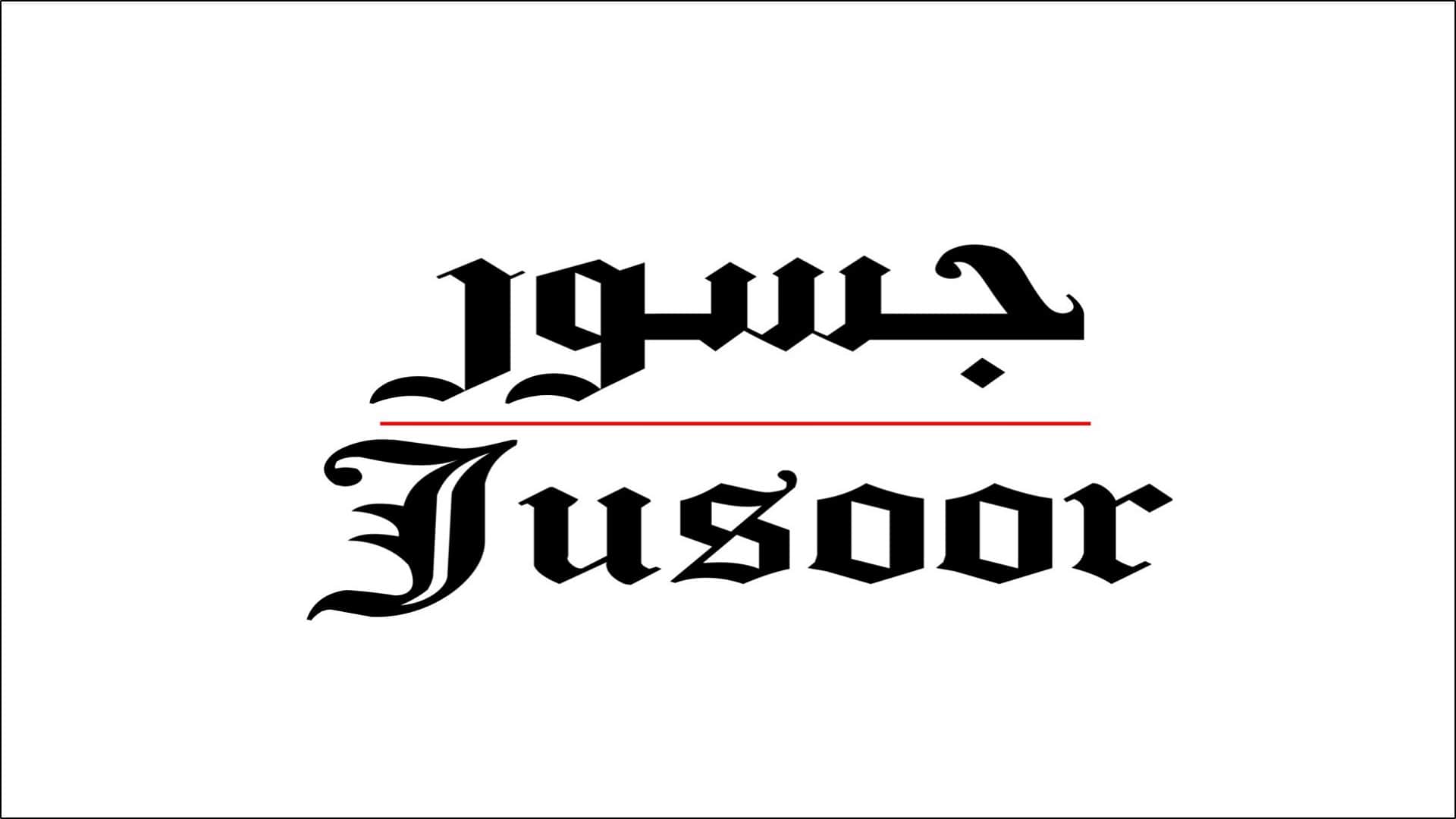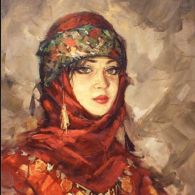معركة من أجل البقاء.. كيف تتحقق العدالة المناخية بين تقاعس الحكومات وضغوط المجتمع المدني؟
معركة من أجل البقاء.. كيف تتحقق العدالة المناخية بين تقاعس الحكومات وضغوط المجتمع المدني؟
لم يعد تغير المناخ مجرد قضية بيئية أو تحدٍ تقني لحكومات تبحث عن سياسات خضراء، إنه اليوم أزمة حقوق إنسان شاملة تمس الحق في الحياة، والصحة، والسكن، والغذاء، والمياه، والثقافة. فبحسب تقارير الأمم المتحدة، سيؤثر تغير المناخ بشكل مباشر على مئات الملايين من البشر خلال العقود المقبلة، بينما يدفع ثمنه الأكبر من لم يسهموا إلا قليلاً في مسبباته.
كل يوم يمر دون اتخاذ إجراءات جادة يعني مزيداً من المعاناة لمجتمعات في الجزر المنخفضة، وفي القرى الزراعية الفقيرة، وفي المدن المعرضة لفيضانات وأعاصير أكثر تكراراً وحدة، وهذا التناقض بين المسؤولية التاريخية والانكشاف الحالي هو ما جعل الأزمة المناخية تتحول في الخطاب الحقوقي إلى قضية عدالة بامتياز.
قضية مضيق توريس
في أقصى شمال أستراليا، يواجه سكان جزر مضيق توريس خطراً وجودياً حقيقياً حيث لم يعد ارتفاع مستوى سطح البحر توقعاً نظرياً، بل حقيقة تهدد المنازل والمزارع والمواقع الثقافية والمقابر التاريخية، في عام 2021، رفع زعيما المجتمع المحلي العم باباي والعم بول قضية تاريخية ضد الحكومة الأسترالية، معتبرين أن تقاعسها عن حماية الجزر يمثل إخلالاً بواجبها في الرعاية.
ورغم أن المحكمة العليا الأسترالية في يوليو 2025 أقرت بعدم وجود التزام قانوني مباشر على الحكومة، فإنها اعترفت بأن مستقبل الجزر قاتم إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة، وقد وثقت المحكمة أن التربة الزراعية لم تعد صالحة بفعل تسرب مياه البحر، وأن سكان بويغو وسايباي قد يصبحون أول لاجئي مناخ في أستراليا خلال 30 عاماً.
هذا الحكم شكّل سابقة قضائية تُظهر كيف يمكن للأزمات البيئية أن تتحول إلى نزاعات قانونية تمس صميم حقوق الإنسان: الحق في السكن، وفي الغذاء، وفي الثقافة، وفي البقاء ذاته.
من المحيط الهادئ إلى محكمة العدل الدولية
في موازاة هذه القضية، تحركت حملات حقوقية وأكاديمية في جنوب المحيط الهادئ للضغط على محكمة العدل الدولية، فمنذ عام 2019، قاد طلاب القانون في جامعة جنوب المحيط الهادئ حملة تطالب المحكمة بإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الدول تجاه المناخ، وبعد ست سنوات من الجهود، جاء القرار في يوليو 2025 ليؤكد أن التمتع الكامل بحقوق الإنسان غير ممكن دون العمل المناخي الجاد.
وصفت المحكمة تغير المناخ بأنه "مشكلة وجودية ذات أبعاد كوكبية" وأكدت مسؤولية الدول في حماية البيئة والأجيال الحالية والمستقبلية، وبهذا القرار، انتقلت قضية المناخ من كونها مسألة سياسية أو تفاوضية إلى التزامات قانونية دولية، تعزز موقف المجتمعات المتضررة في المطالبة بالمساءلة والتعويض.
ردود فعل المنظمات الحقوقية والأممية
رحبت منظمات حقوقية دولية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بالقرار، واعتبرته لحظة تاريخية للعدالة المناخية، وأكدت العفو الدولية أن الحكم يضع الحكومات أمام مسؤوليات قانونية وأخلاقية، لا سيما الدول الصناعية الكبرى التي تتحمل العبء الأكبر من الانبعاثات التاريخية.
من جانبها، شددت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة على أن حماية حقوق الإنسان في القرن الحادي والعشرين لن تكون ممكنة من دون مواجهة أزمة المناخ، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة في تقارير حديثة إلى تسريع تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2035، محذراً من أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية من الاحترار العالمي قد يقود إلى كوارث لا رجعة فيها.
الأرقام تتحدث: صورة قاتمة تتسع
وفق تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) لعام 2023، ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بالفعل بمقدار 1.1 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وإذا استمر المسار الحالي فقد يتجاوز الاحترار 2.7 درجة بحلول نهاية القرن.
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن تغير المناخ قد يتسبب في نحو 250 ألف حالة وفاة إضافية سنوياً بين عامي 2030 و2050 بسبب سوء التغذية والملاريا والإجهاد الحراري.
البنك الدولي قدّر أن 216 مليون شخص قد يضطرون إلى النزوح الداخلي بحلول 2050 نتيجة آثار المناخ.
في أستراليا وحدها، شهدت البلاد بين 2019 و2023 سلسلة حرائق غابات مدمرة وصفت بأنها "الأسوأ في التاريخ"، تسببت في خسائر بشرية ومادية هائلة، وفاقمت أزمة السكن والصحة النفسية.
هذه الأرقام تعكس أن الأزمة ليست مستقبلية فحسب، بل واقعة اليوم، وتكشف حجم التهديد لحقوق الإنسان الأساسية.
العدالة المناخية بين القانون والسياسة
مع اتساع الفجوة بين التزامات الدول وخطواتها الفعلية، برزت حركة "العدالة المناخية" كإطار جامع للنضال الحقوقي والبيئي.
جوهر هذا المفهوم يقوم على أن المسؤولية يجب أن تُوزع وفق المساهمة التاريخية في الأزمة، وأن يُمنح المتضررون الأكثر هشاشة حق الحماية والتعويض.
من هذا المنظور، تتحمل الاقتصادات الصناعية الكبرى –مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين والهند– مسؤولية مضاعفة، ليس فقط في خفض الانبعاثات، بل أيضاً في تقديم الدعم المالي والتقني للدول النامية. وقد ربطت اتفاقية باريس 2015 بين الحد من الانبعاثات وتمويل التكيف، لكن فجوة التمويل لا تزال كبيرة، إذ لم يتحقق بعد هدف 100 مليار دولار سنوياً لدعم الدول النامية.
مأزق أستراليا وصوت المجتمع المدني
في أستراليا، التي تُعد من كبار مصدري الفحم والغاز، يتجلى التناقض بوضوح، بينما تلتزم الحكومة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050، يرى الحقوقيون والعلماء أن هذا الموعد متأخر جداً.
89 منظمة حقوقية وبيئية، من بينها منظمة العفو الدولية، تطالب الحكومة بالوصول إلى الصفر الصافي بحلول 2035، انسجاماً مع ما يقتضيه الحفاظ على الاحترار عند 1.5 درجة مئوية.
الناشطة الأسترالية نيكيتا وايت قالت في تصريحات صحفية إن "الانتظار حتى 2050 يعني تعريض حقوق الإنسان للخطر"، مؤكدة أن المجتمعات الأسترالية تعاني بالفعل من الفيضانات والحرائق وارتفاع مستوى سطح البحر.
من ستوكهولم إلى باريس
منذ مؤتمر ستوكهولم 1972 حول البيئة البشرية، بدأ الربط بين البيئة وحقوق الإنسان يظهر في الخطاب الدولي، وتدريجياً، ترسخ هذا الرابط في اتفاقيات لاحقة، أبرزها اتفاقية باريس للمناخ 2015، التي وضعت هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة، إلا أن ضعف الالتزامات الوطنية والفجوة بين الأقوال والأفعال أبقت العدالة المناخية بعيدة المنال.
اليوم، ومع صدور رأي محكمة العدل الدولية وتكاثر الدعاوى القضائية، يتحول المناخ إلى ساحة رئيسية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، في سابقة قد تعيد تشكيل مفهوم السيادة والالتزام الدولي.
الأزمة المناخية تكشف هشاشة النظام الدولي القائم على المصالح قصيرة الأمد، لكنها تكشف أيضاً قدرة المجتمعات والأفراد على دفع التغيير، فمن جزر مضيق توريس إلى حملات طلاب المحيط الهادئ، يبرز صوت إنساني واحد يطالب بالعدالة والحماية.