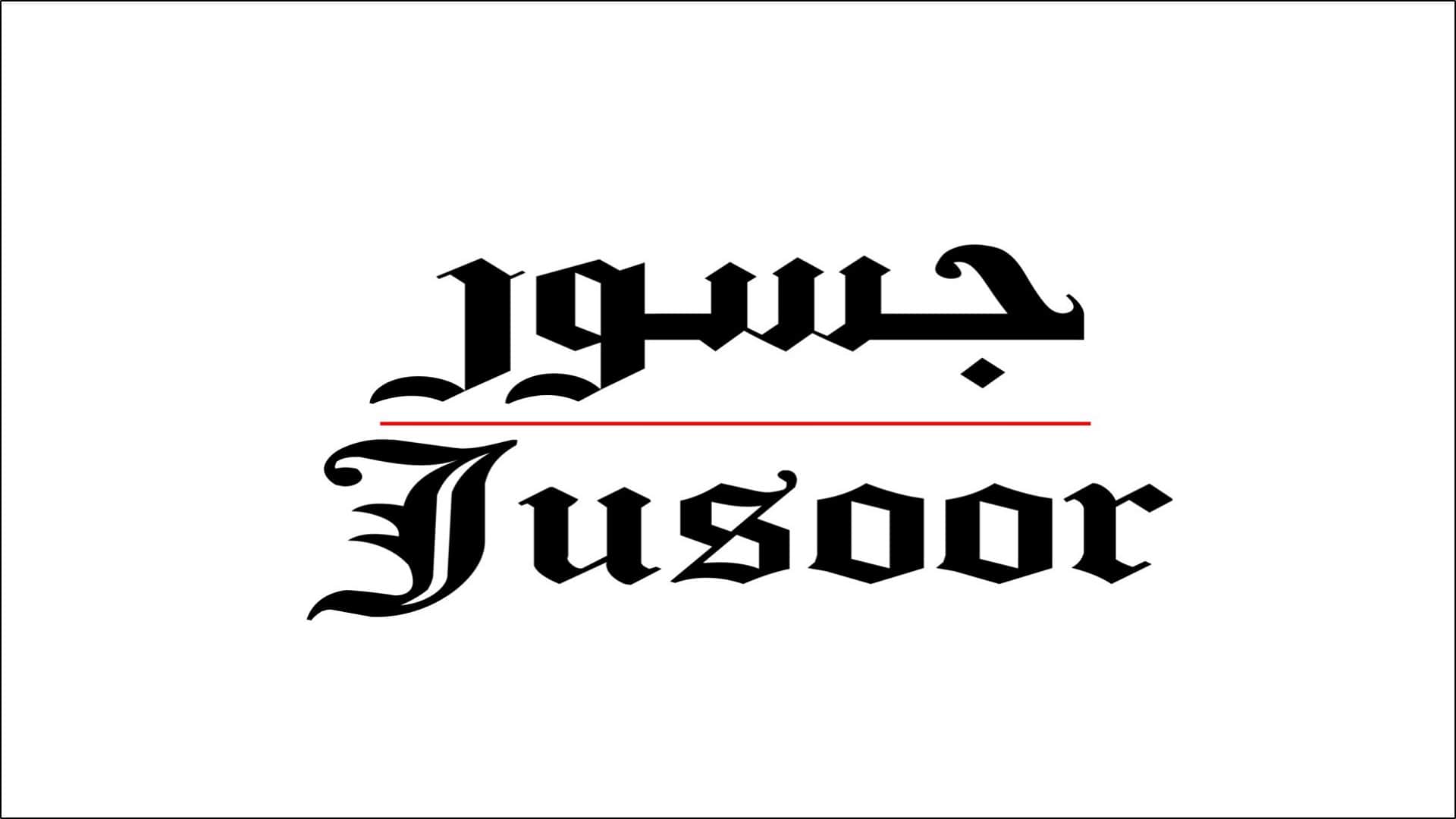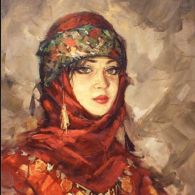بعد وفاة 15 شخصاً في الكونغو.. هل يخرج إيبولا مجدداً عن السيطرة؟
بعد وفاة 15 شخصاً في الكونغو.. هل يخرج إيبولا مجدداً عن السيطرة؟
أعلنت السلطات الصحية في جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤخراً وفاة ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة 28 حالة مشتبهاً بها إثر تفشٍّ لفيروس إيبولا في مقاطعتي بولابي ومويكا بإقليم كاساي، بينها أربع حالات بين العاملين الصحيين، في حين أكد الفحص المعملي وجود فيروس إيبولا من سلالة زائير ذات الفتك العالي، وفق منظمة الصحة العالمية.
منذ إعلان التفشّي أرسلت منظمة الصحة العالمية فرقًا متخصصة لدعم فرق الاستجابة الوطنية، وتم تزويد المنطقة بمعدات مختبرية وحماية شخصية وشحنة من الإمدادات تقدر بطنين، إضافة إلى 2000 جرعة من لقاح Ervebo المخصّص لسلالة زائير، بهدف تنفيذ تطعيم حلقي للمخالطين والعاملين في الصفوف الأمامية.
وتُعد هذه التدابير جزءًا من حزمة تدخلات سريعة لإيقاف السلسلة الانتقالية، لكن المنظمة نفسها حذّرت من احتمال زيادة الحالات مع استمرار انتقال العدوى.
أسباب بيولوجية واجتماعية
إيبولا مرض حيواني المنشأ، حيث تحافظ الخفافيش والقردة والقوارض البرية على الفيروس في البيئة، وينتقل إلى البشر عبر اتصال مباشر بسوائل جسم الحيوانات المصابة أو تناول لحوم برية غير مطهية.
وتنشط حالات "الانتقال من الحيوان إلى الإنسان" عندما تتزايد الوصلات بين المجتمعات والغابات (قطع أشجار، صيد، تجار لحوم برية)، أو عندما تضعف سلاسل المناعة الجماعية، ثم ينتشر الفيروس بين البشر عبر الاتصال المباشر مع سوائل المرضى أو الجثث، أو عبر ممارسات دفن تقليدية غير آمنة، وتبلغ فترة الحضانة من يومين حتى 21 يومًا، ما يجعل المراقبة والكشف المبكر تحديًا بالغ الأهمية.
وتعد هذه المرة السادسة عشرة التي تواجه فيها الكونغو إيبولا منذ اكتشاف الفيروس عام 1976. البلاد تحمل خبرة واسعة في الاستجابة، لكن التفشّي الكبير بين 2018 و2020 أدى إلى وفاة ما يقارب 2,300 شخصًا، وما زالت آثار ذلك الأخير مرئية في قدرة النظام الصحي والذاكرة المجتمعية.
عوامل تعقيد الاستجابة
لا يمكن قراءة هذا التفشّي بمعزل عن هشاشة النظام الصحي والبيئة الأمنية في أجزاء كبيرة من الكونغو، فالنزاعات المسلحة المتواصلة، وعمليات انتهاك حقوق الإنسان الأخيرة، تقوّض قدرة فرق الصحة على الوصول إلى القرى.
وتزيد من درجات الهجرة والنزوح التي تسهّل انتقال الأمراض، كما أن تخفيض المساعدات وقيود التمويل الدولي يؤثران في جاهزية الأجهزة المحلية للاستجابة السريعة، وفي السياق الحالي، تحذيرات من أن الهجمات على المرافق الصحية والمكونات اللوجستية قد تعرقل عمليات التعقب والتطعيم.
وسارعت المنظمات الدولية والإنسانية إلى الترحيب بمبادرات الحكومة والمنظمات الصحية، لكنها شددت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان حرية وصولهم إلى المرضى، ودعت مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية إلى تمويل فوري وتعزيز الوقاية من خلال تحسين مياه الشرب والصرف الصحي والتواصل المجتمعي لتقليل الخوف والوصم الذي قد يعوق استجابة السكان.
وفي الوقت نفسه، ربطت تقارير حقوقية أوضاع الانتهاكات الأمنية وتقييد الحريات بزيادة خطر تفشيات الأمراض وعدم القدرة على احتوائها وفق مركز أخبار الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية.
الأدلة العلمية والإجراءات الفعالة
التجارب الميدانية في تفشيات سابقة أظهرت أن استراتيجية "التطعيم الحلقي" باستخدام لقاح Ervebo تقلص الإصابات والوفيات بشكل كبير عندما تُنفّذ بسرعة وتتماشى مع إجراءات عزل الحالة، والتعقب الدقيق للمخالطين، والتشخيص المخبري السريع، كما تُعدّ ممارسات الوقاية والتحكم في العدوى داخل المرافق الصحية (PPE، وحدات عزل، تدريب العاملين) من عوامل الأساس لخفض العدوى بين الكوادر الصحية، وهو أمر بالغ الأهمية بعد تسجيل إصابات بين العاملين الطبيين الحاليين.
قانونياً، تشترط الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اللوائح الصحية الدولية (IHR 2005)، على الدول إخطار منظمة الصحة العالمية بالحوادث التي قد تشكل طوارئ صحية دولية والتعاون في إجراءات المراقبة والمشاركة بالمعلومات، والتزامات هذه الآليات ليست تقنية فحسب، بل تنطوي على مسؤولية حماية الحق في الصحة والحصول على الإغاثة الإنسانية بمراعاة معايير حقوق الإنسان، بما في ذلك عدم التمييز وحرية الحركة والحق في المعلومات، وفي حالات النزاع تزداد هذه الالتزامات تعقيدًا لأنها تتقاطع مع واجبات الحماية المدنية وقرارات أمنية.
تداعيات محلية ودولية محتملة
على الصعيد المحلي، تهدد التفشيات استمرار تعطّل الخدمات الأساسية (الرعاية الصحية الروتينية، اللقاحات الأخرى، خدمات الأمومة والطفولة)، وتعمق الضعف الاقتصادي للقرى المتأثرة، وإقليميًا، تزيد الحدود المفتوحة مع دول مجاورة المخاطر، وخاصة مع تنقل السكان ونقص نقاط الفحص، ودولياً، فرغم أن احتمال الانتشار الوبائي خارج الحدود يبقى محصورًا مع تكثيف المراقبة، فإن أي فشل في السيطرة قد يستدعي مزيدًا من التدخلات الطارئة وتفعيل بروتوكولات السفر والتجارة، مع آثار اقتصادية وسياسية.
وفق منظمة الصحة العالمية فإن فرص احتواء هذا التفشّي جيدة إذا توافرت ثلاث ركائز: سرعة الوصول وإغلاق حلقات العدوى عبر التلقيح الحلقي والتتبع، حماية الكوادر الصحية وتزويدهم بالمعدات والتدريب، وتواصل مجتمعي شفاف يبني الثقة ويمنع الوصم وإعاقة العمل الصحي. وفي المقابل تبقى التحديات الحقيقية مرتبطة بالتمويل، والوصول إلى مناطق متأثرة بالنزاع، والاستجابة لاحتياجات السكان المتضررين من انعدام الأمن الغذائي والخدمات.
وبحسب المنظمة الأممية فإن ما يجب تتبعه خلال الأيام المقبلة يتمثل في أرقام الحالات والوفيات وتوزعها الجغرافي، سرعة وصول جرعات اللقاح وتوسع حملات التطعيم الحلقي، وتطورات الأمن في مقاطعتي بولابي ومويكا هي مؤشرات حاسمة، كما ينبغي مراقبة قدرة المرافق المحلية على العزل وتعقب المخالطين، وبيان الجهات الدولية والتمويل الجديد للاستجابة، ولا يقلّ عن ذلك أهمية قياس مستوى قبول المجتمع للتدابير الصحية (مشاركة قادة المجتمع، دور الكنائس والمساجد، وسائل الإعلام المحلية)، لأن قبول المجتمع هو ما يحسم سرعة الاحتواء أو انتشاره.