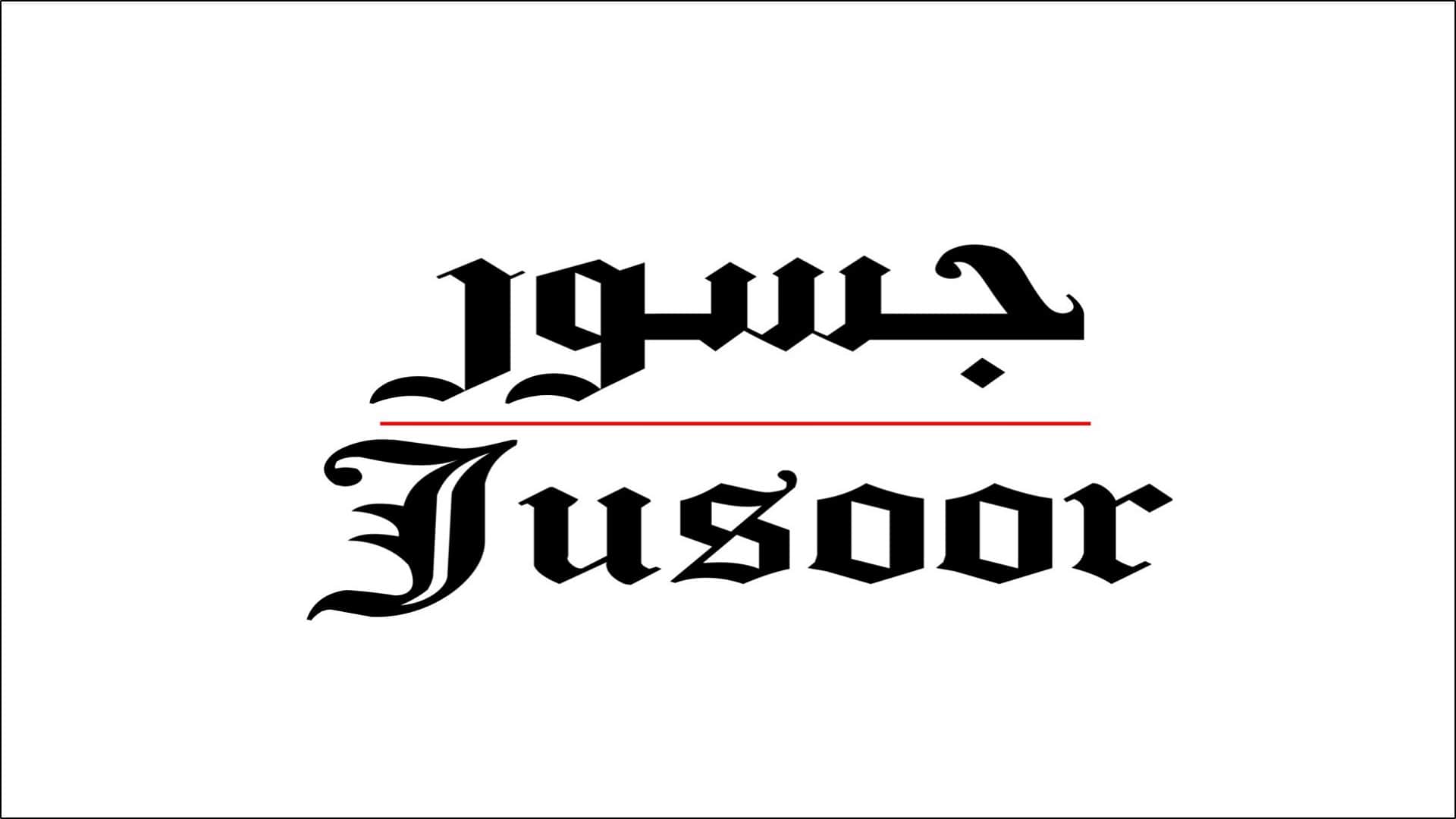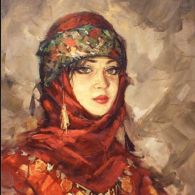عصر التنوير العربي.. المعرفة هي الحل
عصر التنوير العربي.. المعرفة هي الحل
حديث التنوير في العالم العربي المعاصر، يمكن التأريخ له في واقع الأمر من عند القرن الثامن عشر تحديدا، فقد كانت الحملة الفرنسية على مصر تخصيصا (1798-1801) منطلقا لهذا التنوير.
فعلى الرغم من أن جوهرها في حد ذاته هو احتلال عسكري حماية وحفاظا لمصالح فرنسا في الشرق في مواجهة المنافسة مع إنجلترا، إلا أن هناك وجهاً آخر كان يتبدى من وراء الأكمة، وهو ذاك المعروف بالأبعاد العلمية لتلك الحملة، فقد اصطحب نابليون بونابرت معه عدة مئات من العلماء الفرنسيين في كافة التخصصات، وعلى أيدي بعض من علماء تلك الحملة تم الكشف عن حجر رشيد، والذي قاد لاحقا إلى معرفة لغة المصريين القدماء، أي الهيروغليفية، وقد كان الأمر فتحا تاريخيا معرفيا ولا شك.
غير أن المصريين قد خبروا أشكالا وأنواعا من التقدم التكنولوجي بلغة أيامنا، لم يكن لهم ولا لغيرهم من شعوب الشرق دالة عليها، مثل الكيمياء والفيزياء في طبعاتها الحديثة، ناهيك عن الأسلحة الفتاكة التي رأوها للمرة الأولى مع الجنود الفرنسيين، وطرق القتال الحديثة، وصولا أيضا إلى طريقة التعامل الاقتصادي بعملات حديثة، وبخلاف فكرة الذهب التي لم يكن الشرق يعرف سواها، ثم رسم الخرائط وإقامة الحدود والولايات، وحتى الانفتاح على آداب وعلوم الفرنسيين.
ولَّد مشهد تلك الحملة تساؤلات جوهرية في أدمغة المصريين والعرب من خلفهم، وكانت هزيمة الفرنسيين عبر حملة فريزر الإنجليزية بعد ثلاث سنوات من الحملة الفرنسية، نهاية زمن قصير فرنسي، لكن الأسئلة وكما يقال هي مولدات الفكر الإنساني، ومن هذا المنطلق كان الجميع يسعى إلى معرفة الأسباب والمنطلقات التي دعت أوروبا للتقدم، في حين كانت فترات العثمانيين والمماليك وبالا على مصر وبقية العالم العربي.
أسئلة التنوير ربما هي التي دفعت والي مصر الحديثة محمد علي باشا للتطلع من حوله، والإيقان بأن الانفتاح على الأمم والشعوب المجاورة، في الأرض الكبيرة أو الواسعة، أي أوروبا، كما كان العرب يسمونها في ذلك الحين هو درب التنوير، ومن هنا بدأت علائم التنوير الحديثة عبر البعثات التي أرسلها الوالي “التقدمي” كما يقول أهل اليسار، تهل على ربوع مصر المحروسة، وقد كانت رائدة في محيطها العربي في ذلك الوقت، ومنها كان البعض في إقليم البحر الأبيض المتوسط يراقب ويتطلع.
والشاهد أن تجربة محمد علي لم يقدر لها أن تمضي طويلا، وبعيدا عن فكر المؤامرة الذي يذهب إلى أن الغرب لم يكن يريد لمصر ولا للعالم العربي أن ينهض، فإن واحدا من المصريين الذين أرسلوا إلى أوروبا في عهد محمد علي، كان قد أشعل سراج التنوير العربي الحديث.. ماذا عن هذا؟
كان أول عين رأت لنا الحضارة الغربية الحديثة، وأول من نفخ في بوق القرن إيذانا بمرحلة الانتقال لحضارتنا من حقبة الجمود إلى عصر اليقظة والتجديد، كما كان أيضا نموذج القلق الذي تمثل في عقل الأمة ووجدانها، لا سيما عندما قارنت بين تخلفها الموروث وبين الوافد الغربي، بما فيه من نافع وضار.
حكما أننا نتحدث عن الشيخ المصري رفاعة رافع الطهطاوي، المولود في صعيد مصر أي جنوبها عام 1801، والذي ستشاء الأقدار لاحقا أن يكون الإمام والواعظ خلال خمس سنوات لبعثة مصرية من بعثات محمد علي، حيث ذهب إلى هناك كي يتلو القرآن ويعظ الطلاب ويؤمهم في الصلاة، ومن هنا للمرء أن يتحدث عن مصادفات القدر، فلم يكن رفاعة مبتعثا في الأصل لذاته حتى يحقق تحريكا للمياه الراكدة في عقول المصريين والعرب، ولكنه كان على الهامش من البعثة، وتشاء الأقدار أن يعود منها كي يترجم علوم الحضارة الأوربية وفنونها، ويؤم الشرق العربي والإسلامي في تخطي عصور التخلف، والولوج إلى رحاب عصر التنوير.
في عمله الجزيل القيمة “رفاعة الطهطاوي.. رائد التنوير في العصر الحديث”، يقودنا المفكر المصري الدكتور محمد عمارة إلى عمق ما أدركه الشيخ الأزهري، ونقشه على الواحة التي عاد بها إلى أرض الكنانة، وكيف كانت تلك الرؤى التي أجملها في كتابه الخالد “تخليص الابريز في تلخيص باريز”، منطلقا حقيقيا لمشاغبة العقل العربي، وعن دفعه في آفاق وشؤون بل وشجون البحث عن التقدم والرقي، بعد أن انحصرت وانحشرت الحضارة المصرية في الهوامش، وضاعت منها المتن عبر الأجيال.
اقرأ… إنها مفتاح التنوير، وهي الأمر القرآني الأول، ومن أسف فقد غاب هذا البعد عن ناظري العرب والمسلمين في تلك الفترة لأسباب تحتاج إلى قراءات متخصصة قائمة بذاتها، وقد توقف الطهطاوي الأزهري الأصل أمام مفتاح التنوير عند عموم الأوربيين، ولدى الفرنسيين بنوع خاص.
نلحظ في كتابات الطهطاوي أنه عندما تحدث عن المعارف والآداب قرر أن عموم البلاد الإفرنجية كما كان يسميها، مشحونة بأنواع المعارف والآداب التي لا ينكر إنسان أنها تجلب الأنس وتزين العمران، وقد تقرر أن الملة الفرنساوية ممتازة بين الأمم الإفرنجية بكثرة تعلقها بالفنون والمعارف، فهي أعظم أدبا وعمرانا.
يمكن لأي قارئ محقق ومدقق هنا أن يربط بين التنوير من جهة، وبين التقدم العلمي والمعرفي، فما من أمة تبغي تقدما إنسانيا وحضاريا من دون أن تكون لها ريادة وسيادة في سائر العلوم والمعارف.
غير أن الطهطاوي ينبه قومه إلى خاصيتين من خواص العلم عند الفرنسيين، وليتنا نتوقف عندهما في عالمنا العربي، فقد غابتا في الماضي البعيد ويشك المرء أنهما متواجدتان الآن على أراضينا رغم دورس الأزمان وحكايا الإنسان، لا سيما وأنهما كانا من أسباب تأخر العرب والمسلمين وغياب التنوير عن دروبهم.
الخاصية الأولى: هي أن مفهوم العلم هناك وثيق الصلة بالصناعة والإنتاج، وأن هذه الصلة قائمة بالنسبة لمختلف الصناعات والحرف، ذلك أن “سائر العلوم والفنون والصنائع مدونة في الكتب، حتى الصنائع الدنيئة كما يسميها، فيحتاج الصنائعي بالضرورة إلى معرفة القراءة والكتابة لإتقان صنعته، وكل صاحب فن يجب أن يبتدع في فنه شيئا لم يسبق به، أو يكمل ما ابتدعه غيره، ومما يعينهم على ذلك، زيادة عن الكسب، ما يسميه حب الرياء والسمعة ودوام الذكر”.
الخاصية الثانية “هي أن الطهطاوي قد فاجأ قراءه عندما حدثهم عن أن العلماء في فرنسا ليسوا هم رجال الدين، ففقه الشريعة ليس هو العلم الذي يصنع الحضارة ويبني العمران، ومن يظن ذلك فهو واهم”.
تحدث الطهطاوي إلى قراءه فقال: “ولا تتوهم أن علماء الفرنسيين هم القسوس، لأن القسوس إنما هم علماء الدين فقط، وقد يوجد من القسوس من هو عالم أيضا، وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من له معرفة في العلوم العقلية، ومعرفة العلماء في فروع الشريعة النصرانية هينة جدا، فإذا قيل في فرنسا: هذا الإنسان عالم، لا يفهم منه أنه يعرف في دينه، بل إنه يعرف علما من العلوم الأخرى”.
أكثر من مائة وخمسين عاما تقريبا على توصيف الطهطاوي للفارق بين أوروبا الساعية في دروب التنوير وقتها، وبين عوالمنا وعواصمنا العربية بحالها ومآلها، ولا يزال السؤال القلق المقلق، الحائر والمحير: “لماذا يتقدم الآخرون ونتخلف نحن؟”.
لا ننكر أن هناك محاولات جادة لاستنهاض التنوير عربيا في بلادنا، لكن هناك رواسب ثقيلة تشدنا إلى الأسفل، فنحن على سبيل المثال لا نتطلع إلى علمانية جافية تنكر الدين والإيمان، وبالقدر نفسه لا نرغب في راديكالية سلبية وأصولية ظلامية تجرنا إلى الهواء.
الخلاصة: يوم نوازن بين هذه وتلك، وعلى أسس معرفية علمية، سوف يكتب للعالم العربي الانطلاق إلى آفاق التنوير مرة وإلى الأبد.