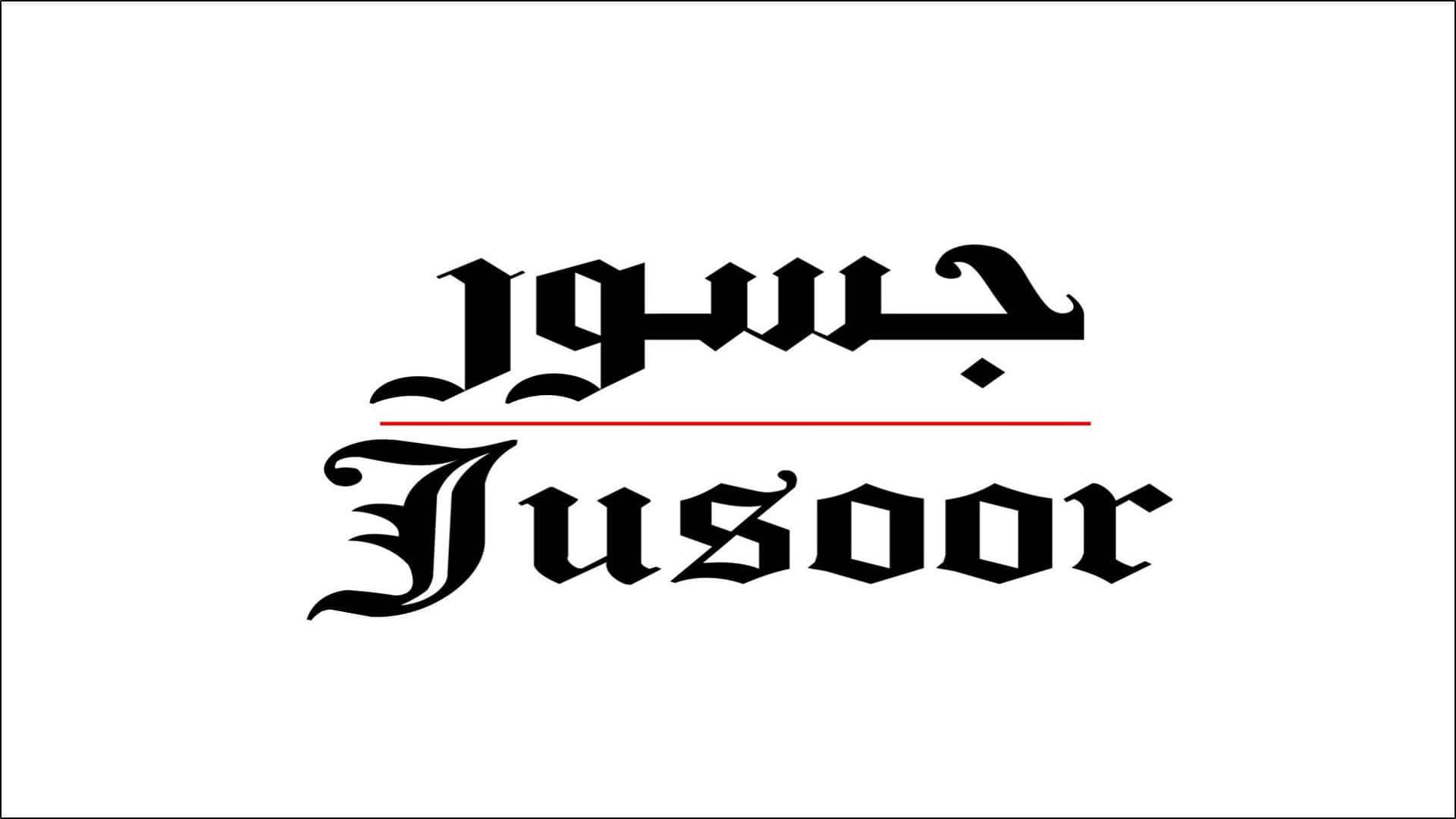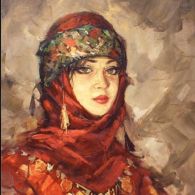"سجن بلا محاكمة".. الاعتقال الإداري في إسرائيل يحرم الفلسطينيين من العدالة
"سجن بلا محاكمة".. الاعتقال الإداري في إسرائيل يحرم الفلسطينيين من العدالة
في ممر طويل داخل سجن عوفر الإسرائيلي، تمضي عائلات الأسرى الإداريين ساعات من القلق والترقب بانتظار بضع دقائق لزيارة أحبّتهم، لكن حتى هذا اللقاء لا يجيب عن السؤال الأهم الذي يلاحقهم منذ شهور وربما سنوات: متى سيخرجون من هذا السجن؟.. والإجابة عادة ما تكون: "لا أحد يعلم"، إذ يعيش المعتقلون الإداريون في واقع قانوني استثنائي يجعلهم سجناء دون تهم واضحة، وأسرى دون تاريخ إفراج محدد.
وصدر نظام الاعتقال الإداري في إسرائيل استنادًا إلى قانون الطوارئ الانتدابي لعام 1945، الذي يتيح للسلطات احتجاز الأفراد إداريًا بدعوى وجود "ملف سري" يهدد الأمن.
وفي المبدأ، يُفترض أن يكون هذا الإجراء استثنائيًا ولمدد محدودة، لكن في الواقع تحوّل إلى سياسة ممنهجة، خاصة بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووفق إحصاءات نادي الأسير الفلسطيني حتى يونيو 2025، تجاوز عدد المعتقلين الإداريين 750 أسيرًا، من بينهم نساء وأطفال ونواب في المجلس التشريعي، بعضهم يقبع في السجن إداريًا منذ أكثر من خمس سنوات.
غياب المحاكمة العادلة
تجدد أوامر الاعتقال الإداري عادةً كل ستة أشهر بناءً على تقييم "أمني"، دون إبلاغ المعتقل أو محاميه بتفاصيل التهم أو الأدلة.
ويناقش القضاة ملفات سرية تقدمها أجهزة الأمن، ويحرم الدفاع من الاطلاع عليها، ما يقوض جوهر الحق في محاكمة عادلة الذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا سيما المادة (9) التي تحظر الاعتقال التعسفي.
وتقول المحامية الفلسطينية سحر فرنسيس، مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان في تصريحات إعلامية متعلقة بالقضية:"في كل جلسة محكمة نسمع العبارة نفسها (لا يمكن كشف الأدلة لأنها سرية) وعمليًا، هذا يجعل الدفاع مستحيلًا".
أصوات أممية وحقوقية
في تقريرها الأخير لعام 2024، وصفت منظمة العفو الدولية سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية بأنها "خرق سافر للقانون الدولي"، في حين حثت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان إسرائيل على إما تقديم المعتقلين الإداريين لمحاكمات عادلة مع ضمانات قانونية أو الإفراج الفوري عنهم.
كما عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء "الاستخدام الواسع" لهذا الإجراء خارج نطاق القانون، مشيرة إلى أن إسرائيل تستخدمه "سلاحاً سياسياً لإسكات المعارضة الفلسطينية".
وفي مواجهة هذا الواقع، لجأ عشرات الأسرى الإداريين من الضفة الغربية إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، باعتباره سلاحًا سلميًا للضغط على السلطات.
وحقق بعضهم الإفراج، لكن الثمن غالبًا ما يكون تدهورًا صحيًا خطِرًا، ومثال على ذلك إضراب الأسير خضر عدنان عام 2012، الذي أعاد قضية الاعتقال الإداري إلى الواجهة الدولية، ثم تبعه إضرابات فردية وجماعية لاحقًا.
أثر في المجتمع الفلسطيني
لا يقف أثر الاعتقال الإداري عند المعتقل نفسه، بل يمتد إلى المجتمع كله فمئات الأسر تعيش في قلق دائم والأطفال يكبرون دون آبائهم، ووصمة الاعتقال دون تهمة تبقى تلاحق العائلة
يرى الباحث الاجتماعي خليل النمري في تصريحات صحفية مرتبطة أن "الغياب المفاجئ والمستمر للآباء يخلق فراغًا عاطفيًا وماديًا في الأسر الفلسطينية، ويضعف الروابط الأسرية".
يُشكّل الأطفال الحلقة الأضعف والأكثر تضررًا، و تشير تقارير منظمات أممية وحقوقية مثل "يونيسف" و"الضمير" إلى أن غياب الأب أو الأم المعتقل إداريًا يخلّف آثارًا نفسية طويلة المدى على الأطفال، أبرزها القلق المستمر، التراجع الدراسي، ونوبات الكوابيس والخوف من فقدان آخرين من العائلة.
ويُفاقم الأمر عدم معرفة مدة الغياب، إذ تتحول الحياة اليومية إلى حالة ترقّب معلقة بين تجديد محتمل أو إفراج غير متوقع، مما يزرع شعورًا عميقًا بعدم الاستقرار وفقدان الأمان الأسري، وفي بعض الحالات يضطر الأطفال لتحمل مسؤوليات كبرى في غياب المعيل الرئيسي، بما يؤثر في طفولتهم ونموهم العاطفي والاجتماعي، هذه التداعيات لا تُقاس فقط بالأرقام بل تُلمَس في ملامح القلق على وجوه الصغار الذين ينتظرون لقاءً قصيرًا وراء زجاج السجون أو عند أبواب المحاكم العسكرية.
أداة لردع النشاط السياسي والاجتماعي
تحوّل الاعتقال الإداري في الضفة الغربية إلى أداة ممنهجة تستخدمها السلطات الإسرائيلية لشلّ الحراك السياسي والاجتماعي الفلسطيني، إذ يُستهدف به بالدرجة الأولى النشطاء الشباب وقادة المجتمع المحلي والطلبة الجامعيون والصحفيون وحتى شخصيات أكاديمية وخيرية.
ويؤكد حقوقيون أن الهدف لا يقتصر فقط على إبعاد هؤلاء الأفراد عن الفعل الميداني، بل يمتد لترهيب الدوائر المحيطة بهم وردع آخرين عن الانخراط في أي نشاط احتجاجي أو تنظيمي، ويعزز ذلك غياب الحاجة إلى تقديم لوائح اتهام أو أدلة واضحة، ما يجعل الأوامر الإدارية سلاحًا مرنًا في يد أجهزة الأمن، يُستخدم بشكل متكرر ضد أي شخص يُعتقد أن وجوده خارج السجن قد يحرك الشارع أو ينشط مبادرات شعبية، حتى وإن لم يكن ارتكب فعلاً جنائيًا مثبتًا، وهذا النمط الممنهج رسّخ حالة من الرقابة الذاتية والخشية في الأوساط الفلسطينية، إذ بات كثيرون يحجمون عن المشاركة في العمل العام خوفًا من توقيف إداري مفاجئ وغير محدد الأجل.
تستخدم دول أخرى الاعتقال الإداري، وإن بدرجات أقل ففي الهند، يُستخدم في إقليم كشمير كإجراء أمني ضد المعارضين، وحتى في بريطانيا، لجأت السلطات للاعتقال الإداري مؤقتًا في أيرلندا الشمالية خلال السبعينيات، لكن في إسرائيل، يصف الخبراء الوضع بأنه "الأوسع والأكثر انتظامًا واستمرارية" بين الديمقراطيات الحديثة.
ويسمح القانون الدولي بالاعتقال الإداري فقط في ظروف استثنائية ومؤقتة، مع ضمان: إطلاع المعتقل على أسباب احتجازه، كما يسمح بالحق في الطعن أمام محكمة مستقلة، والرقابة القضائية المستقلة، لكن في الممارسة الإسرائيلية، يُحرم المعتقل من معرفة أدلة الاتهام، وتكون الرقابة القضائية شكلية لأنها تستند إلى ملفات سرية.
دعوات لإنهاء الظلم
تطالب منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بـ: إلغاء نظام الاعتقال الإداري أو حصره في أضيق نطاق، وضمان الشفافية في تقديم الأدلة، وإنهاء التمديد غير المحدود، وتعويض المعتقلين المتضررين من الاحتجاز التعسفي.
ويرى خبراء القانون أن الحل الحقيقي يمر عبر إنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة السياسية الشاملة.
ونشأ نظام الاعتقال الإداري في فلسطين خلال الانتداب البريطاني لمواجهة "التمردات"، ثم اعتمدته إسرائيل بعد تأسيسها، وتوسّع بعد 1967 ليشمل آلاف الفلسطينيين. رغم الإدانات الدولية المتكررة، لا يزال الاعتقال الإداري يُستخدم سلاحاً أمنياً وسياسياً، ويفرض أثمانًا إنسانية باهظة على المعتقلين وأسرهم.