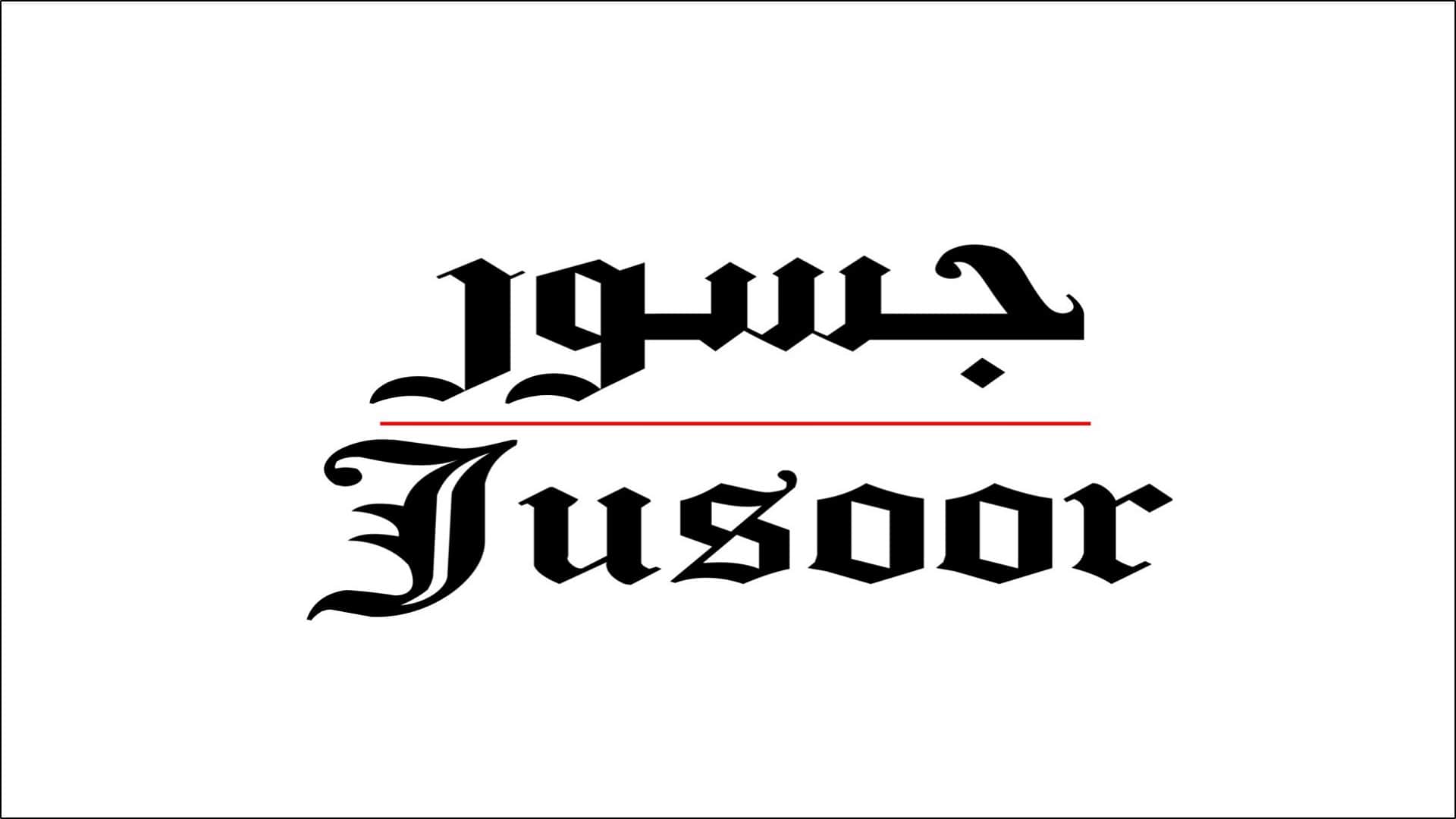صراع ذوي البشرة السمراء في تونس ضد العنصرية.. حكايات لم تُروَ من قبل
صراع ذوي البشرة السمراء في تونس ضد العنصرية.. حكايات لم تُروَ من قبل
في تونس، حيث تتعانق زرقة المتوسط بخضرة السهول وتُروى حكايات الأجداد على ألسنة الأحفاد، هناك قصصٌ أخرى تُروى همساً، قصصٌ تُخبئ ألماً عميقاً وجراحاً لا تندمل.
إنها حكايات التونسيين من ذوي البشرة السمراء، الذين، وعلى الرغم من أنهم جزءٌ أصيل من نسيج هذا الوطن، يواجهون يومياً تحدياً لا يُمحى أثره.
العنصرية.. ليست مجرد كلمة، بل هي واقعٌ يوميٌ ينهش في كرامتهم، يُضيّق عليهم فرص الحياة، ويُلقي بظلاله القاتمة على أحلامهم البسيطة.
امرأة تصرخ في وجه العنصرية
كانت لطيفة بطيفي، الفنانة والمنتجة التونسية ذات البشرة السمراء، تعود إلى بيتها في أحد أيام تونس الصيفية، تحمل في قلبها أحلامها وفي عينيها بريق الإبداع.
لم تكن تعلم أن طريق العودة ذاك سيُصبح مسرحاً لحادثة تُدمي القلب، وتُعيد للأذهان مرارة واقع لم يزل يلاحقها منذ الطفولة.
"كأي شخص من ذوي البشرة السوداء"، بدأت لطيفة حديثها لجسور بوست بصوت حمل عمق التجربة وصدق المشاعر، "تعرضت للعنصرية منذ طفولتي المبكرة وحتى مسيرتي الحياتية كلها".
تلخص هذه الجملة الموجزة عقوداً من المعاناة، لكن ما حدث في ذلك اليوم كان أقسى، وأشد تأثيراً، خاصةً بعد موجة تواجد الأفارقة من جنوب الصحراء في تونس، وما رافقها من تصاعد في خطاب الكراهية الذي طال الجميع، بمن فيهم التونسيون الأصليون من ذوي البشرة السمراء.
"أذكر موقفًا في مرة من المرات كنت عائدة من العمل، إذ بأطفال صغار يعترضون طريقي ويطلبون مني بعض النقود باللغة الفرنسية"، كان المشهد يبدو عادياً، أطفال يتسولون، لكن لطيفة، التي تؤمن بالمسؤولية المجتمعية، لم تُرد أن تُشجعهم على التسول، "ولما رفضت قلت لهم: مفروض أنكم تكونون في المدرسة لا أن تتسولوا هكذا، مع أني حدثتهم بالعربية حتى أؤكد أني تونسية، "كلماتٌ بسيطة، هدفها التوجيه والإرشاد، تحولت فجأة إلى شرارة أشعلت نار العنصرية الكامنة.
فقال لها أحد الأطفال: "كحلوشة، روح لبلادك!".. تلك الكلمة، "كحلوشة"، ذات الدلالة العنصرية البغيضة، اخترقت قلب لطيفة كخنجر مسموم، لم تكن مجرد إهانة، بل كانت طعنا في هويتها، ونفيا لانتمائها، حاولت لطيفة أن تبتلع الإهانة، وأن تمضي في طريقها متجاهلة هذا الأذى، لكن القدر لم يُمهلها، "تركت الأمر وحاولت مواصلة طريقي، إلا أن واحداً من المجموعة أخذ حجراً ورماني به على رأسي"، الاعتداء الجسدي، ذلك السلوك الهمجي، أتى ليُكمل لوحة الألم.
في تلك اللحظة، لم تعد لطيفة قادرة على الصمت. التفتت إلى الطفل، وعيونها تحمل مزيجاً من الغضب والألم، "لو أمسكت بك فسأحملك إلى مركز الشرطة وهكذا يتم استدعاء والديك لكي تلتزم ولا تعيد مثل هذه الكرة لا معي ولا مع غيري"، كان رد الطفل صاعقًا، يكشف عن عمق المشكلة: "في تحدٍ قال لي: 'لا يمكنك فعل ذلك فأنت سوداء ولن يؤخذ بكلامك!" هذه الكلمات لم تكن مجرد رد طفل، بل كانت صدى لواقعٍ مؤلم، يُخبر لطيفة بأن صوتها، بصفتها امرأة سمراء، قد لا يجد آذاناً مصغية في أروقة العدالة.
الكفاح من أجل الحقوق
أدركت لطيفة مرارة الواقع، وأن الكفاح من أجل حقوقها سيكون وحيداً ومضنياً، "في تلك اللحظة استسلمت للأمر لأنه فعلاً حتى لو اشتكيت، فلن يحدث شيء، فرجعت إلى المنزل"، هذه الجملة الموجزة تحمل في طياتها يأساً عميقًا وإحساساً بالظلم الذي لا يُقاوم.
لم تكن حادثة الشارع سوى جزءٍ من معاناة لطيفة، حتى في مجال عملها الفني، الذي يُفترض أن يكون فضاء للإبداع والشمول، واجهت تمييزاً صارخاً، حاولت العمل مع مؤسسة ثقافية وطنية للمشاركة في مهرجان، لكن الأبواب أُغلقت في وجهها بطريقة لا تخلو من العنصرية المقيتة، "في السنة الفائتة قدمت مطلبي وأخذ بالاعتبار.
وفي آخر لحظة، ولما حاولنا أن نتكلم مع مديرة المؤسسة، قالت لي: "هذه السنة أتيتِ متأخرة، السنة المُقبلة حدثيني وسوف أفسح لك المجال للعمل"، كان وعداً زائفاً، تبخر مع مرور الأيام، "وكان الأمر كذلك سنة كاملة وأنا أحاول الاتصال بها وجهاً لوجه، بعثت مراسلات، حاولت مقابلتها أكثر من مرة ولكن دون جدوى، "السبب، كما تقول لطيفة، كان واضحًا ومُعلنًا: "وهذا الشيء لأنها لا تحب ذوي البشرة السوداء".
لطيفة، وبصوت يملؤه الأسى، تُؤكد أن العنصرية ليست قضية محلية تونسية فحسب، بل هي ظاهرة عالمية متجذرة. "العنصرية بالنسبة لي هي ليست وليدة مجتمع أو مختصة ببلد بعينه، تونس كباقي العالم لا تخلو من العنصرية، والعنصرية قضية قديمة حديثة وستظل، لكن ما أطلبه وما نطالب به هو ضرورة احترام الكيان الإنساني، يعني ضرورة أن نتعايش مع بعضنا البعض".
وتُصرح بحزمٍ لا يقبل الجدال: "نعم تونس، وهناك من يقول إن في تونس أو في أي بلد في العالم لا توجد عنصرية، فهذه عنصرية أكثر من العنصرية، فالعنصرية في كل كيان، في كل إنسان موجودة، لكن الفرق في طريقة التعامل".
تُشدد لطيفة على أن العنصرية تفاقمت في تونس بعد موجة الهجرة غير النظامية من أفارقة جنوب الصحراء، وتفاقم خطاب "التوطين" الذي روج لفكرة أن هؤلاء المهاجرين يريدون البقاء في تونس، ما خلق جواً من التوتر والقلق، لكن لطيفة تُذكّر الجميع بهويتها الراسخة: "أنا مواطنة موجودة في بلدي، مختلفة نوعاً ما عن الأغلبية، سوداء البشرة، نسبة أمثالي 15% من النسيج الاجتماعي التونسي".
تُقارن لطيفة هذا الواقع بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشكل هذه النسبة أساسًا قويًا لوصول ذوي البشرة السمراء إلى سدة الحكم، في حين أن التونسيين السود ما زالوا يُناضلون من أجل أبسط حقوقهم، كحق الحياة والتعايش والنقل والدراسة.
تُعبر لطيفة عن ألمها العميق لغياب تمثيل السود في المقررات المدرسية والإعلام التونسي، "لا يوجد في المقررات المدرسية مثلاً عائلة سوداء، في الجانب الإعلامي، يندر جداً أن تجد شخصية سوداء، وفي أغلب الأحيان يعطونهم أدواراً ثانوية أو أدواراً مُعينة، فإما سائق أو معينة منزلية، مع احترامي لكل المهن.
تُسلط لطيفة الضوء على كفاءات تونسية سمراء في كل المجالات: "عندنا أساتذة، محامون، مهندسون، عندنا أطباء في جميع المجالات، فنانون لماذا لا يُسلط عليهم الضوء؟".
عن محاولاتها مواجهة العنصرية والإقصاء، تُؤكد لطيفة أنها دائماً تختار الطرق السلمية، وأنها تُؤمن بدولة القانون، لكنها غالبًا ما تجد نفسها وحيدة في هذا المجال، ما يدفعها للاستسلام أحياناً والبحث عن حلول أخرى، "القوانين موجودة، ترسانة من القوانين، لكن التنفيذ غير موجود"، هذا الاعتراف المرير يُوضح حجم التحدي الذي يواجهه المدافعون عن حقوق الإنسان.
مواطنة كاملة الحقوق
تُطالب لطيفة بمعاملتها كونها مواطنة تونسية كاملة الحقوق، لا مواطنة من الدرجة الثانية. "ما أطلبه مثلاً من بلدي هو ضرورة احترام حقوق المواطنة، فيزعجني أن أُعامل كوني مواطنة درجة ثانية، يزعجني كثيراً في وسائل النقل العمومي في الإدارات، دائماً يُخيّل إليهم كأني إفريقية".
وتُضيف: "وعندما أتكلم مثلاً بالعربية تتغير المعاملة ويقولون: "آه أنت تونسية، لكن لا توحي هيأتك أنك تونسية، هكذا علي أن أفعل حتى أبرر جنسيتي حسب معتقداتي"، إنها معاناة مستمرة، حتى في إثبات الهوية.
لطيفة لا تتمنى التغيير، بل تسعى إليه وتُناضل من أجل حقوق السود في تونس عن طريق الفن. "عندما أنتج عملًا فنيًا مسرحيًا أو سينمائيًا، لا بد من أن يكون فيه عنصر من عناصر أو شخصية ذات بشرة سوداء، أحاول أن أُمرر هذا في خطاباتي"، هي لا تدعو للعنف، بل للتعايش السلمي، وتُطالب بتفعيل القوانين وتوحيد الخطاب الرسمي، وتصحيح الصور النمطية في الإعلام والتعليم، "لا بد للسياسيين من أن ينظروا في القوانين والمشرع لا بد له من أن يدعم أكثر ويعطي حقوق المواطنين ما داموا قد أخذوا ما عليهم أو ما داموا يدفعون واجباتهم".
تختتم لطيفة حديثها بمرارة عن تجربتها في وزارة الثقافة، حيث تُلاحظ غياب الكفاءات السمراء في المناصب القيادية، وتُشير إلى أن مدينة الثقافة بأكملها لا يوجد بها سوى موظف واحد ومديرة واحدة من ذوي البشرة السمراء.
وتتذكر كيف تم استبعادها من المركز الوطني لفنون العرائس رغم خبرتها التي تمتد لثلاثين عاماً، وتقول: "استبعدت وأقولها وأتحمل المسؤولية، استبعدت لمواقفي وللوني"، لكنها لا تفقد الأمل: "أنا دائمًا متفائلة وأقول غداً أفضل إن شاء الله".
إرثٌ ثقيل وواقعٌ مُنكر
تُعد تونس، شأنها شأن العديد من دول شمال إفريقيا، وريثة لإرث الرق الذي ترك ندوباً عميقة في نسيجها الاجتماعي، فبالرغم من إلغاء الرق في عام 1846، وهو ما يُعد سباقًا تاريخيًا لتونس في المنطقة، إلا أن الآثار الاجتماعية والاقتصادية لهذا النظام البائد لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، مُغذية للصور النمطية والتمييز ضد ذوي البشرة السمراء، غالباً ما يُربط هؤلاء الأفراد، خطأً، بالعبودية أو الهجرة غير الشرعية، حتى لو كانوا مواطنين تونسيين لأجيال متعاقبة، حاملين لأسماء عائلات تونسية أصيلة وتاريخًا يمتد لمئات السنين في هذا الوطن.
وتُشير دراسات متعددة إلى أن التمييز العنصري في تونس ليس مجرد حوادث فردية عابرة، بل هو مشكلة هيكلية متجذرة في المجتمع. في عام 2018، أصدرت وزارة الداخلية التونسية بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة دراسة شاملة حول التمييز العنصري في تونس.
وكشفت هذه الدراسة عن وجود تمييز واسع النطاق في مجالات حيوية مثل العمل، والسكن، وحتى التعليم، وأظهرت الإحصاءات أن التونسيين من ذوي البشرة السمراء غالباً ما يواجهون صعوبة في الحصول على وظائف لائقة، ويتم استبعادهم من بعض المناطق السكنية، ويتعرضون للتمييز في التعاملات اليومية، ما يؤثر في جودة حياتهم وفرصهم في التقدم.
شهادات حية وواقعٌ مرير
تُبرز شهادات عدة حجم معاناة التونسيين ذوي البشرة السمراء، خاصة في مناطق الجنوب، حيث يعانون من تمييز متجذر يعكسه تعامل المجتمع معهم كغرباء أو خدم، حتى وإن كانوا من السكان الأصليين وورثة الأرض، هذا الواقع يولد شعورًا دائمًا بالاغتراب والحرمان من الانتماء الكامل للوطن، حيث يُنظر إليهم من خلال لون بشرتهم لا من خلال مواطنتهم.
تنتشر الصور النمطية السلبية التي تحرم هذه الفئة من حقوقها الاجتماعية، وتبرز بشكل خاص في قضايا مثل الزواج والمصاهرة، حيث يرفض العديد من العائلات إقامة علاقات اجتماعية معهم، ما يفاقم من عزلتهم ويعزز الانقسامات داخل المجتمع، ويُعد هذا التمييز حاجزًا فعليًا أمام الاندماج، ويسهم في ترسيخ وجود طبقات اجتماعية غير معلنة مبنية على اللون.
ولا تقتصر مظاهر التمييز على العلاقات الاجتماعية، بل تظهر أيضًا في الحياة اليومية، حتى في الأماكن العامة، ففي وسائل النقل، يتعرض كثيرون منهم للتنمر أو الاستهزاء، ويعمد البعض إلى تجنب الجلوس بجوارهم، ما يخلق بيئة تنقصها المساواة، ويُعمق الشعور بأنهم غير مرحب بهم داخل مجتمعهم.
تحليلٌ أعمق من منظور حقوقي
يُقر زياد روين، المنسق العام لجمعية “منامتي”- وهي أول جمعية تونسية مناهضة للتمييز العنصري- بأن مظاهر التمييز العنصري في تونس تتجلى بأشكال متعددة، من بينها التمييز الفردي المباشر، والتمييز الهيكلي والمؤسساتي.
ويشير إلى أن هذه الأنماط من التمييز متجذرة في المخيال الشعبي، حيث يُصنَّف ذوو البشرة السمراء ضمن صور نمطية تقلّل من شأنهم، مثل اعتبارهم "عبيدًا سابقين" أو "مواطنين من الدرجة الثانية".
ويؤكد روين أن المجتمع التونسي لم يطور بعد الآليات الكفيلة بتمكين التونسيين ذوي البشرة السمراء وتعزيز مكانتهم، مضيفًا أن الفرص المتاحة أمامهم تظل محدودة، وتُقيَّد بعوامل اجتماعية وتاريخية تُكرّس التمييز بدلًا من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويُشير إلى أن القانون رقم 50 لسنة 2018، المتعلق بمناهضة التمييز العنصري، يُعد خطوة أولى نحو الاعتراف الرسمي بوجود هذه الظاهرة في تونس، وينص القانون على التزام الدولة بحماية الأفراد من التمييز على أساس اللون أو العرق أو النسب، وقد صدر بالفعل عدد من الأحكام القضائية لمصلحة ضحايا هذا النوع من التمييز.
ومع ذلك، يُلفت روين الانتباه إلى تحدٍ جوهري، يتمثل في غياب التطبيق الفعلي لهذا القانون خلال السنوات الأخيرة. ويُعزى ذلك، بحسب قوله، إلى تصاعد الخطاب العنصري في الفضاء العام، خاصة مع تزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين، ما أسهم في تراجع الالتزام بتطبيق القانون وتفعيله.
ويختم روين حديثه، متسائلًا: "لماذا لا تُطبق الدولة قانونها؟ إذ إن كل دولة ملزَمة باحترام قوانينها، وعلى تونس أن تُفعّل القانون عدد 50 للحد من خطاب الكراهية والتمييز".
إنكارٌ مُجتمعِيٌّ يفاقم المشكلة
للأسف، يؤكد روين، كما تؤكد الناشطة الحقوقية غفران بينوس، أن الوعي بوجود التمييز العنصري في تونس لا يزال محدوداً. غالباً ما يُقابل الحديث عن العنصرية بالإنكار أو التبرير، حيث يعدها الكثيرون "مشكلات زائفة" أو "مجرد دعابة" أو "مزاح"، لكن غفران تُصرح بحزم: "الواقع يُظهر العكس تماماً، وهناك تمييز واضح في التوظيف، التعليم، وحتى في التعاملات اليومية".
وتضيف: "الرفض للاعتراف بوجود المشكلة يعد بحد ذاته جزءاً من المشكلة، لأنه يمنعنا من التقدم نحو الحلول"، هذا الإنكار المجتمعي يشكل عائقاً كبيراً أمام إيجاد حلول حقيقية، فكيف يمكن معالجة مشكلة لا يُعترف بوجودها؟
وتكشف غفران بينوس عن قصة مؤلمة لطفل تعرض للتنمر العنصري في المدرسة: "من بين الشهادات التي لا أنساها، طفل يدرس بمدرسة في منطقة بالعاصمة، مارست عليه معلمته العنصرية بسبب لون بشرته، إذا كان يوجد درس يتحدث عن العبيد، كانت تقول المعلمة: "مثل صديقكم سعيد"، وكان هذا يحزّ في نفسه كثيراً، خاصة أنها كانت تتعمد دائماً إهانته أمام زملائه وتقول إن رائحته كريهة"، هذه القصة ليست مجرد حادثة فردية، بل هي شهادة على تأثير العنصرية على الأطفال، الذين "لا يملكون آليات دفاع".
تضيف غفران: "كنا قد قمنا بحملات ضد المعلمة العنصرية، والتي في الأخير اعتذرت من التلميذ، ولكن بعد أشهر، سمعت أن التلميذ توفي، لا أعرف إن كان توفي بسبب كثرة التنمر أو بسبب مرض عضوي، ولكن ما وصلني من أشخاص مقربين أنه مرّ بحالة اكتئاب كبيرة، وهذا حزّ في نفسي كثيراً، لأني دائماً حساسة في الأمور التي تخص الأطفال، خاصة في موضوع العنصرية".
وتُشير غفران إلى الحملات التي تُشن على مواقع التواصل الاجتماعي ضد أفارقة جنوب الصحراء، والتي طالت حتى التونسيين السود، "وتجد الكثير من الشهادات حول هذا، هذه ليست حوادث معزولة، بل تعكس نسقاً عاماً من التمييز المجتمعي الممنهج وغير المُعلن"، هذه الحملات خلقت جواً من الخوف والقلق لدى التونسيين السود، الذين أصبحوا "ضحايا صامتين ويخافون حتى من التكلم حتى لا يُتهموا بالتواطؤ من قبل المواطنين".
دور الإعلام والتعليم والخطاب الديني
ترى غفران بينوس أن وسائل الإعلام في تونس، للأسف، تكرس في كثير من الأحيان الصور النمطية السلبية عن ذوي البشرة السمراء: "سواء من خلال التمثيل النمطي لأصحاب البشرة السوداء في المسلسلات واختزالهم -في أغلب الأوقات- في المهن الخدمية، أو من خلال التعتيم على قضاياهم المتشعبة"، هذا التهميش الإعلامي يُعزز الفكرة النمطية بأن دورهم في المجتمع محدود.
أما التعليم، فهو لا يتطرق بفعالية لمفهوم المساواة العرقية، ولا يعترف بالهوية المتعددة داخل تونس. "إذ لا يوجد في المناهج التعليمية تمثيل للعنصر الأسود، وحتى إذا وُجد، يكون اسمه اسمًا لإفريقي من جنوب الصحراء مثل مامادو، وليس علي أو صالح أو محمد، تلك الأسماء التي نستعملها لتونسيين"، هذا الغياب في المناهج الدراسية يُحرم الأجيال الجديدة من فهم التنوع الثقافي والعرقي داخل بلادهم، ويُسهم في استمرار الصور النمطية.
فيما يتعلق بالخطاب الديني، تُلاحظ غفران أنه "يُستخدم أحيانًا لتبرير التراتبية الاجتماعية باسم القَدَر أو الخضوع، ما يعمق الفجوة بدل أن يسهم في تقليصها".
وتُضيف: "أو تلك الجملة الشهيرة: بلال مؤذن الرسول كان أسود، مجرد كلمات تُستخدم لإغلاق النقاش"، هذا الاستخدام الخاطئ للدين يُعزز التمييز بدلاً من محاربته.
طريقٌ وعرٌ نحو العدالة
شاركت غفران بينوس في حملات مثل "تونس بدون تمييز" و"لا للعنصرية"، وعدة مشاريع وحملات تهدف إلى تسليط الضوء على التمييز ضد السود في تونس، "كما عملنا على مشاريع توعوية في المدارس والجامعات، وتدريب شباب على توثيق الانتهاكات والمطالبة بحقوقهم".
وعلى الرغم من وجود "شباب متحمس جدًا"، فإن هذه الجهود تواجه "مقاومة قوية من بعض الفئات التي تحسبنا نُبالغ أو نفتعل مشكلة غير موجودة"، واليوم، تُضيف غفران، "وباعتبار وجود ملاحقة لكل الجمعيات التي عملت على ثقافة الاختلاف، فإن عملنا انعدم"، هذا التضييق على عمل المجتمع المدني يُعد انتكاسة كبيرة لجهود مكافحة التمييز.
أما زياد روين، فيُشير إلى أن جمعية منامتي قامت بتوثيق مجموعة من حالات الانتهاكات، وخرجت بمجموعة من الإحصاءات التي تُلقي الضوء على القضية، من أهم الحالات التي تم توثيقها هي حالة الألقاب التي تحمل دلالات تاريخية مرتبطة بالرق.
ويُذكر روين أن تونس كان لديها جانب من المسؤولية في تتبع كل من ينال من الكرامة البشرية، ولكن في الأعوام التالية "تم التخلي عن التعامل بقانون 50".
ويُشدد على أنه "من 2018 وحتى الآن لم تُوجد لجنة لمكافحة التمييز أو إعطائها الحق في ذلك"، وأن تمثيل السود في المجال السياسي غائب، ما يؤكد أن محاربة التمييز العنصري ليست أولوية لدى الدولة التونسية.
ويُشير إلى أن خطاب 23 رأى البعض على مواقع التواصل الاجتماعي أنه يعزز الكراهية والتمييز العنصري بين المواطنين، وأن مؤسسات الدولة لا تطبق القانون، ما يخلق جوًا عامًا من التحريض والكراهية.
ما الذي تحتاجه تونس لخلق تغيير حقيقي؟ تجيب غفران بينوس: "نحتاج أولًا إلى إرادة سياسية واضحة لتفعيل القوانين الموجودة، مثل القانون 50 لسنة 2018 ضد التمييز العنصري، والذي لا يُطبّق كما يجب. وأيضًا نحتاج إلى خطاب رسمي يوحد كل التونسيين ويُرسل رسالة طمأنينة للسود التونسيين، خاصة في هذا الوضع".
وتضيف غفران: "نحتاج أيضًا إلى إصلاح في المنظومة التعليمية لتشمل مواد تُعزز قيم المساواة والتنوع، إلى جانب إعلام مسؤول يتبنى القضية ولا يغض الطرف عنها"، أما عن المجتمع المدني، فتُشير إلى أنه "لم يعد قادرًا اليوم على تقديم شيء، خاصة أن المنظمات والجمعيات التي عملت على هذا، أغلب رؤسائها في السجن، وهذا لن يُشجع أي جمعية في المستقبل على العمل على هذا الملف".
ومع هذا، تختتم غفران بكلمات قوية: "التغيير الحقيقي يبدأ بالاعتراف، ثم بالمواجهة، ثم بالعدالة، لأنه لا يمكن أن نبني مجتمعاً ديمقراطياً حقيقياً دون مواجهة عنصريته أولاً".